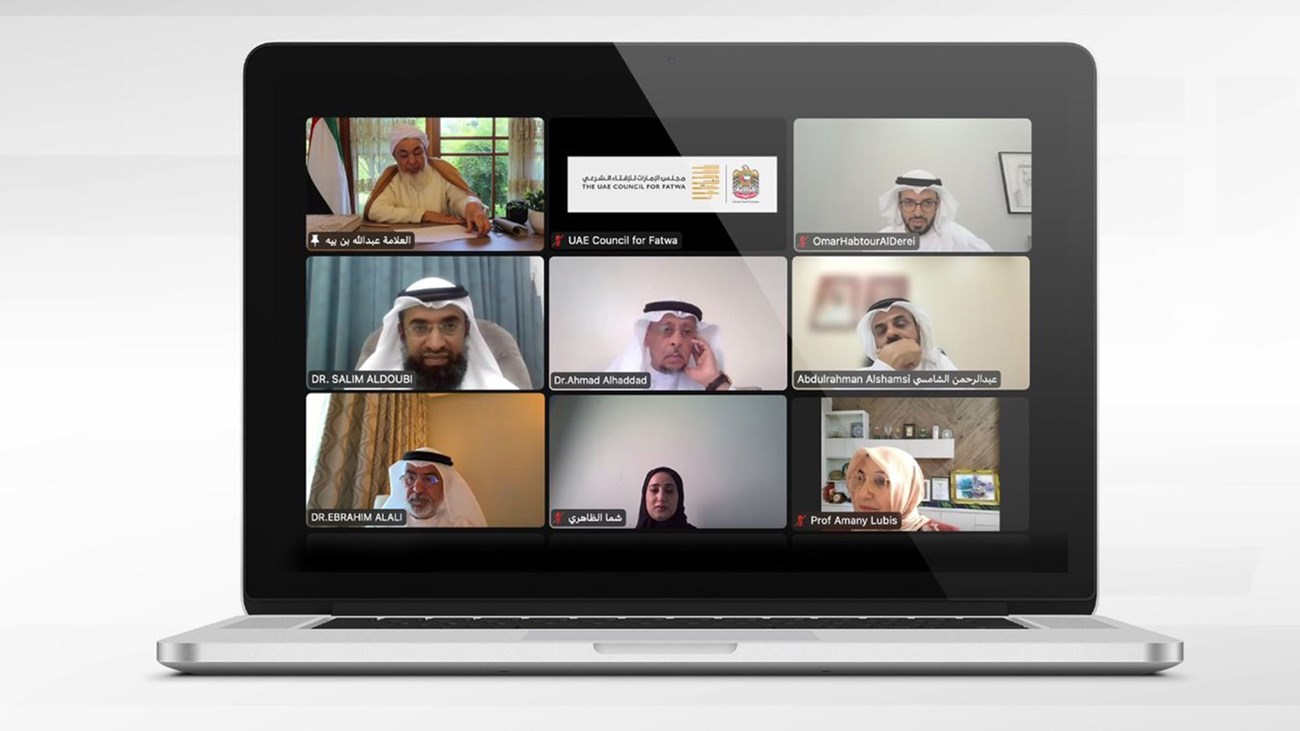مدى حاجة الفقيه إلى اللغة العربية (3-3 )

بقلم الإمام العلامة / عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
ويرجع الخلاف بين الفقهاء إلى مدلولات الألفاظ اللغوية، ويمكن للفقيه أن يستفيد من تطور اللغة عرفاً في مسائل فقهية معاصرة كمدلول القبض والتقابض في البيع وكمدلول الحوز والحيازة في الهبات إلى غيرها ولو أن هذا المبحث لا يهتم بهذا الموضوع وإنما يهتم فقط بلفت الانتباه إلى علاقة اللغة بصفة عامة بالفقه لذكرنا من ذلك الكثير ولعلنا في بحوث قادمة نتعرض إلى ذلك كما نتعرض بتفصيل إلى كثير من الألفاظ اللغوية التي وردت في كلام الشارع وتسبب عنها الخلاف بين الفقهاء كالغسل بين المالكية والجمهور والتبيع في الزكاة بينهم وبين الجمهور والبيات بين الحنابلة في مسألة: أين باتت يده، وغيرهم والقائمة طويلة.
ولعلنا الآن نكتفي بمثالين فقط خفية التطويل وقد اخترتهما من الكلمات المرتبطة بالحياة اليومية، فهما من الأغذية وما كان ينبغي أن يختلف فيهما لو حكمنا الاستعمال العرفي للغة.
ولقد اخترت هذا المصطلح على المصطلح الذي يستعمله الأقدمون، وهو: الحقيقة العرفية، المجاز اللغوي [1] ، لتجنب المقابلة بين الحقيقة اللغوية من وجه والمجاز من وجه آخر؛ لأن الإطار العام الذي نقترحه هو اعتبار الحقيقة العرفية تطوراً للحقيقة اللغوية من حيث الاستعمال وقد يقال إن هذا هو المجاز بذاته ولكن المجاز يقابل الحقيقة، ومن هنا ينشب الخلاف بين المتمسكين بالأصل أو الفرع في حين نحاول تحقيق ذلك عن طريق الاعتراف بتطور الاستعمال اللغوي كأساس ومرجع عند الاختلاف.
والمثالان هما لفظ الإدام:
فقد اختلف في مدلوله ولا خلاف بينهم أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن والعسل والرب والخل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام، وفي الحديث: “نعم الإدام الخل”، رواه تسعة من الصحابة سبعة رجال، وامرأتان، وإنما الخلاف هل لفظ الإدام يطلق على الجامد أو هو خاص بالمائع؟ فذهب الجمهور إلى أن الإدام يجوز إطلاقه على الجامد كاللحم والتمر وهذا قول مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة وهي رواية عن أبي يوسف صاحبه أنه لا يجوز إطلاق على الجامد كاللحم والتمر؛ لأن حقيقة الإدام عنده من الموافقة على الاجتماع على وجه لا يقبل الفصل كالخل والزيت ونحوهما، وأما البيض واللحم وغيرهما من الجامدات فلا يوافق بل يجاوره؛ لأنه يؤكل على حده فلا يكون إداماً [2] .
والمسالة مفروضة في اليمين لو حلف لا يأكل إداماً فأكل هذه الجوامد هل يحنث أو لا؟ فذهب الجمهور إلى الحنث واستدلوا بالدلالة اللغوية وبحديث أبي داوود: “أنه – صلى الله عليه وسلم – أخذ كسرة من شعير فوضع عليها تمرة فقال: سيد إدامكم الملح”، رواه ابن ماجة[3].
وذهب أبو حنيفة على أنه لا يحنث بأكل الجوامد لما أسلفنا من المناسبة اللغوية.
وإليك كلمة أخرى هي كلمة الفاكهة، وسنكتفي بنقل كلام القاموس ممزوجاً بشرحه تاج العروس: “الفاكهة الثمر كله”، هذا قول أهل اللغة وقال بعض العلماء: كل شيء قد سمي من الثمار في القرآن نحو التمر والرمان فإنا لا نسميه فاكهة، وقال: لو حلف أن لا يأكل فاكهة وأكل تمراً أو رماناً لم يحنث. وبه أخذ الإمام أبو حنيفة واستدل بقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (الرحمن: 68)، وقال الراغب: وكأن قائل هذا القول نظر إلى اختصاصهما بالذكر وعطفهما على الفاكهة في هذه الآية، وأراد المصنف رد هذا القول تبعاً للأزهري فقال: وقول فخرج التمر والعنب والرمان منها مستدلاً بقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}، باطل مردود وقد بينت ذلك مبسوطاً في كتابي: اللامع المعلم العجاب، في الجمع بين المحكم والعباب. وقد تعرًّض للبحث الأزهري فقال: “ما علمت أحداً من العرب قال إن النخل والكروم ثمارها ليست من الفاكهة وإنما شذَّ قول النعمان بن ثابت في هذه المسالة عن أقاويل جماعة الفقهاء لقلة معرفته بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين، والعرب تذكر الأشياء جملة ثم تخص منها شيئاً بالتسمية تنبيهاً على فضل فيه، قال تعالى:{مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ…} (البقرة: 98)، فمن قال إن جبريل وميكال ليسا من الملائكة لإفراد الله عز وجل إياهما بالتسمية بعد ذكر الملائكة جملة فهو كافر؛ لان الله تعالى نص على ذلك وبينه ومن قال إن ثمر النخيل والرمان ليس فاكهة لإفراد الله تعالى إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة جملة فهو جاهل وهو خلاف المعقول وخلاف لغة العرب”، ورحم الله الأزهري لقد تحامل في المسالة على الإمام – رضي الله تعالى عنه – ولقد كان له في الذب عنه مندوحة ومهيع واسع قال شيخنا وقد تعرض الملا علي في الناموس للجواب فقال: “هذا الاستدلال صحيح نقلاً وعقلاً فأما النقل فلأن العطف يقتضي المغايرة، وأما العقل فلأن الفاكهة ما يتفكه به ويتلذذ من غير قصد الغذاء أو الدواء، ولا شك أن التمر من جملة أنواع الغذاء والرمان من جملة أصناف الدواء. وقال شيخنا هذا كلام ليس فيه كبير جدوى وليس لمثل المصنف أن يعترض على أبي حنيفة في أقواله التي بناها على أصول لا معرفتة للمصنف بها، ولا لمثل القاري أن يتصدى للجواب عنها بما لا علم له به من الرأي المبني على مجرد الحدس ولو علمت أقوال أبي حنيفة – رضي الله تعالى عنه – في ذلك وأدلته لأغنت وأقنت على أن التعرض لمثل هذا في مصنفات اللغة إنما هو من الفضول الزائدة على الأبواب والفصول”، قلت: وقد أنصف شيخنا – رحمه الله تعالى – وسلك الجادة وما اعتسف و{…إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ…} (الأنفال: 38)، انتهى كلام الزبيدي وفيه من التحامل من الجانبين ما لا يخفى.
قلت: إنه لا ينبغي أن يضل هذا الخلاف مؤبداً جامداً في كتب الفقه لا يبرح مكانه لأن أصل المسألة هو لغوي فكان الرجوع على اللغويين جديراً بحل العقدة إذ أن العودة إلى تطور الاستعمال العرفي للغة كفيل أن يجعل فرقاناً لأهل الفقه وبياناً لأن اللغة كائن متطور بتطور العرف الاستعمالي للمتكلمين، وقد تفطن الأصوليون لذلك وهم يتعاملون مع التعريف الظاهر في مقابل النص والمجمل الذين يكتنفانه حيث علقوا الظهور تارة بالحقيقة اللغوية قبالة المجاز كما انتحاه القاضي أبو بكر الباقلاني، إلا أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني انتبه فنبه إلى أن الحقيقة اللغوية الأصلية قد لا تكون الأساس الوحيد للظهور إذا تطور الاستعمال العرفي ليصير معنى آخر يتبادر إلى الفهم من اللفظ وربما أصبحت الحقيقة الأصلية مهجورة ويصبح رد كلام المتكلم إليها من باب التأويل.
قال إمام الحرمين بعد ذكر تعريف القاضي أبي بكر للظاهر: “ويخرج مما ذكره المجازات الشائعة المستفيضة في الناس المنتهية في جريانها حائدة عن الحقيقة إلى منتها لا يفهم منها حقيقة موضوعها، كالدابة من دب يدب، قطعاً وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد في الفعل المتصرف وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر. انتهى محل الاستشهاد وأطال في ذلك مستعرضاً كلام الأستاذ أبي إسحاق[4].
ونحى الباجي هذا المنحى في بحثه في دلالة الأمر قائلاً : “لأن اللفظ إنما يستغني عن قرينة فيما شهر بالاستعمال فيه ويفتقر إلى قرينة فيما عرف أنه يستعمل في غيره أكثر كالغائط فإنه حقيقة في المطمئن من الارض، مجاز في قضاء الحاجة، ثم مع ذلك يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته، ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه، وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال”.
وأطال في الشرح مستعرضاً بعض الألفاظ كلفظ الوطء، فلو قال وطئت الجارية لا يحتمل أن يكون وطئها برجله أو جامعها، ثم لو أطلق اللفظ لحمل على الجماع[5].
ولهذا فإن الرجوع إلى الاستعمال العرفي للغة، وهو مصطلح اخترناه كما أسلفنا حتى لا نقابل بين الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية لأن الواقع يدل على أن الثانية إنما هي نتيجة لتطور الأولى إلا أن الاستشهاد بالأحاديث النبوية يدخل عنصراً جديداً وهو اعتبارها حقيقة شرعية وهذه مقدمة على الحقيقة اللغوية عند بعضهم كما هو مشهور مذهب مالك، وإن كان خليل في مختصره قدم العرف القولي – الحقيقة العرفية على المقصد اللغوي – الحقيقة اللغوية وقدم المقصد اللغوي على المقصد الشرعي – الحقيقة الشرعية فقال: “ثم بساط ثم عرف قولي – ثم مقصد لغوي، ثم شرعي، وقد رد عليه الشروح”[6]، وأشار في المغني إلى أن تخصيص العام بالنية هو مذهب مالك وأحمد خلافاً للشافعي وأبي حنيفة، حيث قالا بإبقائه على الوضع الظاهر لغة وقد رد عليهما بأن العرب تعرف ذلك مستشهداً بشواهد[7]، ومثله في خليل وشروحه عند قوله: “وخصصت فيه الحاف وقيدت إن نافت وساوت”[8].
وفي رأينا أن الرجوع إلى اللغة باعتبار الحقيقة العرفية هي تطور للاستعمال اللغوي من شانه أن يلغي هذا الخلاف في عشرات المسائل في باب الأيمان وهي مسائل منتشرة في كتبهم يكفي أن تراجع المغني من ص763 حتى ص824. وورد هذه الألفاظ في الاحاديث لا يمنع حملها على الاستعمال العرفي في اللغة، ويكفي أن تعرف أن اللفظ إذا ورد في كلام الشارع دون تعليق حكم عليه لا يصبح حقيقة شرعية بل يتصرف فيه بالعرف اللغوي كما نص عليه السيوطي[9] وغيره فلو حلف لا يأكل لحماً وأكل سمكاً ما حنث عند من لا يطلق عليه اللحم مع أنه سمي في القرآن لحماً، وقد اختلف الشافعية فيما يتعلق بالمعاني العرفية للغة هل تقدم على المعاني الأصلية؟ فذهب إلى تقديم العرفي البغوي وإلى تقديم الوضع الأصلي القاضي حسين[10].
وقد أغرب أصحابنا المالكية فجعلوا أي لفظ يستعمله بنية الطلاق يقع به الطلاق حتى ولو قال لها: اسقني الماء، مع أن الطلاق لا يقع في المذهب بالنية وحدها فكيف يقع بهذه الكلمة إذا انضمت إليها؟ إن لم يكن معنى ذلك أن ألفاظ اللغة قابلة للحركة في مهب رياح المقاصد والنيات، فقال خليل المالكي في مختصره: “بكا سقني الماء وبكل كلام لزمه”. وناقش شروحه كون هذا من باب الكناية أم لا[11]؟، ويرجع هذا جزئياً إلى قاعدة خلافية مؤصلة في علم الأصول وهي: هل اللغة توقيفية بمعنى أن الباري جلَّ وعلا علمها لخلقه وحيا ووضعها وضعاً فلا يجوز فيها التصرف بالنقل والتغيير إلا طبقاً لقوانينها المنضبطة وأسسها الثابتة أم أن اللغة اصطلاحية راجعة إلى ما يصطلح عليه الناس ويتواطئون عليه فلو شاؤوا وضعوا لفظ الأسود للأبيض والعكس والماء للنار وهكذا بدون قيد إلا ما يتفق عليه العقلاء.
والأول: مذهب الأشعري وابن فورك وجماعة مستدلين بقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا…} (البقرة: 31).
والثاني: مذهب أبي هاشم وأتباعه وأطالوا البحث في هذه المسألة التي يرى بعض الأصوليون أنها لا يترتب عليها شيء كبير فالخطب فيها يسير[12]، إلا أن بعض المالكية رتبوا على هذا الخلاف مسألة الطلاق باسقني الماء فيقع الطلاق فيه بناء على أنها اصطلاحية.
قال سيدي عبد الله في مراقي السعود:
واللغة الرب لها قد وضعا **** وعزوها للاصطلاح سمعا
يبنى عليه القلب والطلاق **** فكا سقني الشراب والعتاق
كل ما أشرنا إليه يدل على اضطراب وتباين في الآراء وتفاوت نظرتهم حول اللغة ومدلولات الألفاظ وعلاقة ذلك بالعرف والقصد.
وكل هذا في ألفاظ المكلفين دون ألفاظ الشارع التي أناط بها أحكاماً إلا أننا نجد أبا حنيفة هنا أيضاً يعمد إلى عرف الاستعمال في زمن الشارع ولو خالف ظاهر اللغة كالعموم مثلاً فيخصص بالعرف ولهذا فإن بعض أصحابه يقولون في نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الطعام بالطعام أن هذا النهي منصب على البر فقط، لأنه الطعام في عرف الاستعمال ويجادلهم الشافعية في ذلك جدالاً شديداً[13]، لأنهم – الشافعية – يقولون أن علة الربا الطعمية.
ولعل مخرج اللغة الذي اقترحناه سيلغي هذه الخلافات أو يؤدِّي إلى اجتهاد ترجيحي فيها والله أعلم.
الهوامش والمراجع
[1] – الاستغناء للقرافي، ص17.
[2] – جامع أحكام القرآن، القرطبي، ج12 ص116-117، بتصرف.
[3] – نفس المرجع، وتخريج الحديث سنن أبي داوود، ج3 ص363.
[4] – البرهان للإمام الحرمين، ج1 ص417.
[5] – أحكام الفصول، أبو الوليد الباجي، ص82-83.
[6] – الزرقاني على الخليل، ج3 ص69.
[7] – المغني لابن قدامة، ج8 ص764.
[8] – الزرقاني، ج3 ص64.
[9] – الأشباه والنظائر لسيوطي، ص67.
[10] – الأشباه والنظائر لسيوطي، ص67.
[11] – الزرقاني على الخليل، ص103.
[12] – هذا كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة، ج1 ص 471، وما بعده.
[13] – البرهان لإمام الحرمين، ج1 ص446.