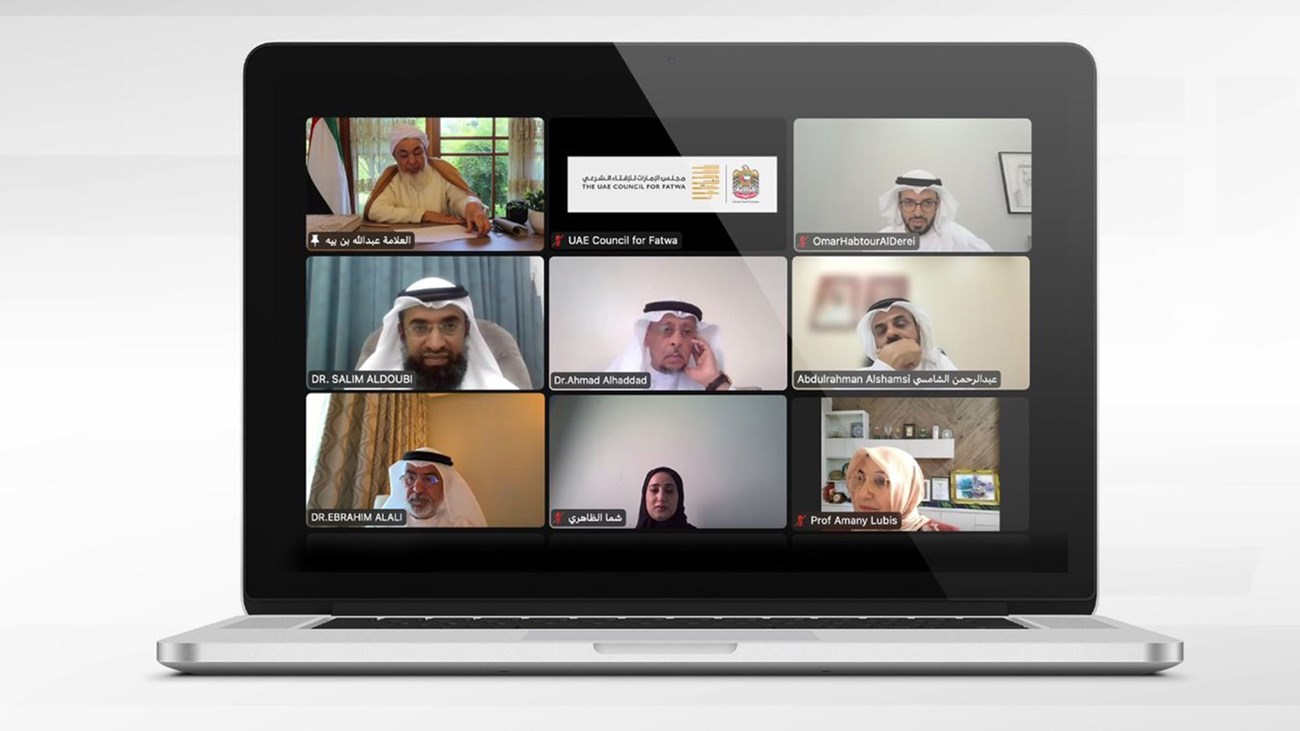تكفير من لم يحكم بما أنزل الله – تخريج فقهي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا بحث ليس بالطويل المستوعب للدقائق، وليس بالقصير المقتصر دون كُبريات الحقائق، ويتكون البحث من مقدمة تُبين أهمية هذا الموضوع في الوقت الحاضر وخطورته.
- فصل في تعريف الردّة والكفر.
- فصل عن خطورة التكفير.
- فصل في أقوال العلماء في موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، والترجيح بينها باعتبار الأدلّة.
- الخاتمة: فيها نتيجة البحث والخلاصة.
مقدمة:
إن المجتمع الإسلامي يعيش أزمة واضطرابًا مفاهيميا يُعطّل كل قدراته على التطور ومكافحة التخلّف، بل تشل كل قواه التفكيرية، إنها (الفتنة).
إن هذا الوضع يرجع إلى أربعة عوامل جوهرية:
العامل الأول: التفاوت في درجة التديُّن بين الأفراد في المجتمع الواحد.
الذي يُغذّيه رافدان تربويان متباينان كل التباين: رافد ينبجس من ينبوع الثقافة الإسلامية طبقًا لجملة من المفاهيم الموروثة التي يُمثل بعضها حقائق دينية لا يمكن الجدل فيها، بينما يُمثل البعض الآخر اجتهادات قد يَروج بعضها على حساب اجتهادات أخرى لظروف معينّة ومتغيّرة.
أما الرافد الثاني فهو رافد مستوطن بنسب متفاوتة طبقًا لخصائص كل مجتمع، مُتمثلا في التيار المتغرِّب بمفاهيمه الفلسفية، ونُظمه التي لم يتكلف عناء تكييفها تكييفًا غير قسري بالبيئة الأصلية؛ ولهذا فإنه لم ينجح في جعله أداة لتطوير اجتماعي طوعي يحدّ من سلبياته.
العامل الثاني: التخلّف التنموي.
الذي يجرُّ وراءه موكبًا مخيفًا ومريعًا من الفقر المدقع، وغلاء المعيشة، وتدهور أوضاع الطبقات الدنيا والمتوسطة، وارتفاع هائل في أعداد العاطلين الذين طحنتهم رحى البطالة، وبالأخص الشباب الذين تُساورهم الحيرة من جرّاء غموض المستقبل، وانسداد أفق الحصول على عمل يضمن حدًا أدنى من الدخل الذي يكفل عيشًا كريمًا، ولو متواضعًا، يتمثل في المسكن والزواج والغذاء والكساء.
تلك الحالة النفسية اليائسة التي تتحول تدريجيًا إلى ثورة بركانية هائجة لا يُمكن التكهُّن عن نتائجها.
العامل الثالث: العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وهذه تُشكّل أزمة أخرى من الأزمات الفكرية والتطبيقية، فمن الناحية النظرية لا يوجد اتفاق على فلسفة الحكم وآلياته المختلفة، ومن الناحية العملية لا يوجد اتفاق على الممارسات القائمة بين السلطة والأفراد في أكثر من قطر من أقطار العالم الإسلامي بلا ضوابط.
هذه الأزمة يمكن محاولة الاقتراب من فهمها بتقرير وجود تيارين فكريين أساسيين طبقًا للتصنيف الذي أشرنا إليه في العامل الأول:
التيار الديني الذي يدعو إلى قيام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس البيعة الشرعية (بيعة أهل الحل والعقد)، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما يستتبع ذلك من وجوب الطاعة فيما ليس بمعصية مُجمَع عليها، وعدمِ نزع يده حتى ولو جار طبقًا لمقولة الإمامين مالك بن أنس وسفيان: (سلطان جائر سبعين سنة خير من أُمَة سائبة ساعة من نهار) (1).
ويجوز لهذا الإمام أن يعهد لمن يشاء ليتولى الحكم من بعده، والفلسفة الإسلامية في هذا تقوم على قاعدة جوهرية مفادها أن الاستقرار وقطع دابر الفتن راجح على التغير العنيف مهما كان (واعدا).
إن التيار الذي يسميه البعض (بالمحافظ) أو (التقليدي) هو الفكر الذي ظل سائدًا طيلة القرون الماضية عند أهل السنّة وما زال، إلاّ أنه تولدت داخله اتجاهات فكرية ذات ميول تطمح إلى تفسير مذهب أهل السنّة تفسيرًا لا يقاوم إغراء رياح التغيير بحيث ينزع إلى تقمص الفكر الخارجي نسبيًا.
أما التيّار الثاني فهو التيار التحديثي الذي يعتنق الديمقراطية الغربية التي تقوم إجمالاً وباختصار شديد على أساس (العقد الاجتماعي)، كما سمّاه جان جاك روسو، وفلسفة هذا العقد تمنح الفرد دورًا بارزًا في إثبات الحكم ونفيه، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من حل وترحال دائم في الهيئة الحاكمة كحال الحكومات الإيطالية، إلا أنه على كل حال يجعل الفرد يعيش شيئًا من التوازن النفسي لشعوره بضلوعه فيما يجري؛ ودوره بالفعل أو بالقوة في آلية الحكم.
لسنا بصدد مناقشة دستورية، بل المقصود ملاحظة كون هذين التيارين العريضين هما المسيطرين على الساحة الفكرية، هذا هو (مُسجر) تنور الأزمة التي تهز أكثر من قطر من أقطار العالم الإسلامي، حيث تقوم أنظمة سلطوية لا هي شرقية ولا غربية، فلا هي قامت على عقد البيعة ولا على (العقد الاجتماعي)، وبالتالي فإنها (أيديولوجياً) على الأقل لم تُرضِ أيًّا من الفئتين المتميزتين فكريًا، ولا جرم قد يوجد أوان أيديولوجية توفيقية تأخذ من هذا وذاك.
العامل الرابع: هو الإعلام بصنوفه وصروفه وقصوره وشفوفه.
هذا الإعلام الذي جعل الأرض بحق قرية كونية لا أسرار فيها ولا حواجز، بل لا خصوصيات فيها على الإطلاق. أصبحت الصحافة تنشر فضائح القرية على الملأ حتى لم تعد توجد فضائح على حد قول الشاعر:
| على أنها الأيام قد صرن كلّها | عجائب حتى ليس فيها عجائب |
الإعلام أصبح مقدمة ونتيجة ووسيلة وغاية، لا يوجّه الأفكار بل يصنع العقول، إن أخبار الجرائم على الرد والتكرار تُعدي الأصحاء وتنكس الأسوياء، والتفنن في عرض النزاعات هو تحريض، فما ينشب نزاع حتى تُصنف أطرافه، ويُدفع لكل منهم لقبًا ليدافع عنه، وهكذا تُذكي الصحافة نار الفتنة بإيعازها الماكر وتؤججها بالكلمة المسمومة، وقديمًا قيل: (وإن الحرب أوّلها كلام).
هذه العوامل متضامنة شكّلت خلفية النزاع الحاد، والأزمة الخانقة التي استُعملت فيها أدوات التبرير ووسائل الدفاع عن طرفي الأزمة، فأصدرت أشنع الأحكام وأقبح الأوصاف والألقاب بما فيها الخروج على الشرعية (المكتسبة) من جهة، والتكفير والارتداد من الجهة الأخرى. وهي أحكام لا تقبل الاستئناف ولا تحتمل الاعتراض على حيثياتها، فالمعترض أو المعارض يخاطر بتعريض نفسه لتهمة مماثلة، فضاقت بالحياد الأرضُ بما رحبت، وهلك خلقٌ لا هو في العير ولا في النفير.
ونعترف أن ما ذكرناه ليس تحليلاً كاملاً لجذور الأزمة، وهي أزمة يمتزج فيها الموضوعي بالذاتي، والديني بالنفعي، والضرورات بالمتطلبات الروحية، والحضارة والتاريخ بمقتضيات العصر والتعايش مع الأمم الأخرى، إنها الحياة الإنسانية بكل أبعادها.
وحيث إن التكفير هو حكم شرعي يستمد قوته ونفوذه من مرجعية الشريعة الإسلامية، فالأمر في إصداره يستدعي عرض أسسه على ميزان الشرع القائم على الكتاب والسنّة وفهم سلف الأمة، ولهذا فسنعالج في هذا البحث مسألة (التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله) مستعرضين نصوص الكتاب والسنة مستنيرين بأقوال العلماء في معالجة هذا الموضوع، فإن وُفقنا فذلك ما نرجوه، وإن أخطأنا فالخير أردنا.
فمن لم يجد طلبته ولم يُدرك نُشدته فليراجع الأدلة التي سقناها، وليناقش النقول التي وثقناها، فذلك أجدر من محاكمة النوايا والتسوّر على الخبايا.
الفصل الأول:
تعريف التكفير والرّدّة
اعلم أن التكفير هو إصدار حكم على شخصٍ أو جماعة بالكفر؛ سواء كان ذلك أصليًا أو حادثًا، إلا أن الاصطلاح الشرعي للذي يخرج من دينه بعد أن حُكم له بالإسلام هو (الارتداد) أخذًا من قوله تعالى: )وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ) (البقرة : 217).
قال في القاموس – ممزوجًا بالتاج -: (والرِّدة بالكسر اسم من الارتداد، وقد ارتدَّ عنه تحول، والاسم منه الرِّدِّة) (2).
وذكر العلماء عدة تعريفات منها قول ابن عرفة المالكي: (الردة كفر بعد إسلام تقرر) (3). وقال في تنوير الأبصار: (المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان) (4). قال ابن قدامة: (المرتد هو الراجعُ عن دين الإسلام إلى الكفر) (5). وقال الزركشي الشافعي في المنثور في تعريفه للكفر(6): (هو إنكار ما عُلم ضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، كإنكار وجود الصانع، ونبوته عليه السلام، وحُرمة الزنا ونحوه، وهذا كما أن الإيمان تصديق الرسول – عليه الصلاة والسلام – في كل ما علم بالضرورة مجيئه به. قال “الزنجاني” في شرح الوجيز: هكذا ضبطه أستاذنا الإمام فخر الدين الرازي، وهو غير واف بالمقصود، إذ الإنكار يختص بالقول، والكفر قد يحصل بالفعل، وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات، وهو كفر في الأصح، وأيضًا فإنا قد نُكفر المجسم والخارجي، وبطلان قولهم ليس من الضروريات، وأيضًا فالطاعن في عائشة – رضي الله عنها – بالقذف كافر إجماعًا وبراءاتها تثبت بالقرآن، والأدلة اللفظية عنده غير موجبة للعلم فضلاً عن الضروري، وشرط الحد أن يكون منعكسًا. قال: ولا يخفى أن بعض الأقوال والأفعال صريح في الكفر وبعضها في محل الاجتهاد.
ومن الأئمة من بالغ فيه وجعل يعد ألفاظًا جرت بها عادت العوام سيما الشُّطار؛ منها ما يساعَد عليه ومنها ما لا.
وفي الجملة تعداد الصور مما يتعذر أو يتعسر حتى قالوا: من أنكر مسألة من مسائل الشرع فهو كافر، وهو خطأ عظيم وجهل ظاهر، وأما المسائل المجتهد فيها ينكرها المخالفون فلا شك أنّ أحد الطرفين شرع فليزم أن يكون أحد المجتهدين كذلك بالجملة، فالتكفير والتضليل والتبديع خطر، والواجب الاحتياط، وعلى المكلف الاحتراز عن مواقع الشبهة ومظان الزلل ومواضع الخلاف. انتهى).
ومن هذه التعريفات تبرز العناصر التالية:
أولها: وهو أساس التعريف وحقيقة الحد المتمثل في الجنس والفصل هو ما عرف به ابن عرفة المالكي، فإن قوله: (كفر) هو جنس للردة، ويدخل فيه الكفر الأصل والطارئ، وقوله: (بعد إسلام تقرر) هو الفصل؛ أخرج به الكفر الأصلي، وما إذا لم يتقرر الإسلام أي لم يثبت(7).
أما تعريف صاحب تنوير الأبصار وصاحب المغني فهو تعريف لاسم الفاعل؛ وهو المرتَد أي الراجع، فالرجوع هو الجنس، وكونه عن (دين الإسلام إلى الكفر) هو الفصل، وهذه التعريفات متقاربة إلا أنها لا توضح كيفية الخروج، إلا أن مُلحقات الحد بينت ذلك.
فقال في تنوير الأبصار: (وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان)، ويجعل التعريف مركبًا إذ كونه ركنًا يدل على أنه جزء لماهية، ولكن ابن عابدين قال: (هذا بالنسبة للظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه، كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين) (8)، وهذا الكلام يجعل الاعتقاد ركنًا إلى جانب الكلام.
أما ابن عرفة فقد جعل الكلام ونحوه وسيلة فقط لظهور الردة وليس جزءًا من الماهية فقال: (عن ابن شاش: ظهور الردة إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) (9).
وهكذا فإن هذه الثلاثة هي مظاهر الردة، وقد نقل ابن عرفة كلام ابن شاش في عقد الجواهر الثمينة فيما تظهر به الردة ولكنه لم يتبعه في التعريف، فابن شاش عرّف الردة بأنها (عبارة عن قطع الإسلام من مكلف) (10)، وبهذا تكون الردة أمرًا قلبيًا مظهرها الخارجي الذي يحكم به قول صريح أو مقتض أو فعل متضمن.
وقد اقتصر الأحناف على القول فيما مر إلا أنهم أضافوا الفعل، فقد قال ابن عابدين في الحاشية: (وكما لو سجد لصنم ووضع مصحفًا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مُصدقًا؛ لأن ذلك في حكم التكذيب، كما أفاده في شرح العقائد) (11).
أما تعريف الزركشي الذي نقلنا فهو تعريف للكفر، وهو أعم من الردة، وجعل الجنس فيه الإنكار، والفصل فيه هو ما عُلم من الدين ضرورة، وهذا التعريف للرازي؛ وهو مثل تعريف الأحناف الذي يعتبر إجراء كلمة الكفر على اللسان ركنًا للردة، وقد ناقشه الزنجاني قائلا: (إن الإنكار يختص بالقول والكفر قد يقع بالفعل). ولكن الزركشي بعد نقله لاعتراض الزنجاني على الرازي ناقش قائلاً: (وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنار ونحوه على الضابط فجوابه أنه ليس على الحقيقية كفرًا، لكن لما كان عدم التصديق باطنًا جعل الشرع له مُعرفات يدور الحكم الشرعي عليها، والظاهر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهذا ونحوه فلم يخرج الكفر عن أول التصديق)(12).
بعد هذه المناقشات يبدو أن الردة مردها إلى القلب، وأن وسيلته هي اللسان، أما الأفعال فقد تُعطى حكم التصريح إذا كانت واضحة، وقد بالغ بعض العلماء بالتمسك بالعقد القلبي كأساس فريد للكفر، فقال الشوكاني:
(فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يُرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه) (13).
وإذا كان الأمر مردودًا إلى القلب لأن الكفر نقيض الإيمان والإيمان محله القلب؛ فإن العلامات التي تترجم عن القلب يجب أن تكون واضحة شارحة غير غامضة ولا مشتبهة ولا محتملة لخطورة أمر الردة، وهذا هو الفصل الثاني في البحث.
الفصل الثاني:
عظمُ التكفير وخطورة أمره
قال تعالى: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (النساء: 94).
وفي الأحاديث الصحيحة في النهي الشديد والوعيد لمن يرمي غيره بالكفر، فقد روى البخاري وأحمد:
(ومن رمى مؤمن مؤمنًا بكفر فهو كقتله) (14).
(إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما) (15).
والأحاديث بمثل هذا المعنى كثيرة، وما ذلك إلا لما يستلزمه الكفر من النتائج الخطيرة التي من جملتها إباحة الدم والمال، وفسخ عصمة الزوجية، وامتناع التوارث، وعدم الصلاة عليه، ومنع دفنه في مقابر المسلمين، وغيرها من البلايا والرزايا نعوذ بالله تعالى منها.
هذا وقد اختلف العلماء في مسائل التكفير وتبادلت الطوائف تهمته بحق أو بغير حق، إلا أنه بسبب ما ورد فيه من الوعيد حذّر أشد التحذير من التكفير جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام السبكي:
(ما دام الإنسان يعتقد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكفيره صعب) (16).
وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني: (لا أكفر إلا من كفرني).
قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: (وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما)، وكأن هذا المتكلّم يقول: الحديث دلّ على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين إما المكفِّر أو المكفَّر، فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه).
وقد بالغ الإمام أبو حامد الغزالي حتى نفى الكفر عن كل الطوائف فقال:
(هؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة الدماء والأموال من المُصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم.
وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكّفر بعضها بعضًا، فالأشعري يكفّر المعتزلي زاعمًا أنه كذّب الرسول في رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات وفي القول بخلق القرآن، والمعتزلي يكفّر الأشعري زاعمًا أنه كّذب الرسول في التوحيد، فإن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء).
قال: (والسبب في هذه الورطة الجهلُ بموقع التكذيب والتصديق، ووجهه أن كل من نزَّل قولاً من أقوال الشرع على شيء من الدرجات العقلية التي لا تُحقق نقصًا فهو من التعبد، وإنما الكذب أن ننفيَ جميع هذه المعاني ويزعمَ أن ما قاله لا معنى له وإنما هو كذب محض، وذلك هو الكفر المحض، ولهذا لا يكفَّر المبتدع المتأول ما دام ملازمًا لقانون التأويل؛ لقيام البرهان عنده على استحالة الظواهر) (16).
وكلام الغزالي الذي لا يُسلمه له كثير من العلماء هو نموذج من التشدد على من يستسهل إطلاق الكفر على الناس.
(وفي جامع الفصولين روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ إذا الإسلام الثابت لا يزول بالشك، مع أن الإسلام يعلو، وينبغي للعالم إذا رُفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره
أقول: قدمت هذا ليصير ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل، فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة، فليتأمل. انتهى ما في جامع الفصولين.
وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم. زاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل. وفي التتار خانية: لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية.
والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. انتهى كلام البحر باختصار) (17).
ومثله نصَّ عليه في تنوير الأبصار مع شرحه رد المحتار، وعلق ابن عابدين على قوله: “ولو رواية ضعيفة” بقوله: (قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية في غير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه) (18).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: (وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أن ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بُسطت في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ أو لإمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما”) (19).
الفصل الثالث:
أقول العلماء في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله
قال عبد الحق بن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز):
(واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)، فقال جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين، وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البراء بن عازب. وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يُخرجهم عن الإيمان) (20).
قال في فتح القدير: (وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ) يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44) قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفرًا ينقل عن الملة بل دون كفره. وأخرج عبد الله بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح في قوله: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال:
إنما أنزل الله (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، (الْفَاسِقُونَ)، (الظَّالِمُونَ)، في اليهود خاصة.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن حذيفة، أن هذه الآيات ذكرت عنده: (الْكَافِرُونَ)، (الْفَاسِقُونَ)، (الظَّالِمُونَ(، فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: نعم، الإخوة لكم بنو إسرائيل؛ إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة، كلا والله لتسلكُنَّ طريقهم قدَّ الشِّراك.وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس) (21).
وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير في تفسيره لهذه الآية:
(وأما الجمهور من المسلمين وهم أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم فهي عندهم قضية مجملة؛ لأن ترك الحكم بما أنزل الله يقع على أحوال كثيرة، فبيان إجماله بالأدلة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب ومساق الآية يبين إجمالها).
إلى أن قال: (وقال جماعة: المراد (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ) مَن ترك الحكم بما أنزل الله جَحدًا له أو استخفافًا به أو طعنًا في حقِّيته بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمِعَه المكلف بنفسه، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن، فـ (من) شرطية، وترك الحكم مجمٌل بيانه في أدلة أُخَر .وتحت هذا حالة أخرى؛ وهي التزام أن لا يحكم بما أنزل الله في نفسه كفعل المسلم الذي تُقام في أرضه الأحكام الشرعية فيدخلُ تحت محاكم غير شرعية باختياره، فإن ذلك الالتزام أشد من المخالفة في الجزئيات، ولا سيما إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية. وأعظم منه إلزام الناس بالحكم بغير ما أنزل الله من ولاة الأمور، وهو مراتب متفاوتة، وبعضها قد يلزمه لازم الردة إن دل على استخفاف أو تخطئة لحكم الله.
وذهب جماعة إلى التأويل في معنى الكفر، فقيل عُبِّر بالكفر عن المعصية كما قالت زوجة ثابت بن قيس: “أكره الكفر في الإسلام” أي الزنا؛ أي قد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين، وروي هذا عن ابن عباس. وقال طاووس: “هو كفر دون كفر، وليس كفرًا ينقل عن الإيمان”) (22).
قال القرطبي في آيات (الْكَافِرُونَ)، (الْفَاسِقُونَ)، (الظَّالِمُونَ(: (نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم، وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل: فيه إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن، وجحدًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والنصارى، أي معتقدًا ذلك ومستحلاً له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبُ محرَّم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا في قوله تعالى: (للذين هادُو)، فعاد الضمير عليهم، ومنها: أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا ترى أن بعده: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ)، فهذا الضمير لليهود بإجماع، وأيضًا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل: (مَنْ) إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها؛ قيل له: (مَنْ) هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة، والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويُروى أن حذيفة سُئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم هي فيهم، ولتسلكُنَّ سبيلهم حذو النعل بالنعل.
وقيل: (الْكَافِرُونَ) للمسلمين، و(الظَّالِمُونَ) لليهود، و(الْفَاسِقُونَ) للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضًا. قال طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حَكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكَمَ به هوىً ومعصية فهو ذنب تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعُزي هذا إلى الحسن والسدي) (23).
ونكتفي بهذه الأمثلة لأنها هي حصيلة لأقوال المفسرين لتضمُّنها مختلف الأقوال سواء تلك المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الموقوفة على الصحابة أو التابعين.
وهي باختصار: الآيات الثلاثة في اليهود، والمسلم لا يكفر بذلك لأنه ذنب، وهذا ما رواه البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا في صحيح مسلم، وعليه معظم العلماء.
أنها عامة في اليهود وفي المسلمين، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد، وفي هذه الحالة فإنهم جميعًا تأولوا عن طريقين:
أولاهما: حمل اللفظ على غير ظاهره من الكفر المُخرج عن الملة، وهو المروي عن ابن عباس وأصحابه وهو (كفر دون كفر).
ثانيهما: تقدير محذوف، وهو ما يُسمى بدلالة الاقتضاء والإضمار، وهذا المحذوف هو ردًا (للقرآن) أو (جحدًا) أو فعل فعلاً يضاهي فعل الكافرين، أو (مستحلاً له) أو (معتقدًا ذلك) أو (بجميع) أي بالتوحيد أو (تبديلاً).
فإذا كانت الآية خاصة باليهود على ما في حديث البراء، وقلنا إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، فلا حُجَّة فيها، وإذا كانت عامة في المسلمين معهم فإن جميع من يُعتد بهم من السلف تأولوها على النحو الذي تقدَّم بأن حملوا الكفر على أنه كفر غير مخرج عن الملة؛ لأن كلمة الكفر قد تكون في الكفر الأكبر وفي الكفر الأصغر كما مرَّ، فحمله على غير الظاهر منها هو تأويل لوجود قرينة هي عدم التكفير بالذنب من جهة، ومن جهة أخرى ورود الكفر في لغة الشرع للفسق والفعل القبيح، أو تأويلها على تقدير محذوف يوجب الكفر هو الاستحلال والجحد والرد والتبديل، وقد تقول: لماذا؟ والجواب: أن هذا الفعل بمجرده ليس من الأفعال المُوجبة للكفر، فتعين إيجاد شيء موجب للكفر لو وُصف به أي فعل آخر لكان كفرًا.
فإذا كان الأمر كذلك والفعل لا يوجب كفرًا، فإن الحكم بالكفر به غير ممكن إلا إذا ثبت الاستحلال بتصريح وكان ما عُلم من الدين ضرورة، فقيام الاحتمال كافٍ لإسقاط تهمة الكفر مهما كان الواقع في حقيقة الأمر، ولو لم يكن الأمر كذلك ما أتعب السلف أنفسهم في هذه التأويلات تجنبًا للتكفير بالذنب الذي هو مذهب الخوارج.
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه “التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد”: (وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالمًا به، رُويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44) و(الظَّالِمُونَ)، و(الْفَاسِقُونَ) ، نزلت في أهل الكتاب.
قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا، قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملّة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأُمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، روي هذا المعنى عن جماعة العلماء بتأويل القرآن، منهم: ابن عباس وطاووس وعطاء. وقال الله تعالى: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (الجن:15)، والقاسط: الظالم الجائر) (24).
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تطرق لهذه القضية في أكثر من موضع، وهو لا يخرج كثيرًا عما درج عليه غيره من العلماء والمفسرين عكسًا لما قد يظنه البعض فقال: (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل”، وقال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وقد قال الله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31)، وفي حديث عدي بن حاتم – وهو حديث طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما – وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له إنّا لسنا نعبدهم، قال: “أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم”. وكذلك قال أبو البختري: “أما إنهم لم يصَلُّوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية”.
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونُهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة الرجال وتلك عبادة الأموال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر الله تعالى أن ذلك شرك بقوله: (لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة: 312)) (25).
وفصل رأيه هذا بعد صفحتين قائلا: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلّل الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدَّلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركًا – إن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم – واعتقاد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشتركًا مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكمُ أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الطاعة في المعروف”، وقال: “على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية”، وقال: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”، وقال: “من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه”)(26).
إنه بمراجعة كلام شيخ الإسلام من أوله إلى آخره نجده ساق تحريم الحلال وتحليل الحرام في الشرك الأصغر والكفر الأصغر، حيث ذكر كلام ابن عباس وأصحابه قائلاً إنه قول أهل السنة أحمد وغيره، وفي نهاية كلامه على حديث عدي بن حاتم ساوى بين عبادة الرجال وعبادة الأموال، وهي التي أشار إليها قبل ذلك في حديثه عن قوله عليه السلام: ” تَعِس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة ” (27).
إلا أن شيخ الإسلام في كلامه الثاني استدرك وفصَّل مبينًا أن الاتباع في تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا كان اعتقادًا مخالفًا للشرع فإنه كفر أكبر، أما إذا لم يوجد اعتقاد منافٍ فإنه معصية، وهو كلام نفيس موافق لكلام غيره من العلماء، فمرد الكفر إلى الاعتقاد وليس للأفعال، وما ذكرُ أبي عمر بن عبد البر للحكم بغير ما أنزل الله في قائمة الكبائر إلا دليلاً على أنه لا حظ أنه من باب أفعال المعصية وليس من باب الكفر الناقل عن الملة.
وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك في أكثر من موضع فقال: (وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)، قالوا: كفروا كفرًا لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة) (28).
وقال في موضع آخر: (وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون بالكواكب وبالكواكب”، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44) (فأولئك هم الظَّالِمُونَ)، (الْفَاسِقُونَ)، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم, وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما)(29).
وقفة مع كلمة الكفر
الكفر في اللغة هو الستر والإخفاء، وقد ورد في كلام الشرع دون أن يقصد الكفر الأكبر المخرج عن الملة، قال تعالى: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران: 97).
ووردت أحاديث كثيرة فيها استعمال كلمة الكفر محتملة أكثر من معنى، وترجم النووي في شرح مسلم بقوله: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض”، وهو لفظ حديث عن جرير قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: “استنصتِ الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض”، والرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: “ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض”، قيل في معناه سبعة أقوال:
أحدها: أنه كفر في حق المستحِل بغير حق.
والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام.
والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
والرابع: أنه فعل كفعل الكفار.
والخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا، بل دوموا مسلمين.
والسادس: حكاه الخطابي وغيره، المرد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يُقال: تكفّر الرجل بسلاحه إذا لبسه، قال الأزهري في كتاب “تهذيب اللغة”: يُقال للابس السلاح كافر.
والسابع: قال الخطابي: ومعناه لا يُكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا.
وأظهر الأقوال الرابع: (أنه فعلٌ كفعل الكفار)، وهو اختيار القاضي عياض – رحمه الله – (30).
قال النووي في تفسيره لحديث: (اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب والنياحة على الميت): (وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المُستحِل) (31).
وكذلك في حديث: (أيمّا عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)، وكذلك حديث: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب).
وكل هذه الأحاديث في صحيح مسلم وترد عليها الاحتمالات السابقة، إلا أن من قال: مُطِرنا بنوء كذا معتقدًا في الكوكب فهو كفر مخرج عن الملة، وإلا فهو كفر بالنعمة(32). وفي الحديث: (يكفرن العشير ويكفرن الإحسان) وهو في الصحيح.
ونقتصر على هذه الأمثلة من مرجع واحد، وهي في الصحاح وغيرها في كل المراجع والمصادر، وخوف الإطالة نكتفي بما ذكرناه.
ومن هذا نذكر أنَّ كلمة الكفر مشتركة بين أكثر من معنى، وأصل معناها الستر والغطاء، وما كانت العرب قبل الإسلام تعرفه إلا لهذا المعنى، هكذا يقول ابن فارس في “فقه اللغة”(33) حتى أعطاها الإسلام معاني جديدة أهمها: أن الكفر خلاف الإيمان ولكنه قد يناقض الإيمان تمام المناقضة فيكون كفرًا أكبر، وقد ينافيه منافاة ما لا يصل إلى حد المناقضة الكاملة فيكون كفرًا أصغر، والشارع نطق به مرادًا به كلا المعنيين، والمشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة(34).
والمشترك هو نوع من المجمل، والمجمل في اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء(35)، وحكمه التوقف على البيان الخارجي(36)، أي وحكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به خارجًا عن لفظه(37)، والبيان في هذه المسألة هو بالأدلة على تعين المعنى، وهو هنا الكفر الأصغر.
وإذا قلنا إن الكفر الأصغر في الأكبر فإن الأمر يرجع إلى التأويل وليس إلى البيان، والتأويل هو:
| صرف لظاهر إلى المرجوح | واقسمه للفساد والصحيح |
كما قال في مراقي السعود.
وقال في مختصر الروضة: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا(38)، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس (39).
والدليل هو ظاهر قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ) (النساء:48). وتأويل ابن عباس وغيره قد تقدم.
أدلة المُكفرين بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله:
أولاً: ظاهر آية المائدة (44)، وقد أسلفنا أقوال المفسرين وتأويل العلماء المتقدمين والمتأخرين فيها.
ثانيًا: احتجوا بحديث عدي بن حاتم الوارد على آية التوبة: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ) (التوبة:31).
وقد تقدم نقل كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى، وهو واضح في تفسير هذا الحديث وحمله على محامله، ولعل من أهم تلك المحامل هو (الاستحلال لما حرّم الله وتحريم ما أحلَّ)، وهو أمر يتعلق بالاعتقاد، بمعنى أنهم اعتقدوا المحرم حلالاً والحلال حرامًا لا أنهم وقعوا في المعصية.
ثالثًا: ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير من التكفير في مسألة “الياسق: مجموعة القوانين التي كان يعمل بها التتار”، واختصارًا للموضوع إليك نص ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50): (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المُحكَم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر؛ وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتابٍ مجموعٍ من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنِيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله و رسوله صلى الله عليه وسلم) (40).
أما ابن تيمية فقد قال في منهاج السنة: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية، وكأوامر المُطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المُطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً) (41).
وما سوى هذين الإمامين فإن أكثر ما يعتمده المكفرون هو كلام للمتأخرين عن القوانين الوضعية كالشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وأحمد شاكر في عمدة التفسير(42)، وغيرها، والجواب عن هذا الكلام من وجوه:
الوجه الأول: أن التتار أسلموا على هذه الشرائع ولم يتركوها، والكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين، ولم يلتزم بأحكام الشرع الضرورية فإنه لا يُعتبر مسلمًا عند جماعة من العلماء، منهم مالك، فقد قال مالك وابن القاسم فيمن نطق بالشهادتين ولم يلتزم شعائر الإسلام ولا أحكامه: (يُترك في لعنة الله) (43)، بمعنى أنه يُعتبر كافرًا أصليًا ليس مرتدًا، هذا هو الاحتمال الأول.
الوجه الثاني: هو استحلال ذلك، أي اعتقاده حلالاً، وقد صرح الشيخان بهذا القيد في كلامهما، فيحتمل بعض الكلام على بعض ليتسق مع ما ذكروه وذكره غيرهم في تفسير آيات المائدة، فإنه لا يوجد فرق مؤثر بين هذا وذاك، وبذلك يتسق الكلام وينسجم.
وأقوال شيخ الإسلام في غير هذا الموضوع متفقة مع أقوال غيره من الأئمة، وهي أولى بالأتباع وأرجح في الموازنة.
الوجه الثالث: أن يكون قتالهم لا لسبب الكفر ولكنه لإفسادهم في الأرض ولنحلتهم تلك، كما قال مالك وأصحابه والأشعري من عدم تكفير أهل الأهواء وإنما قال مالك: (إن تابوا وإلا قتلوا لأنه من الفساد في الأرض) (44).
من سائر ما مرّ من أقوال العلماء في تأويل قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44) يتبين أن أيًا من الذين تكلموا على هذه الآية من عهد الصحابة فمن بعدهم لم يتركوها دون تأويل، وما جعلوا مجرد الحكم سببًا للكفر، فلا بد أن يصحبه (جحد) أو (رد) أو (تبديل) أو (استحلال)، وكلمة أبي عمرو بن عبد البر كانت صريحة: (إذا فعل ذلك رجل من هذه الأمة فليس بكفر حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر) وقد قدمنا ذلك.
والإشكال هو: هل وضع التشريعات استحلال أو رد أو جحد؟ وهل يتضمن ذلك تضمنًا لا احتمال فيه؟ وهل هو كالنطق باللسان الذي هو الأصل في التعبير عن ذلك؟
وهنا تكمن صعوبة التكفير لأنه لا يفعله على أنه دين، ومن هنا فإنه ليس تبديلاً للدين، وقد لا يجحد نصوص الدين ولا يعترف بالاستحلال؛ فإن الإدمان على المعصية بإجماع أهل السنة لا يُعتبر كفرًا، بقي الرد، فما معنى الرد، فهل عدم القبول رد؟ وهل الرد فعل أو قول يتضمن الإنكار؟ والظاهر الثاني، فهذا المانع للزكاة إذا لم يُنكر وجوبها فإنه لا يكفر على مذهب جمهور العلماء حتى لو قاتل.
يقول ابن قدامة: (وإن منعها معتقدًا وجوبها وقدَرَ الإمام على أخذها منه أخذها وعزَّره، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم.
فأما إن كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام قاتله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضًا، ولم تُسبَ ذريته، لأن الجناية من غيرهم، ولأن المانع لا يُسبى فذريته أولى، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثًا، فإن تاب وأدى وإلا قُتل ولم يحكم بكفره. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها)، ثم رد ابن قدامة هذا القول(45).
وفي رواية أخرى عن أحمد: لا يُقتل مانع الزكاة المتمنّع، وهو قول مالك والشافعي(46)، أما أبو حنيفة فتارك الصلاة عنده لا يُقتل فضلاً عن تارك الزكاة، قال في تنوير الأبصار: (وتاركها [الصلاة] عمدًا مَجَانَة يُحبس حتى يصلي) (47).
قال ابن رشد في بداية المجتهد في كلامه عن تارك الصلاة: (والجمهور – وهم أهل السنة – على أنه ليس يُشترط فيه؛ أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال؛ إلا التلفظ بالشهادة فقط) (48).
وما كانوا يذكرون في الفعل الدال على الكفر إلا أمثله قليلة غير محتملة منها: السجود للصنم، وإلقاء مصحف بقذر وبعضهم أضاف معها قتل نبي من الأنبياء.
يقول الحافظ في الفتح: (أما بالنظر لما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقرَّ أُجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يُحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم) (49).
ويشهد لما قاله الحافظ في الفتح ما في مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لا إله الا الله كلمة على الله كريمة، لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقًا أدخل الله به الجنَّة، ومن قالها كاذبًا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدًا فحاسبه).
(وجعل الخطابي أن قتال الصحابة للممتنعين عن أداء الزكاة ليس ناشئًا عن كونهم كفارًا بل هم أهل بغي، وقسَّم العرب الذين قاتلهم أبو بكر على ثلاثة أصناف: صنف عاد إلى عبادة الأوثان، وصنف اتبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وصنف ثالث استمر على أصل الإسلام ولكنهم منعوا الزكاة. فيقول: فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين، فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارًا؛ وإن كانت الردة قد أُضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسـم لغوي، وكل من انصـرف عن شيء كان مقبلاً عليه فقد ارتدَّ عنه) (50).
(وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب, وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، وراية ثالثة: لا يفكر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف) (51).
وقد علمت أن الأئمة الثلاثة لا يكفَّرون بترك شيء من هذه المباني على المشهور من مذاهبهم، وأحمد اختلف عنه في ذلك، فإذا كان جمهور العلماء لا يكفّر بالذنب والمعصية تركًا أو فعلاً بما فيها من يقاتل ضد أداء فريضة الزكاة، فما هو رد أوامر الله الذي يكون إذن كفرًا؟
ولم يبق إلا أن يكون الرد هو إنكارًا لفظيًا وجحدًا صريحًا وتجريحًا وقولاً قبيحًا؛ فالاستمرار على الجريمة وأمر الغير بها، كل تلك الأوصاف طردية لا تأثير لها، أما القول القبيح بأن يقول عن الحدود: (إن تطبيقها هو رجوع إلى العهود الظلامية)، ونحو هذا فيحكم على هذه الكلمة بأنها كفر لا يتجاوز قائلها إلى غيره.
هذا الذي تدل عليه النصوص وأقوال السلف والخلف، فالكفر شخصي يتعلّق بحالة كل شخص من الإنكار أو الاستحلال ولا يمكن أن يكون جماعيًا.
قال ابن حبيب: (من اعتــرف بالوجــوب وامتنع كفَر كما قاله في الصلاة) (52).
وقول ابن حبيب كما هو واضح شاذ مخالف لقول مالك وأصحابه.
حصيلة البحث:
لقد تناول هذا البحث إحدى المشكلات الفقهية العملية التي تُمثل إحدى المرتكزات النظرية للأزمة الحادة التي تعيشها الأمة، والتي شخَّص البحث باختصار الأسس النظرية التي سببتها في مقدمتها، وهذه المشكلة هي التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله.
وقد عرض البحث بعد المقدمة في ثلاثة فصول:
في الفصل الأول: معنى التكفير والردّة – أعاذنا الله منها- حيث بين أنَّ الردة رجوع عن الإسلام بعد إيمان تقرر، وحيث إن الردة تقابل الإيمان فمحلها القلب، ولكن الشرع وضع علامات قد تكون قولاً صريحًا – وهذا أولاها بالاطمئنان إليه – لكونه صيغة إذا صدرت من مكلّف مختار، وقد تكون فعلاً واضحًا لا يحتمل أكثر من معنى.
ثم تعرّض في الفصل الثاني لخطورة التكفير والتحذير منه، وفي هذا الفصل نقلنا الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في النهي عن تكفير المسلم، والوعيد الشديد في ذلك حيث ورد في الحديث أنه كفر، وورد أنه كقتل المسلم.
وفي الفصل الثالث: ناقشنا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله نقلاً واستنباطًا، تعليلاً وتحليلاً، وتأصيلاً وتفصيلاً، جمعًا بين الأقوال عند الإمكان، وترجيحًا عند التعارض، حيث توصل إلى أن هذا ليس من الكفر البيِّن أو البواح، فلو فُرضت الكتابة لفظًا فما هو بالصريح، ولو فُرضت فعلاً فما هو بالفعل المتمحض الذي لا احتمال فيه، والدوام والإدمان على التحاكم قرينة غير حاسمة ولا قاطعة، مع إيضاح أن ذلك العمل من أشنع الكبائر إلا أنه لا يرقى إلى الكفر إلا بعاضدٍ من قول، وهذا لا يمنع كون الفاعل كافرا في نفس الأمر، ولكن الحكم عليه بالكفر يفتقر إلى علامة لا لبس فيها.
ولعل هذا البحث إذا كان يتميز بشيء فهو إشراك فقهاء المذاهب في كتبهم المعتمدة في مسألة الخروج عن الإسلام.
كما أن اللمحات الأصولية التي اتخذها الباحث معيارًا يرد إليه النزاع الذي هو في الأصل مردود إلى الله ولرسوله طبقًا للآية الكريمة في سورة النساء: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: 59).
إلا أن ذلك لا ينافي بل يقتضي ردّه إلى العلماء لبيان غامضه ومجمله، واستنباط تأويل مشكله طبقًا لقوله تعالى في نفس السورة: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء: 83).
فنرجو أن يكون هذا البحث مساهمة في تقديم مجموعة من الدراسات العلمية الرامية إلى ترشيد هذه الأمة، وإطفاء جذوة الفتنة، ومحاصرة ما شبَّ من ضرامها حتى لا يصل إلى بقاع وأصقاع أخرى من العالم الإسلامي بحكم النقل، ويشهد شاهد العقل بوجوب تجنيبها الفتن وحمايتها من الشرور والمحن، ذلك ما يقتضيه ترتيب المصالح والمفاسد في سلم الشرع، كما يطمح إلى إبراز بعض جوانب الفكر الإسلامي فيما يتعلق بالمشروع الحضاري الذي لا يكفِّر أحدًا ما وجد إلى ذلك سبيلاً، القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله ولي التوفيق،،،
([1]) ابن فرحون، الديباج المذهب، 9/154، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة.
([2]) تاج العروس: 2/351.
([3]) الحدود لابن عرفة بشرح الرصاع 2/634، طباعة دار الغرب الإسلامي.
([4]) رد المحتار على الدر المختار 3/ 283.
([5]) المغني لابن قدامة 12/264، هجر للطباعة والنشر.
([6]) المنثور للزركشي 3/84-85، طبع وزارة الأوقاف بالكويت.
([7]) من شرح الرصاع بتصرف 2/634.
([8]) الحاشية لابن عابدين: 3/283.
([9]) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع: 2/634.
([10]) عقد الجواهر الثمينة 3/297.
([11]) حاشية ابن عابدين: 3/284.
([12]) المنثور للزركشي: 3/85.
([13]) السيل الجرار للشوكاني: 4/578.
([14]) هو جزء من حديث أوله: ((من خلف بملّة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال))، فتح الباري 8/32.
([15]) متفق عليه، البخاري، فتح الباري 8/32، مسلم 1/79.
([16]) الزركشي، المنثور 2/ 87- 88. والنقل عن الإمام الغزالي من المنثور أيضا.
([17]) حاشية ابن عابدين 3/ 289.
([18]) حاشية ابن عابدين: 3/ 289.
([19]) مجموع الفتاوى: 7/ 685.
([20]) ابن عطية 4/ 456- 457.
([21]) فح القدير للشوكاني: 2/ 48، ويراجع المستدرك للحاكم 2/ 212، 213، والبيهقي 8/ 20، وابن جرير 6/ 164.
([22]) التحرير والتنوير 6/ 211- 212.
([23]) تفسير القرطبي 6/190.
([24]) التمهيد 5/ 74- 75.
([25]) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/ 66- 76.
([26]) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/70 ،71.
([27]) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 65.
([28]) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 312.
([29]) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 522.
([30]) صحيح مسلم بشرح النووي: 2/55، 56.
([31])صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 57.
([32]) نفس المرجع السابق: ص58 -61.
([33]) المزهر للسيوطي 1/ 295.
([34]) المرجع السابق: 1/369.
([35]) مختصر الروضة وشرحه لنجم الدين الطوفي 2/ 648.
([36]) المرجع السابق: 2/ 655.
([37]) المرجع السابق: 2/588-563.
([38]) الطوفي شرح مختصر الروضة 1/ 558.
([39]) المرجع السابق: 1/ 563.
([40]) تفسير ابن كثير 2/ 68.
([41]) منهاج السنة لابن تيمية 5/ 130.
([42]) تفسير المنار 6/ 417، عمدة التفسير 4/ 157.
([43]) الزرقاني شرح خليل 8/ 68.
([44]) القرافي الذخيرة 12/ 27.
([45]) المغني لابن قدامة 4/ 7، 8، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، طبعة هجر.
([46]) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص75.
([47]) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 235.
([48]) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/ 235.
([49]) فتح الباري: 1/ 46.
([50]) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 204، ويراجع فتح الباري 12/ 276 وعمدة القاري 8/ 244.
([51]) مجموع الفتاوى، ابن تيمية 7/ 302.
([52]) مقدمات ابن رشد 1/ 274. الذخيرة، للقرافي 3/8.