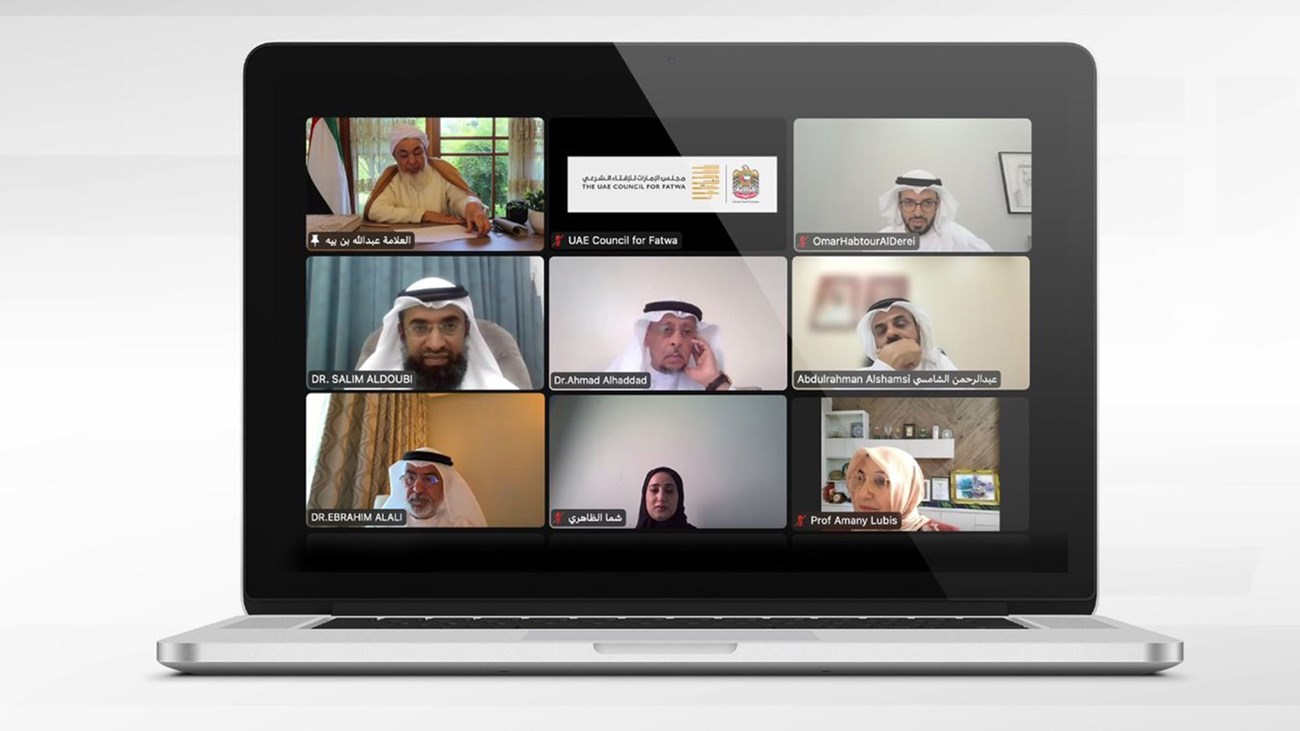حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم.
بحث التَّضخُّم من كتاب: (مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات )
إن هذا البحث مردف بجملة من الملاحق، تشرح بإسهاب بعض الأسس التي اعتمدها الباحث في تأصيل رأيه، وانتحاها في اختيار ما ذهب إليه, وفي هذه الملاحق تجد تكرارا لبعض ما أوردناه في صلب البحث الأصلي، وهو تكرار تدعو إليه الحاجة لإيضاح فكرة أو دفع شبهة، فلا تحسبَنَّ الباحث غافلا عن ذلك, وهذه الملاحق هي:
- ملحق النقود الشرعية وتطورها.
- ملحق الأعواض والمعايير الشرعية.
- ملحق الشروط.
- ملحق نسبة التضخم المعتبرة في الديون.
- ملحق تطبيق وضع الجوائح على حالة التضخم.
وبعد:
فهذا الفصل في نازلة «انخفاض أسعار العملات» الذي عمَّت به البلوى، وطمَّت فيه الشكوى، واستعجمت فيه الفتوى، ورماه البعض فأشوى.
| تَعَفَّقَ بالأرْطَى لها وأرادها | رجالٌ فبذَّت نَبلَهم وكليبُ |
وقد أدليت دلوي في الدلاء، ودلوته بعد التَّأقِ والامتلاء, وقد اتخذ فيها المجمع الفقهي الموقر بعض القرارات، إلا أنه قرر فيها مراجعتها، ونشر ما طواه من صحفها, وحيث إن هذه المسألة ليست منصوصة فيُتوقف عند نصها، ولا هي مشمولة بإجماع فيُنتهى إلى ما أجمعوا عليه فيها، وهي مسألة إلا تكن حديثة بالجنس، فهي ـ بلا شك ـ حديثة بالنوع، وهي من موارد الاجتهاد كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
لهذا أردنا في هذا البحث الذي سيكون اتباعا لا ابتداعا، واقتفاء لا انتفاء، أن نحاول مع ذلك استنباط حكمها واستخراج خَبئها.
أولا: تصوير الموضوع.
إن المنهجية في البحث الفقهي ينبغي أن تكون بتجلية مصطلحاته، ومحاولة التعرف عليه في بيئته إن كان عقدا مستوردا باستنطاق أهل ذلك الفن؛ خصوصا في البحوث الاقتصادية والطبية المعاصرة.
وبعد التصور والتصوير يكون التنقيب عن نص من كتاب أو سنة يدل على موضوع البحث بشكل ما، من الدلالات نصا أو ظاهرا، اقتضاء أو إيماء، أو مفهوم موافقة أو مخالفة، أو قياسا, واقتفاء أثر العلماء والسلف، فإن كان لهم إجماعٌ فلا محيد عنه، وإن لم يكن وكان لهم قول أو أقوال ساغ تتبُّعها لتقليدها بعد استجلاء سبل الترجيح، واللجوء إلى الأدلة المختلف فيها من استحسان واستصلاح.
إن هذه المنهجية لن تكون بعيدة عن بحثنا هذا، فسنحاول طرق الأبواب، وكشف مستور الحجاب، والله المستعان, وسيكون البحث كالتالي:
أولا: مقدمة عن الموضوع، فيها شرحٌ لمصطلحات التغيرات التي تعتري النقود من كساد وانقطاع ورُخْص وغلاء ( التضخم).
ثانيا: ثلاثة فصول مرتبة على النحو التالي:
الفصل الأول: أقوال علماء المذاهب الأربعة في الحكم على هذه التغيرات، نماذج من المذاهب الأربعة مع بيان وجوه الاستدلال.
الفصل الثاني: تأصيل الرأي الفقهي وبيان أسسه وإيضاح أن المسألة اجتهادية, ثم تلخيص الحكم واستنباط الرأي الذي نتوخاه, والله تعالى ولي التوفيق.
الفصل الثالث: عن الشروط.
ثالثا: الخاتمة, والله تعالى ولي التوفيق.
ألقاب تغيرات العملة:
إن التغير الذي يعتري العملة يكون على أربع حالات، هي الحالات التي تطرَّق إليها الفقهاء، وطبقا لمصطلحهم فإن هذه الحالات هي: الكساد أو البطلان ؛ الانقطاع أو الانعدام ؛ الرُّخْص (التضخم) ؛ الغلاء (الانكماش), وهذا الأخير لن نُفرع عليه.
الكساد: من حيث اللغة: هو كون البضاعة غير نافقة، قال صاحب القاموس المحيط ممزوجا بشرح الزبيدي: (كسد) المتاع وغيره، (كنَصَر وكرُم)، اللغة الأولى هي المتداولة المشهورة، والفعل يكسد (كسادا) بالفتح، (وكُسودا) بالضم (لم ينفق), وفي التهذيب: أصل معنى الكساد هو الفساد، ثم استعملوه في عدم نَفاق السلع والأسواق، (فهو كاسد وكسِيد)، وسلعة كاسدة ، (و) كسدت السوق تكسد كسادا، و(سوق كاسد) بلا هاء، وكأنهم قصدوا النسب, أي ذات كساد، و(أكسدَ) في سائر النسخ بالرفع بناء على أنه معطوف على ما قبله, والصواب أنه جملة مستقلة مستأنفة, أي وأكسَدَ القومُ: كسَدت سوقُهم, كذا في اللسان, وعبارة ابن القطاع: أكسد القومُ: صاروا إلى الكساد, (و)كذا قولهم: (أكسدَتْ سوقُهم), وهذا خلاف ما عليه الأئمة, فإنهم صرحوا بأن: أكسد القوم رباعيا، وكسدت سوقهم ثلاثيا، (والكسيد: الدُّونُ)، وبه فُسِّر قول الشاعر:
| إذْ كلُّ حيٍّ نابتٌ بأرومةٍ | نَبْتَ العِضاهِ فماجدٌ وكسِيدُ |
قال ابن بري: البيت لمُعَوِّد الحكماء([1]).
قلت: يبدو أن في النسخة خللين, أولها: (والفعل يكسد)، والصواب المضارع أو ما في معناه, ثانيها: (فإنهم صرحوا بأن: أكسد القوم)، والصواب «بأنه يقال أكسد»، وقد نبه عليه المحشي.
إن تفسير الكساد بعدم النَّفاق «بالفتح» هو من باب تفسير الشيء بنقيضه, ولكن ما هو النَّفاق بالفتح كسحاب؟ هو الرواج، قال المرجع نفسه: نَفَقَ البيعُ ينفُقُ نَفَاقا كسحاب: رَاجَ، وكذلك السلعة تنفُق إذا غَلَت ورُغِب فيها، ونفَق الدرهم نَفَاقا كذلك، وهذه عن اللحياني، كأنه قَلَّ فرُغب فيه([2]).
قلت: هذه إشارة على أن الدراهم إذا كانت قليلة في السوق تكون مرغوبة قوية، وهذا هو ما يُسمى بـ «الانكماش DEFLATION» في لغة الاقتصاد ، وعكسه وهو مفهوم مخالفة في كلام الزبيدي: أنها إذا كثُرت رخُصت، وهذا هو التضخم INFLATION، وهو داخل في المعنى اللغوي للكساد، وسنتعرض له بتفصيل بعد سرد أقوال الفقهاء في تحديد مصطلحات الأحوال التي تعتري العملة.
أما الانقطاع من الناحية اللغوية فهو لفظ غير فني، بمعنى أنه لا يختص بالعملات ولا بالأسواق والسِّلع، بل إنه من مادة (قَطَعَ) بمعنى أبَان وفَصَل، وتأتي للماديات والمعنويات, فمن الأول: قطع لحمه، ومن الثانية: قطع رحمه, وهذا ما عبر عنه الراغب بقوله: (القطع: قد يكون مُدرَكا بالبصر ، كقطع اللحم ، وقد يكون مُدرَكا بالبصيرة ، كقطع السبيل, وذلك على وجهين, أحدهما: يُراد به السير والسلوك ، والثاني: يُراد به الغصب من المارة والسالكين), وانقطع: فعل مطاوع لـ«قطع»، أهملها القاموس، وقال المرتضى: (وانقطع الشيءُ ذهب وقته، ومنه قولهم: انقطع البردُ والحَرُّ، وهو مجاز، وانقطع الكلامُ: وقف فلم يَمضِ، وانقطع لسانُه: ذهبت سلاطتُه)([3]), وهو في العملة من باب المجاز.
مصطلح الفقهاء:
الكساد : عدم رواج العملة، قال الكاساني: (ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا؛ لأن ثمنيتها تثبت باصطلاح الناس، فإذا ترك الناس التعامل بها عددا فقد زال عنها صفة الثَّمنِيَّة), وقد قال قبل ذلك: (لو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ «العقد» عند أبي حنيفة)([4]), وقال في الدر المختار: (ومما يكثر وقوعه: ما لو اشترى بقطَعٍ رائجة فكسدت بضربِ جديدةٍ), قال في رد المحتار :(والكساد أن تُترك المعاملة بها في جميع البلاد)([5]), وجاء في كشَّاف القناع عن متن الإقناع ما يدل على معنى قريب من هذا ، حيث قال: (وعُلم منه أن الفلوس إن لم يُحرِّمها «السُّلطان» وجب ردُّ مثلها، غَلَت أو رخُصت أو كَسدت)([6]).
أما المالكية فإنهم عبروا عن الكساد بالبطلان والانقطاع ، قال خليل: (وإن بطلت فلوس فالمثل)، قال الزرقاني: (أي: قطع التعامل بها بالكلية)([7])، ففُهم مما قال إن الكساد أو البطلان يكون مع بقاء العين, وقد يستعمل المالكية مصطلح «الكساد» في معنىً لا ينافي ما استعمله فيه غيرهم، قال الحطاب: (وإن بِعته سلعة بفلوس إلى أجل، فإنما لك نقد الفلوس يوم البيع، ولا يُلتفت لكسادها)([8]).
وتعريف الفقهاء ليس مناقضا لتفسير اللغويين؛ بل هو داخل في مضمونه، فالكساد: عدم النفاق، وهو يصدق على عدم الرواج مطلقا مع بقاء العين، وهو البطلان, ويصدق على الانخفاض مع عدم الرغبة, وهو في المعنى الأول أظهر، وهو الذي اعتمده الفقهاء، فهو من باب قَصْر العام على بعض أجزائه، أما الانعدام أو الانقطاع فهو عدم وجودها بالكلية في السوق, قال خليل المالكي: )أو عُدمت(، قال الزرقاني: )جملةً في بلد تعامل المتعاقدين، وإن وُجدت في غيرها فالقيمة)([9]), وهذا ما سماه الأحناف الانقطاع، قال ابن عابدين: (وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق؛ وإن وُجد في يد الصَّيَارفة والبيوت, هكذا في الهداية)([10]).
والتضخم هو: تفعُّل من الضخامة، وجذره الأصلي ضخم ثلاثيا كـ«كرم» ضخامة، فهو ضخم أي عظيم غليظ([11]), أما التضخم فهو مُولد منه، ولكن «تفعّل» تأتي لعشرة معان، ومن هذه المعاني: التكرار، والتكلف، كـتَصَبَّر تكلف الصبر، وتجرَّع المريض الدواء، شربه جرعة جرعة مرة بعد مرة بتكلف، ولعل التضخم مأخوذ من هذا المعنى لصعوبته على النفوس، وتفاوته وتكرره في الورود, وقد فُسر التضخم بأنه: «زيادة النقود أو وسائل الدفع الأخرى على حاجة المعاملات»([12])، وهذا نوع من التضخم.
وأصل التضخم الذي هو «INFLATION»، كما يقول القاموس الفرنسي: (وضع أو ظاهرة تتميز بارتفاع عام دائم متزايد بنسب متفاوتة للأسعار).
التضخم الذي ينشأ عن ضخ كمية مبالغ فيها من وسائل الدفع في الدورة الاقتصادية؛ مما يؤدي بواسطة تزايد الطلب إلى ارتفاع الأسعار([13]), ولبسط هذا المعنى والتقاط النتائج التي هي مثار بحثنا نسرد نصا مُبسطا لاقتصادية غربية هي «سوزان لي» في معجم اقتصادي بعنوان «أبجدية علم الاقتصاد», لأن كل فن يُرد إلى أهله وبيئته حتى يتمكن الباحث من خلال تصويرهم له أن يتصوَّره ليحكم عليه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره, تقول سوزان لي عن التضخم: (هو بوجه عام ارتفاع الأسعار).
يبدو هذا بسيطا, ولكن ثمة عدة إجابات للسؤال عن الأسباب في ارتفاع الأسعار، هناك تفسيران يُعرفان باشتداد الطلب, لأن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة مفاجئة في الطلب أو الإنفاق, وينحى علماء النقد باللائمة في اشتداد الطلب على السياسة النقدية، فحين يضع الاحتياط الاتحادي كمية من المال تزيد على ما هو مطلوب للصفقات قيد التداول؛ يستخدم المال الجديد في شراء موجودات كالأسهم والسندات وأجهزة التلفزيون والسيارات.
وإذا افترضنا أن كمية الموجودات في الاقتصاد تظل ثابتة لا تتغير، فإن الطفرة الجديدة في الطلب ستؤدي إلى رفع الأسعار (استخدام كمية أكبر من المال في شراء الكمية ذاتها من السلع يتسبب في ارتفاع الأسعار).
هناك نظرية ثابتة فيما يتعلق باشتداد الطلب يطرحها أتباع «كينز» توافق على أن طفرة من المال الجديد ستنفق في شراء موجودات، غير أنهم يرون أن الأثر الدولي ينبثق من شراء السندات، فإذا فرضنا أن كمية السندات تظل ثابتة، فإن زيادة في طلب السندات ستؤدي إلى رفع أسعارها؛ مما يؤدي بالطبع إلى هبوط معدلات الفائدة, وهذا يؤدي بدوره إلى تشجيع الإنفاق في الأعمال التجارية؛ وبعد الإنفاق في الاستهلاك، وهنا تؤدي طفرة في طلب البضائع إلى رفع الأسعار أيضا. وثمة تفسيرات أخرى تُعرف بارتفاع الكلفة؛ لأن الأسعار كما يقال ترتفع بسبب زيادة مفاجئة في كلفة الإنتاج، وتنحى وجهة النظر التي تنادي برفع الأجور باللائمة في ذلك على نقابات العُمَّال التي تطالب بأجورٍ أعلى مما يبرزه إنتاج العمال، وعندها تضطر الشركات إلى رفع أسعارِ نِتاجها لتغطية تكلفة العمل العالية هذه, ويقول المنادون بزيادة السلع إن زيادة أسعار السلع نتيجةٌ لقرارات سياسية يتخذها المنتجون مثل «منظمة أوبيك»، أو نتيجة لرداءة الطقس كجفافٍ في منطقة زراعة الحبوب؛ ستمتد إلى باقي القطاعات الاقتصادية فترتفع الأسعار بصورة عامة.
ترى ما هي النظرية الصحيحة؟
قد تكون جميع النظريات صحيحة، أي لا يوجد هناك جواب واحد، فالتضخم قد تتسبب فيه أشياء كثيرة، بعضها أهم من بعضها الآخر في وقت معين, وقد تختلط أسباب التضخم على المرء، ولكن عواقبه لا تختلط عليه، وقد يكون التضخم رديئا بالنسبة إلى بعض الناس وجيدا بالنسبة إلى بعضهم الآخر، فالتضخم يحول الدائنين إلى خاسرين تُدفع لهم ديونهم بمال قلَّت قيمته، أي «ارتفاع الأسعار بخفض القوة الشرائية للمال؛ بحيث تقل عما كانت عليه عند إقراض مال», والتضخم من ناحية أخرى يُحول المدينين الذين يستطيعون الوفاء بديونهم بمال قلَّت قيمته إلى رابحين.
وهناك فئات تتمتع بمناعة ضد أية وطأة، فالأجور عادة تسير جنبا إلى جنب مع معدلات التضخم، وتنص معظم عقود النقابات على جدولة غلاء المعيشة، كما تُجدول علاوات الضمان الاجتماعي؛ والعلاقات التقاعدية الاتحادية؛ ومعظم العلاوات التقاعدية في المرافق الخاصة.
على أن هناك نوعا من التضخم يُقوض الترتيبات الاقتصادية التي تُعوض الخاسرين في مختلف أنحاء البلاد، ألا وهو الإفراط في التضخم، وهذه حالة ترتفع معها الأسعار ارتفاعا كبيرا وبسرعة, والمثال الكلاسكي على ذلك: ألمانيا سنة 1922/ 1923م؛ حيث بلغ معدل التضخم 322 بالمئة في الشهر الواحد ففقد النقد قيمته بسرعة؛ بحيث بات الناس في حاجة ماسة إلى استبداله ببضائع، وطالب العمال بدفع أجورهم مرتين في اليوم؛ بحيث يستطيعون التسوق في منتصف النهار, ذلك لأن الأسعار قد ترتفع عند نهاية اليوم، كما أن من يتناولون البيرة كانوا يطلبون قِنينتين مرة واحدة، (وهكذا تكون النكبة)؛ ذلك لأن القنينة الثانية قد تفقد قوتها بصورة أبطأ من سرعة ارتفاع الأسعار([14]). لعل فقرة واحدة في هذا السرد تستوقفنا أكثر من سردها, وهي: «فالتضخم يحول الدائنين إلى خاسرين تدفع لهم ديونهم بمال قلت قيمته …».
كيف نعالج هذه الخسارة؛ أو كيف نجعل المدين يتحمل مع الدائن الغُرْم بعد أن استفاد الغُنْم؟
إن هذا السؤال هو بيت القصيد بالنسبة للفقيه الذي يبحث عن الأسس الشرعية لرفع الخسارة المتحققة دون إلحاق خسارة بالدائن, «فالضرر لا يُزال بالضرر»؛ فلا يأكل مضطر طعام آخر، تلك قاعدة مخصصة لقاعدة «الضرر يزال» كما يقول ابن السبكي([15]), ولكن معالجة الفقيه لا تعدُو الاجتهاد في بيان الحكم الشرعي في العلاقة بين الدائن والمدين، وليست معالجة تقترح سياسة اقتصادية لقطع دابر التضخم وتعفية رسومه وآثاره ـ ذلك موضوع آخر ـ .
وإذا كان الاقتصاديون الغربيون حاولوا حل ذلك الإشكال بما يسمى بـ«الربط القياسي»: ربط الأعواض الآجلة بالمستوى العام للأسعار، أو الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، فإن الإشكال يتمثل في كون هذا الربط بالنسبة للفقيه يجعل العقد إن كان بيعا أو إيجارا أو كراء يشتمل على شرط يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين؛ لأنه لا يدري هل تنزل قيمة العملة التي عقدا عليها، فيترتب له في ذمة المدين أكثر من أصل الثمن المتفق عليه في الأصل، أو ترتفع فيكون العكس، أو تبقى كما هي، وكذلك الدَّين الناشيء عن صداق, أما إن كان قرضا فيكون عُرضة للربا؛ لأن الزيادة المحتملة في عدد النقود بأن أقرضه مائة فرخصت العملة فرد مائة وعشرين تُعتبر شرطا مفسدا للقرض, ذلك هو الإشكال الذي سنعالجه في هذا البحث.
حكم التغيرات من أقوال الفقهاء:
الأحناف:
قال الكاساني: (لو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ العقد عند أبي حنيفة $، وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائما، وقيمته أو مثله إن كان هالكا, وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يبطل البيع، والبائع بالخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس)([16]), قال ابن عابدين: )اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها، أو بالفلوس، ولم يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد، ويجب على المشتري رد المبيع لو قائما، ومثله أو قيمته لو هالكا، وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا, وهذا عنده, وعندهما لا يبطل البيع؛ لأن المتعذِّرَ التسليمُ بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، لكن عند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد يوم الكساد، وهو آخر ما تعامل الناس بها, وفي الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف، وفي المحيط والتتمة والحقائق: وبقول محمد يُفتى رفقا بالناس. والكساد أن تُترك المعاملة بها في جميع البلاد، فلو في بعضها لا يبطل، لكنه يتعيب إذا لم ترُج في بلدهم، فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت، هكذا في الهداية. والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب, لكن قال في المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمتُه في آخر يوم انقطع، وهو المختار, هذا إذا كسدت أو انقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انتقصت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري، ويطالَب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في «فتح القدير», وفي البزازية عن المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت، فعند الإمام الأولُ والثاني، أولا ليس عليه غيرها، وقال: الثاني ثانيا عليه قيمتُها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى، ونقله في البحر وأقره، فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعوَّل عليه إفتاء وقضاء، ولم أر مَن جعل الفتوى على قول الإمام, هذا خلاصة ما ذكره المصنف $ في رسالته «بذل المجهود في مسألة تغيير النقود», وفي الذخيرة عن المنتقى: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلكم سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض. وقوله: يوم وقع البيع, أي في صورة البيع، وقوله: يوم وقع القبض, أي في صورة القرض، كما نبه عليه في النهر في باب الصرف. وحاصل ما مر أنه على قول أبي يوسف المفتى به لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها. وفي دعوى البزازية من النوع الخامس عشر من فوائد الإمام حفص الكبير: استقرض منه دانقَ فلوسٍ حال كونها عشرةً بدانق ، فصار ستةٌ بدانق؛ أو رخُص وصار عشرون بدانق، يأخذ منه عدد ما أعطى لا يزيد ولا ينقص اهـ. قلت: هذا مبني على قول الإمام، وهو قول أبي يوسف أولا، وقد علمت أن المفتى به قوله ثانيا بوجوب قيمتها يوم القرض، وهو دانق أي سدس درهم، سواء صار الآن ستةَ فلوس بدانق أو عشرين بدانق, ومثله ما سيذكره المصنف في فصل القرض من قوله استقرض من الفلوس الرائجة والعَدَالِي فكسدت، فعليه مثلها كاسدة لا قيمتها اهـ. فهو على قول الإمام ، وسيأتي في باب الصرف متنا وشرحا: اشترى شيئا به أي بغالب الغش وهو نافق؛ أو بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع، كما لو انقطعت عن أيدي الناس فإنه كالكساد، كذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل، وصححاه بقيمة المبيع، وبه يُفتى رفقا بالناس, بحر وحقائق اهـ. وقوله : «بقيمة المبيع» صوابه بقيمة الثمن الكاسد. وفي «غاية البيان» قال أبو الحسن: لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها، قال بشر: قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها، يعني البخارية والطبرية واليزيدية, وقال محمد: قيمتها في آخر نفاقها، قال القدوري: وإذا ثبت من قول أبي حنيفة من قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة، والطبرية واليزيدية هي التي غلب عليها الغش فتجري مجرى الفلوس، فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس. انتهى ما في «غاية البيان», وما ذكره في القرض جار في البيع أيضا كما قدمناه عن الذخيرة من قوله: «يوم وقع البيع… إلخ». ثم اعلم أن الذي فُهم من كلامهم أن الخلاف المذكور إنما هو في الفلوس والدراهم العالية الغش, ويدل عليه أنه في بعض العبارات اقتصر على ذكر الفلوس، وفي بعضها ذكر العَدَالِي معها – وهي كما في البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال وكسر اللام – دراهم فيها غش، وفي بعضها تقييد الدراهم بغالبَة الغش، وكذا تعليلهم قول الإمام ببطلان البيع بأن الثمنية بطلت بالكساد؛ لأن الدراهم التي غلب غشها إنما جُعلت ثمنا بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا، وبقي البيع بلا ثمن فبطل, ولم أر من صرح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش سوى ما أفاده الشارح هنا, وينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل البيع بكسادها، ويجب على المشتري مثلها في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء, أما عدم بطلان البيع فلأنها ثمنٌ خِلقة، فتركُ المعاملة بها لا يُبطل ثمنيتها، فلا يتأتى تعليل البطلان المذكور، وهو بقاء المبيع بلا ثمن، وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائةِ ذهبٍ مُشخَّص، أو مائةِ ريالٍ فِرَنجي فلبقاء ثمنيتها أيضا وعدم بُطلان تقوُّمِها، وتمام بيان ذلك في رسالتنا «تنبيه الرقود في أحكام النقود», وأما ما ذكره الشارح من أنه تجب قيمتها من الذهب فغير ظاهر؛ لأن مثليتها لم تبطل فكيف يُعدل إلى القيمة؟ وقوله «إذا لم يكن … إلخ» فيه نظر؛ لأن منع السلطان التعاملَ بها في المستقبل لا يستلزم منعَ الحاكم من الحُكم على شخص بما وجب عليه منها في الماضي, وأما قوله «ولا يدفع قيمتها من الجديدة» فظاهر، وبيانه أن كسادها عيبٌ فيها عادةً؛ لأن الفضة الخالصة إذا كانت مضروبة رائجة تُقَوَّم بأكثر من غيرها، فإذا كانت العشرةُ من الكاسدة تساوي تسعةً من الرائجة مثلا، فإن ألزمنا المشتري بقيمتها وهو تسعةٌ من الجديدة يلزم الربا، وإن ألزمنا المشتري بعشرةٍ نظرا إلى أن الجودة والرداءة في باب الربا غير معتبرة يلزمُ ضرر المشتري حيث ألزمناه بأحسن مما التزم، فلم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدة ولا بمثلها منها، فتعين إلزامه بقيمتها من الذهب؛ لعدم إمكان إلزامه بمثلها من الكاسدة أيضا لما علمت من منع الحكام منه، لكن علمت ما فيه, هذا ما ظهر لي في هذا المقام والله سبحانه وتعالى أعلم)([17]).
المالكية:
قال صاحب أقرب المسالك مع الشرح الصغير: (وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع، أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص «فالمثل»: أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة، «وإن عُدمت» في بلد المعاملة ــ وإن وجدت في غيرها ــ «فالقيمة» أي: تُعتبر يوم الحكم، بأن يدفع له قيمتها عرضا، أو يقوم العرض بعين من المتجددة)([18]). قال الصاوي: )«قوله: من قرض أو بيع»: ومثل ذلك ما لو كانت وَديعةً وتَصَرَّف فيها؛ أو دفعها لمن يعمل فيها قراضا, «قوله: أي فالواجب قضاء المثل» أي ولو كان مائةً بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس، وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو العكس وهكذا, قوله: « فالقيمة يوم الحكم» وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم الاستحقاق، والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم، وحينئذ فتُعتبر القيمة يوم طلبها, وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عُدمت تلك الفلوس، وبه قال بعضهم. وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مَطْل، وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة؛ أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة، وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله. قال الأجهوري: كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا، فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه)([19]).
وهذه المسألة هي في الحطَّاب عن المسائل الملقوطة: مسألة مَن عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته، ومكَّنه المطلوب مرارا، فأتى من جنى على الطعام، قال مالك: ليس له المكيلة، وإنما له قيمته يوم عَجَز عن أخذه، ولم يختلف في هذا من الإحكام بمسائل الأحكام([20]). ونقله الرهوني من المسائل الملقوطة فقال: «حتى غلا الطعام»([21]) بدل «فأتى من جنى الطعام» التي وردت في عبارة الحطاب، والظاهر أنه غلط مطبعي, وهو كثير جدا في النسخة المتداولة من الحطاب، وهذا الفرع في الجملة دليل على اعتبار تغير السعر وإيجاب القيمة بدلا من المثل. قال الحطاب عند قول خليل: «وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم»، يعني أن من أقرض فلوسا أو باع بها سلعة ثم بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها؛ فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت، فإن عُدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها؛ أي وجوبها وحلولها، وعدمها أي انقطاعها، ويحصل ذلك بالأخير منهما، فإن كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة إلا يوم العدم، وإن كان العدم أولا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق، وهذا كأقصى الأجلين في العدة([22]). قال الحطاب: قلت: في المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها. وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت ، وهو نحو ما أفتى به ابن رشد. أبو حفص: من لك عليه دراهم فقطعت فلم توجد فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم الحكم لو وجدت. وأجاب الصائغ عما إذا فسدت السِّكة وباعه بثمن إلى أجل وصارت غيرها، وصار الأمر إلى خلاف ما دخلا عليه فعليه قيمتها يوم دفعها إليه بهذه السكة الموجودة الآن، وقد اضطرب في هذا المتقدمون والمتأخرون، والأولى ما ذكرت لك، وقد وقع ذلك في ثمانية أبي زيد، وفي كتاب ابن سحنون: إذا أسقطت يتبعه بقيمة السلعة يوم قبضت؛ لأن الفلوس لا ثمن لها، ووجه ما في المدونة أنها جائحة نزلت به، وهذا قول ثالث غير ما حكى ابن رشد. وقال اللخمي في كتاب الرهون: لو كانت مائةُ فلس بدرهم ثم صارت ألفَ فلس بدرهم فلم توجد؛ كان له قيمتها يوم انقطعت إذا كان الدين حالا، وإن كان مؤجلا وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل الأول؛ لأن بالقيمة وقع التأخير، ولا ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت؛ إذ لم يتوجه الطلب حينئذ وإن أخر بعد الأجل؛ لأن بالقيمة وقع التأخير أجلا ثانيا، فالقيمة يوم حل الأجل الأول. وفي كتاب الرهون: القيمة يوم يحكم عليه، وعليه يأتي الكوالئ التي انقطعت سكتها من الديوان والصدقات([23])اهـ.
قلت: في الكلام الذي عزاه للصائغ؛ وهو عبد الله بن نافع؛ خطأ مطبعي، فينبغي أن يكون محل «إذا فسدت السكة» «إذا كسدت»لينسجم المعنى. أما قوله: «في ثمانية أبي زيد» فإنه يراد بها في مصطلح المالكية ثمانية كتب جمعها أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم من سماعه من أصحاب مالك بالمدينة أثناء رحلته إلى المشرق؛ وهو أندلسي([24]).
قال عبد الباقي عند قول خليل: «وإن بطلت فلوس» ترتبت لشخص على آخر أي قُطع التعامل بها بالكلية، وأولى تغيرها بزيادة أو نقص مع بقاء عينها «فالمثل» على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير، ولو كانت حين العقد مائةً بدرهم ثم صارت ألفا به كما في المدونة؛ أي: أو عكسه؛ لأنها من المثليات، أو «عُدمت» جملةً في بلد تعامل المتعاقدين وإن وجدت في غيرها «فالقيمة» واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها «وقت اجتماع الاستحقاق» أي الحلول «والعدم» معا، ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما، فأشبه وقت الإتلاف، فإذا استُحقت ثم عُدمت فالتقويم يوم العدم، وإن عُدمت ثم استُحقت فالقيمة يوم استُحقت كأقصى الأجلين في العدة, قاله (تت). ولو أخره أجلا ثانيا بعد عدمها وقد عُدمت عند الأجل الأول أو قبله لزمه قيمتها عند الأجل الأول؛ لأن التأخير الثاني إنما كان بالقيمة، ولو أخَّره بها بعد حلول أجلها وقبل عدمها ثم عُدمت أثناء أجل التأخير لزمه قيمتها عند حلول أجل التأخير، كما يفيده أبو الحسن, أي: لأن التأخير لم يكن للقيمة بل للمِثل وقد عُدم. ويفهم منه أنه إذا تأخر عدمها من الأجل الثاني أن قيمتها تُعتبر يوم عدمها. وهذا كله على مختار المصنف هنا تبعا لابن الحاجب تبعا للخمي وابن محرز, والذي اختاره ابن يونس وأبو حفص أن القيمة تُعتبر يوم الحكم، قال أبو الحسن: وهو الصواب. البرزلي: وهو ظاهر المدونة, فكان على المصنف أن يذكر القولين أو يقتصر على الثاني، وعليه فانظر إذا لم يقع تحاكمٌ هل يكون الحكم ما مشى عليه المصنف أو تعتبر قيمتها يوم حلولها إن كانت مؤجلة، ويوم طلبها إن كانت حالة، أو يقال طلبها بمنزلة التحاكم؟ وظاهر كلام المصنف كالمدونة سواء مَطَله بها أم لا، وقيدها الوانوغي، وأقره المشذالي و(غ) في التكميل بما إذا لم يكن من المدين مطل، وإلا وجب عليه لمطله ما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة كما هو ظاهر, ويدل عليه ما نقله (عج) عن السيوطي : لا الناقصة عنها ولا القيمة ؛ لأنه ظالم بمطله, فإن قلت: ما الفرق بين الظالم هنا وبين الغاصب الذي يضمن المثلي ولو بغلاء كما سيأتي للمصنف مع أنه أشد ظلما من المماطل أو مثله؟ قلت: أجيب بأن الغاصب لما كان يغرم الغلة في الجملة خُفف عنه، ولا كذلك المماطل، وبأن النهي هنا خاص وهو أقوى من النهي العام، على أنه قد وقع بكلامهم ما يدل على التخفيف على الغاصب ما لا يخفف على غيره ممن هو دونه في الظلم، فمن ذلك: البائع إذا أتلف ما باعه بالخيار للمشتري عمدا، فإنه يضمن الأكثر من قيمته وثمنه، مع أن ظلمه دون ظلم الغاصب؛ لأن ما أتلفه ملكه وفي ضمانه, ومنها: أن المستأجر والمستعير إذا حبسا الدابة حتى تغير سوقها فإن لربها أن يُضمنهما قيمتها، والغاصب لا ضمان عليه في تغيير السوق. تنبيه: قال (د): مثل الفلوس النقد، واقتصر عليها لأنها محل توهم؛ إذ يتوهم فيها لكونها كالعرض أن فيها قيمة كذا، قيل وهو غير ظاهر؛ لأن العرض ينقسم إلى مثلي ومُقوَّم، والمثلي يلزم فيه المثل، والمُقوَّم يلزم فيه القيمة. وانظر لو قضاه بما تجدد التعامل به هل يجوز أم لا لكونه صار سلفا بزيادة ؟ وقد أفتى بعض شيوخنا بالجواز، انظر شرح منظومة ابن عاصم([25]).
قال البناني في حاشيته: «أو عدمت فالقيمة» وتعتبر القيمة في بلد المعاملة وإن كان حين القبض في غيرها، ذكره (ح) عن البرزلي : وقول (ز) «وقيدها الوانوغي… إلخ»، هذا القيد قال في تكميل التقييد هو تقييد حسن غريب. قال صاحب تكميل المنهج: وهو ظاهر إذا آل الأمر إلى ما هو أرفع وأحسن، وأما إن آل إلى ما هو أقبح وأردأ ، فإنه يعطيه ما ترتبت في ذمته, والله أعلم اهـ. وبحث بدر الدين القرافي مع الوانوغي فقال: تقييد الوانوغي لم يذكره غيره من شراح المدونة وشراح ابن الحاجب، وللبحث فيه مجال ظاهر؛ لأن مطل المدين لا يوجب زيادة في الدين، وله طلبه عند الحاكم وأخذه منه، كيف وقد دخل عند المعاملة معه على أن يتقاضى حقه كما دفعه وأن يمطله، وعلى أن يفلس أو يموت مفلسا. قال: وبحث فيه أيضا بعضُ أصحابنا بأن غايته أن يكون كالغاصب، والغاصب لا يتجاوز معه ما غصب اهـ. قال بعضهم: إذا رأيت أن إطلاق المدونة عند الشيوخ يقوم مقام النص كما قال ابن عرفة في باب الشفعة؛ خصوصا وقد تابع الشيوخ بعضهم بعضا على قولها وأبقوه على ظاهره؛ ظهر ما قاله البدر القرافي وبعض أصحابه اهـ. وقد ذكر في نوازل الرهون من المعيار أن ابن لب سُئل عن النازلة نفسها فأجاب بأنه لا عبرة بالمماطلة، ولا فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم اهـ. وقول (ز) في «التنبيه»: وانظر لو قضاه بما تجدد… إلخ: الظاهر أن هذا جائز، وأنه من باب صرف ما في الذمة؛ لأن المعدومة إن كانت دراهم فقد ترتب في ذمته قيمتها ذهبا، وله أخذ الدراهم الجديدة عنها صرفا، وكذا عكسه، وأما قوله: «إنه سلف بزيادة» فغير صحيح، تأمله والله أعلم([26]).
وما أشار إليه الزرقاني وغيره من العزو للمدونة في مسألة نقص القيمة هو فيها، ونصها: قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت أسلفني دراهم بفلوس، والفلوس يومئذ مائةُ فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم قال: إنما يرد ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة([27]).
وهو أمر لا خلاف فيه في المذهب إلا تقييد الرهوني في حاشيته على الزرقاني لكلام ابن لب وغيره، حيث قال: وأما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا، وممن صرح بذلك أبو سعيد ابن لب, قلت: وينبغي أن يُقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه([28]).
وفي المعيار نقلا عن أبي حفص العطار: من لك عليه دراهم فقطعت ولم توجد، فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم الحكم لو وجدت, وحكى ابن يونس عن بعض القرويين: إذا أقرضه دراهم فلم يجدها في الموضع الذي هو به الآن أصلا فعليه قيمتها بموضع إقراضه إياها يوم الحكم، لا يوم كان دفعها إليه. وفي كتاب ابن سحنون: إذا أسقطت تتبعه بقيمة السلع يوم قبضت؛ لأن الفلوس لا ثمن لها([29]). وفيه في موضوع آخر: ما الحكم فيمن أقرض غيره مالا من سكة ألغي التعامل بها؟ وسئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقُطعت تلك السكة، فأجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر قيه أشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام؛ ومحمد بن عتاب حيٌّ ومن معه من الفقهاء، فانقطعت سكة ابن جهور لدخول ابن عباد بسكة أخرى، فأفتى الفقهاء بأنه ليس لصاحب الدَّين إلا السكة القديمة، وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب، ويأخذ صاحب الدَّين القيمة من الذهب، قال: وأرسل إليَّ ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة، وقال لي: الصواب فيها فتواي فاحكم بها ولا تخالفها؛ أو نحو هذا الكلام. وكان أبو محمد بن دحون $ يفتي بالقيمة يوم القرض، ويقول: إنما أعطاه على العوض فله العوض، فأخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن فرج عنه, وكان الفقيه أبو عمر بن عبد البر يفتي فيمن اكترى دارا أو حماما بدراهم موصوفةٍ جاريةٍ بين الناس حين العقد، ثم غيرت دراهم تلك البلد إلى أفضل منها؛ أنه يلزم المكتري النقد الثاني الجاري حين القضاء دون النقد الجاري حين العقد, وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونُقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة، وكانت حجته في ذلك أن السلطان منع من إجزائها وحرَّم التعامل بها، وهو خطأ من الفتوى. وأفتى أبو الوليد الباجي أنه لا يلزمه إلا السكة الجارية حين العقد([30]).
فتحصل للمالكية في مسألة إبطال العملة مع وجود عينها ثلاثة أقوال:
الأول: وهو مشهور المذهب والموافق للصحيح من مذهب الشافعي: أنه يقضي بالمثل من العملة المقطوعة بصرف النظر عن مقدار قيمتها.
القول الثاني: أنه إنما يلزمه قيمتها، وهو الذي عليه ابن عتاب وابن دحون، وهو مذهب الإمام أحمد.
القول الثالث: أن يكون للدائن مثل دينه من العملة الجديدة، وهو قول لأبي عمر بن عبد البر، وهو ضعيف.
قلت: القولان الأول والثاني مبنيان على خلاف في مذهب مالك حول قاعدة هي: ما الذي يلزم في فوات المضمونة سواء كان ذلك ناشئا عن بيع فاسد أو غصب هل هو التفصيل بين المثلي فيلزم فيه المثل؟ أو المتقوم فتلزم فيه القيمة؟ أو أنه لا فرق بين الاثنين بل تلزم القيمة مطلقا سواء كان مثليا أم متقوما موجودا أو مفقودا؟ وعلى الأول درج خليل في قوله في البيع المتفق على فساده: «وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي»([31]), ولكن عدل عنه في قوله بعد: «وبتغير ذات غير مثلي», وإليك نص البناني معلقا على كلام الزرقاني ومفصلا الطريقتين: «قول (ز) تبع المصنف اللخمي والمازري وابن بشير…إلخ»: طريقة هؤلاء الشيوخ غير الطريقة التي جرى عليها المصنف أولا في قوله «وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي»، قال (طفي): اعتمد المصنف هنا قوله في توضيحه الذي للخمي والمازري وابن بشير أن المثلي لا يفوت؛ لأن المثل يقوم مقام مثله اهـ. وهو غير ملتئم مع ما قدمه من قوله «ومثل المثلي»؛ لأن المثل هو المرتب على الفوات عنده، وتلك طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف، وأصلها لابن يونس وعزاها لابن القاسم في غير المدونة، فهما طريقتان, إحداهما لابن يونس ومن تبعه أن اللازم في الفوات القيمةُ في المقوَّم والمثلُ في المثلي إلا إن عُدم كثَمر في غير إبانه فقيمته، والثانية لابن رشد وابن بشير واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو القيمة مطلقا في المقوم والمثلي, وهذه الطريقة هي التي انتحاها ابن عرفة وغيره من المتأخرين، وعليها يأتي التفريع والخلاف في حوالة الأسواق والنقل والتغير هل تفيت المثل أم لا؟ فمن أوجب فيه المثل وهو المشهور قال بعدم الفوات فيه، ومن أوجب فيه القيمة قال بالفوات, وأما رده متغيرا مع أرش النقص كما توهم (عج) فلا قائل به، انظر (طفى): وفاتت بهما([32]).
الشافعية:
وأما الشافعية فإنهم كالمالكية في رد المثل في النقد ولو كان فلوسا إذا أبطل السلطان التعامل بها، قال الشافعي في الأم: من سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها([33]). وقال في نهاية المحتاج: «ويرد» حتما حيث لا استبدال «المثل في المثلي» لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطلت المعاملة به، فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد، ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا([34]). وعدم تأثير الرخص والغلاء في رد المثل هو مذهب الشافعي.
يقول السيوطي في الحاوي: تترتب الفلوس في الذمة بأمور منها القرض، وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقا، فإذا اقترض منه رطلَ فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس، سواء زادت قيمته أم نقصت. ونقل كلام الروضة: ولو أقرضه نقدا فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه، نص عليه الشافعي ﭬ، فإذا كان هذا مع إبطاله فمع نقص قيمته من باب أولى. وقال عن السلم: ومنها السلم، والأصح جوازه في الدراهم والدنانير والفلوس بشرطه، ومعلوم أنه لا يتصور فيه قسم العدد لاشتراط الوزن فيه، فإذا حل الأجل لزمه القدر الذي أسلم فيه وزنا، سواء زادت قيمته عما كانت وقت تسليمه السلم أم نقصت([35]).
قال السيوطي في الحاوي: فصل : ومنها ثمن ما بيع به في الذمة، قال في الروضة وأصلها لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان ذلك النقد، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد، كما لو أسلم في حنطة فرخصت فليس له غيرها، وفيه وجه شاذ ضعيف أنه مخير إن شاء أجاز العقد بذلك النقد، وإن شاء فسخه، كما لو تعيب قبل القبض اهـ.
فأقول هنا صور:
إحداها: أن يبيع برطل فلوس، فهذا ليس له إلا رطلٌ زاد سعره أم نقص، سواء كان عند البيع وزنا فجعل عددا أم عكسه، وكذا لو باع بأوقية فضة أو عشرة أنصاف وهي خمسة دراهم أو دنانير ذهب، ثم تغير السعر، فليس له إلا الوزن الذي سُمي.
الثانية: أن يبيع بألف فلوسا أو فضة أو ذهبا ثم يتغير السعر، فظاهر عبارة الروضة المذكورة أنه له ما يسمى ألفا عند البيع ولا عبرة بما طرأ، ويحتمل أن له ما يسمى ألفا عند المطالبة، وتكون عبارة الروضة محمولة على الجنس لا على القدر، وهذا الاحتمال وإن كان أوجهَ من حيث المعنى إلا أنه لا يتأتى في صورة الإبطال؛ إذ لا قيمة حينئذ إلا عند العقد لا عند المطالبة، ويرده أيضا التشبيه بمسألة الحنطة إذا رخصت([36]).
الحنابلة:
أما الحنابلة فقال في المغني: فقد ذكرنا أن من استقرض يرد المثل في المثليات؛ سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله… إلى قوله: وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها سواء كانت قائمة في يده أم استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه، نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا. قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزم أخذها. وقال مالك والليث بن سعد والشافعي: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب حدث فيها فتجري مجرى نقص سعرها. ولنا أن تحريم السلطان لها منع نفاقها وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها أو تلف أجزائها, وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل إن كانت عشرةً بدانق فصارت عشرين بدانق أو قليلا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت([37]).
وقال قبل ذلك: (فصل): ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من سلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك([38]). ومثله في «كشاف القناع», قال البهوتي: وإذا كان القرض مثليا ورده المقترض بعينه لزم المُقرض أخذُه ولو تغير سعره ولو بنقص ما لم يتعيب، كحنطة ابتلت أو عفنت فلا يلزمه قبولها لأن عليه فيه ضررا لأنه دون حقه، أو يكون القرض فلوسا أو يكون دراهم مكسرة فيُحرمها؛ أي يمنع الناس من المعاملة بها (السلطان) أو نائبه، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا؛ لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، (فله) أي: المقرض (القيمة) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال «وقت القرض» سواء كانت باقية أم استهلكها، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا ، والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك([39]).
وللحنابلة قول ضعيف ذكره في المبدع على المقنع، حيث قال: وقيل إن رخصت -الفلوس- فله القيمة([40]).
وللشافعية قول مفيد في الجملة أنه في حالة الرخص ينظر إلى القيمة، ذكر ذلك السيوطي في نقل طويل، نقتبس منه الفقرات التالية: (الثالثة: أن يبيعه بعدد من الفضة أو من الفلوس كعشرة أنصاف؛ أو مائةِ فلس في الذمة وهي مجهولة الوزن فهذا البيع فاسد, والمقبوض به يُرجع بقيمته فيما أطلقه الشيخان لا بما بيع به وليس من غرضنا, وإن قلنا يُرجع في المثلي منه بالمثل كما صححه الإسنوي فكان المبيع فلوسا فالحكم فيه كالمغصوب، وسيأتي).
الفقرة الثانية: (ومنها بدل الغصب بأن غصب فلوسا أو فضة أو ذهبا ثم تغير سعرها، فإن تغير إلى نقْصٍ لزمه ردُّ مثل ما يُساوي المغصوب في القيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى التلف، أو إلى زيادة لزمه ردُّ المثل وزنا والزيادة للمالك، فإن كان المغصوب عدديا فالقول قول الغاصب في قدْرِ وزنه لأنه غارم).
الفقرة الثالثة: )إذا شرط الواقف لأرباب الوظائف معلوما من أحد الأصناف الثلاثة ثم تغير سعرها عما كان حال الوقف فله حالان, الأول: أن يُعلَّق ذلك بالوزن بأن يشترط مثقالا من الذهب أو عشرةَ دراهم من الفضة أو رطلان من الفلوس، فالمستَحَقُّ الوزن الذي شرطه زاد سعره أم نقص, الثاني: أن يعلقه بغيره كثلاثِمائةٍ مثلا، ويكون هذا القدر قيمةَ الدينار يومئذ؛ أو قيمةَ اثنَي عشر درهما ونصفا؛ أو قيمةَ عشرة أرطال من الفلوس، فالعبرة بما قيمته ذلك، فلو زاد سعر الدينار فصار بأربعمائة فله في الحال الأول دينار، وفي الثاني ثلاثة أرباع الدينار, ولو نقص فصار بمائتين فله في الحال الأول دينار، وفي الثاني دينارٌ ونصف, وكذا لو زادت قيمةُ دراهم الفضة أو نقصت؛ أو قيمة أرطال الفلوس، فالمستحَقُّ ما يساوي ثلاثَمائة في الحال الثاني، وما هو الوزن المقرر في الحال الأول).
الفقرة الرابعة: -وقال قبل ذلك في فقرة أخرى تعليقا على رسالة البلقيني في الفلوس التي عزت: إن المدين يؤدي قيمتها يوم الوجوب أو يوم الإعواز- :(واعلم أنه نحا في جوابه إلى اعتبار قيمة الفلوس، وذلك لأنها عدمت أو عزت فلم تحصل إلا بزيادة، والمثلي إذا عدم أو عز فلم يحصل إلا بزيادة لم يجب تحصيله كما صححه النووي في الغصب، بل يرجع إلى قيمته، وإنما نبهت على هذا لئلا يُظن أن الفلوس من المتقومات، وإنما هي من المثليات في الأصح)([41]).
إن هذه النقول تدل على أن الشافعية في الجملة قد التفتوا في بعض الحالات إلى إيجاب القيمة في حالة الرخص وتغيير السعر، كمسألة الوقف المذكورة آنفا، ففيها نوع من الربط بالسعر، وأما مسألة الغصب والبيع الفاسد فقد يقال إنه من باب الحمل على الظالم، ولكن الحمل على الظالم لا يجيز الزيادة عليه في القيمة لو لم يكن لذلك أصل، كما أن إيجاب القيمة إذا عزت الفلوس دليل واضح بطريق «قياس العكس»، إنها إذا رخصت تؤدى قيمتها.
وهو عند المالكية أيضا في المماطلة في مسألة المسائل الملقوطة، وهي كما قدمنا: من تأخر عن أخذ مكيلة قمح يطالب بها شخصا حتى غلا الطعام فليس له إلا قيمتها؛ وذلك حتى لا يتضرر المدين. وهذه تخرج عليها حتى مع نص الإمام في الفلوس ما يخالفها.
ومن هنا تنشأ طريقان في الضياء اللامع: فإنه إذا فرض للمجتهد قول في المسألة وله في نظيرها ما يخالف ذلك ولم يظهر بينهما فرق كان ذلك بمنزلة القولين، وكانت فتواه الأخيرة رجوعا عما أفتى به في نظيرتها([42]). وقال في مراقي السعود:
| وتنشأ الطرق من نصين | تعارضا في متشابهين([43]) |
وقال في مختصر الروضة: قوله « ولو نص » يعني المجتهد « في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما، وأولى » أي كما أنه إذا نص على حكم في مسألة وسكت عن مسألة أخرى تشبهها فلم ينص على حكم فيها فلم يجز أن ينقل حكم المنصوص عليها إلى المسكوت عنها، كذلك إذا نص على المسألتين بحكمين مختلفين لم يجز أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ويخرجه قولا له فيها، فيصير له فيها قولان، بل هذا أولى بالمنع؛ لأنه إذا لم يجز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه الذي لم ينص عليه بنفي ولا إثبات، فأولى أن لا ينقله إلى منصوص عليه بنقيض الحكم, لأنا في الأول نكون قد قولناه ما لم يقله، مع أنه لو قال في المسألة المسكوت عنها لجاز أن يقول كما قولناه فيها، وفي الثانية قولناه نقيض ما قال، فلا يتصور موافقته لنا فيها الآن بحال. قوله: «والأولى جواز ذلك »، أي جواز نقل حكم إحدى المسألتين المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى، إذا كان ذلك «بعد البحث والجد» فيه «من أهله» أي من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر، وعرف مدارك الأحكام ومآخذها, لأن «خفاء الفرق» بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم « مع ذلك » أي مع أهلية النظر «ممتنع» في العادة « وإن دق » يعني ذلك الفرق. قلت: وقياس هذا جواز ذلك في نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه إذا عُدم الفرق المؤثر بينهما بعد النظر البالغ من أهله؛ لأن عدم ظهور الفرق ـ والحالة هذه ـ ممتنع في العادة.
ومثل الشارح لذلك بما وقع في المذهب عن المحرر في باب ستر العورة «ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه، ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان», وذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط في الصلاة, وهذا وجه الشبه بين المسألتين([44]).
هنا وجه الشبه أن مالكا نص في مسألة مكيلة القمح في الغلاء بالرجوع للقيمة، فهذه نظيرتها في الرخص، كما أن قول ابن عتاب وابن دحون في وجوب قيمة السكة التي بطل التعامل بها، وإن كانت ذهبا ، فهو دليل على اعتبار الرخص, والشافعية في كلام الحاوي: اعتبار غلاء الفلوس، فيعتبر الرخص كذلك، والأمر راجع إلى رفع الضرر عن الدائن والمدين، وليس أحدهما بأولى بالمراعاة من الآخر, أما الحنابلة فقد قدمنا أن تغير السعر عندهم غير مؤثر، هذا أصل المذهب، سوى ما ذكر في المبدع وقد قدمناه، وقد نُسب لشيخ الإسلام ابن تيمية في أجوبة الشيخ عبد الله أبي بطين القول بأن التغير بالنقص موجب للرجوع بالقيمة في المثليات([45]), ومرد ذلك إلى أن المثلية لا تتحقق إلا بالقيمة، وقد أشار في الفتاوى إلى أن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل ـ راجع ملحق الأعواض ـ.
وبالجملة فإن الاختلاف في رد غير المكيل والموزون بالمثل أو القيمة له علاقة باختلافهم في رد القيمة أو المثل في الفلوس، وبخاصة إذا كانت تباع عددا، فإن الذي يرد في القرض بمثله إنما هو المكيل والموزون، فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان:
أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له، فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والغصب.
والثاني: يجب رد مثله لأن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فرد مثله.
ويخالف الإتلاف فإنه لا مسامحة فيه فوجبت القيمة لأنه أحصر والقرض أسهل, ولهذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا، ويعتبر مثل صفاته تقريبا، فحقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون، فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل, لأن القيمة ثبتت في ذمته يومئذ, وإذا قلت: تجب القيمة وجبت حين القرض؛ لأنها حينئذ ثبتت في ذمته([46]).
وأما الأحناف فجمهورهم على أن الرخص غير مؤثر، إلا أن المنقول عن أبي يوسف أن ذلك مؤثر مؤدٍ إلى وجوب القيمة كما أسلفنا عن ابن عابدين, ومذهب أبي يوسف في هذا واضح.
إن اختلاف العلماء في هذه المسألة وترددهم بين القيمة والمثل في مسألة الكساد قد يدل على اختلاف نظرتهم للفلوس كنقود مساعدة، وترددها بين العروض والنقود، ولكنه قد يكون خلافا في حال، فقد تكلم كل إمام حسب الحال التي شاهدها, فأبو حنيفة عندما قال «يفسخ البيع في الفلوس الكاسدة» إنما نظر إلى أن قيمتها في نفسها ضعيفة جدا؛ بحيث عرى العقد عن عوض أو كاد, ومالك لما قال «بوجوب المثل» كان يرى أن لها قيمة في نفسها، وهكذا نقول عن بقية الأئمة.
ولكن من اصطلى بنار تقلباتها ينقل صورة للفلوس قبيحة، فهذا ابن حجر يقول في سنة 833هـ: نودي على الفلوس أن يباع الرطل النقي فيها بثمانية عشر درهما، ورسم للشهود ألا يكتبوا وثيقة في معاملة أو غيرها إلا بأحد النقدين بسبب شدة اختلاف أحوال الناس؛ واختلاف أحوال الفلوس التي صارت هي النقد في عرفهم([47]).
قلت: هذه عملية ربط للعملة بالذهب والفضة مع وجود عملة فلسية.
ويذمها المقريزي قائلا: الفلوس لم يجعلها الله تعالى قط نقدا في قديم الدهر وحديثه إلى أن راجت في أيام أقبح الملوك سيرة وأرذلهم سريرة «الناصر البرقوقي»، وقد علم كل من رُزق فهما وعلما أنه حدث من رواجها خراب الأقاليم وذهاب نعمة أهل مصر([48]). راجع ملحق النقود في بحثنا ترى في تطورها وحيرة بعض العلماء في الفلوس عبرة لأولي الألباب.
ومما يدل على أن الفلوس كانت لها قيمة حتى ولو كانت باطلة قول ابن قدامة الذي قدمنا (سواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا).
تأصيل الموضوع:
قد تحصَّل من أقوال العلماء في مسألة رخص العملة – الفلوس – المعبر عنه بالتضخم:
- إلغاء الرخص ما دامت الفلوس رائجة يتعامل بها مهما بلغت, وهذا أصل المذاهب الأربعة, اعتباره مطلقا وإيجاب القيمة التي كانت عليها عند العقد «القرض أو السلم أو البيع أو أي حق من الحقوق، كالجناية والغصب أو عقد الإجارة والكراء», وهذا القول لا يخلو مذهب من الإشارة إليه، وقد وُفق هذا البحث بفضله تعالى إلى التقاط الإشارات في كل المذاهب إليه.
- اعتبار الفاحش فقط، وهذا ما عبر عنه الرهوني بـ «ينبغي»، ولا يمكن أن يعتبر ذلك حكاية لقول مالك في المسألة، إلا أنه لو أدى إليه اجتهاد مجتهد ما ألام ؛ لأنه أحروي بالنسبة لمن يقول بلزوم القيمة في النقص مطلقا، وهذا من باب فحوى الخطاب. وكلام الرهوني وإن كان لا تتوفر فيه شروط القول المعزو إلى المذهب، إلا أن بعض كلام أهل المذهب ممن تتوفر فيهم أهلية الفتوى يشير إلى هذا المعنى، فكلام ابن دحون الذي نقلناه في إيجاب القيمة حيث قال: «إنما أعطاها على العوض، وهو في السكة التي أبطلها السلطان»، ولم يفرق بين ذهبية أو فلسية، ومن الواضح أنها إذا كانت ذهبية فإنما يعوض عن رخص، وإذا كان «الأصل في العقود أنها إذا تمت تكون الالتزامات قد حددت وتقررت في شكل نهائي»، والثمن والمثمن قد عرف معرفة لا تدع مجالا للجهالة والغرر, فكيف يتأتى أن يلزم المدين ببذل زيادة على الثمن الذي اتفق عليه في البيع وغيره من العقود ذات الأعواض الآجلة ككوالئ الصدقات؟ أم كيف يُطلب من المقترض أن يدفع أكثر من القرض الذي استلفه؟ وعلى أي أصل يُبنى ذلك؟ وما هو المقدار الذي إذا بلغ إليه النقص تُلزمونه بذلك؟ وهل يصح أن يتم ذلك في شكل شرط مسبق كذلك الذي يسمى بالربط؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة تحدد حتما مسار هذه المسألة وتقرر مصيرها، إلا أنه قبل ذلك يجب أن نقرر أنها مسألة اجتهادية بواسطة الجواب على التساؤل التالي:
أولا: هذه المسألة هل هي منصوصة أم اجتهادية؟
إن هذه المسألة وهي «قضاء ما ترتب في الذمة من غير النقدين عند انخفاض قيمته بما يساوي قيمته» ليست منصوصة للشارع لا بنفي ولا بإثبات إلا من خلال بعض العمومات أو القياس, ولهذا فهي مسألة اجتهادية, فمن العموم: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ (الرحمن: 9)، ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(النحل: 90)، ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ (هود: 85)، ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ(الأنعام: 152), ولكن السؤال: كيف يكون العدل والقسط في مثل هذه القضية؟ هل يكون بالقضاء عددا مع نقص القيمة أم بإيفاء القيمة من غير نظر إلى العدد من ذهب أو من عروض أخرى؟ فكما يقدم الوزن على العدد عند بعض العلماء كما قال شيخ الإسلام: «والشارع طلب إلغاء الصفة في الأثمان، فأراد أن تُباع الدراهم بمثل وزنها، ولا يُنظر إلى اختلاف الصفات مع خفة وزن كل درهم، كما يفعله من يطلب دراهم خفافا إما ليعطيها للظلمة، وإما ليقضي بها، وإما لغير ذلك، فيبدل أقل منها عددا وهو مثلها وزنا، فيريد المربي أن لا يعطيه ذلك إلا بزيادة في الوزن، فهذا إخراج للأثمان عن مقصودها، وهذا مما حرمه النبي ﷺ بلا ريب»([49]).
من هذا الكلام ندرك أن وصف العدد هو وصف طردي لا ينبني عليه حكم إزاء وصف الوزن المعتبر, فالسؤال هو: هل وصف العدد طردي إزاء وصف القيمة الفعلية والسعر القائم في أداء الحقوق؟ وفي المذهب المالكي خلاف في أيهما المعتبر من العدد أو الوزن كما سيأتي, على أن الشارع وضع الميزان والمكيال لضبط التماثل فيما يباع تماثلا, ولضبط المقادير في الأجناس المختلفة، وحث على قيمة العدل فيما ليس من هذا القبيل، وقد قالوا عن أحمد بن حنبل $ إنه لم يجوز السلم في الفلوس عددا لاختلافها خفة وثقلا كما سيأتي.
إن النصوص الشرعية إنما تحدثت عن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فأناطت بها الأحكام من زكاة وديات وتبادل, ولهذا احتيج إلى تحديد مقاديرها كما سيأتي, أما غيرها فهو محل اجتهاد بين قائس ومانع للقياس وبين متوقف، وسيأتي كلام الموفق في الفلوس: «هذه مسألة فروعية اجتهادية لا حرج على المجتهد فيها إذا كان من أهل ذلك, وليس ينبغي أن ينكر على مجتهد اجتهاده، وإنما يتباحث الفقهاء ليعرف الصواب», سترى كل ذلك في ملحق النقود والأعواض, ولهذا فسنجتهد في استنباط حكم هذه المسألة من خلال الرد على الأسئلة التي طرحناها فنقول:
إننا عندما نقرر أن على المدين أن يدفع زيادة لوجود تضخم فاحش فإننا لا نرى أنه دفع زيادة؛ لأننا نعتبر القيمة معيارا كمعيار الكيل والوزن والعدد المعتمد – كما هو مفصل في ملحق الأعواض والمعايير- وحينئذ فإن الزيادة إنما هي صورية لكون الثمن قد تعيب، فالذي يدفع يكون بمنزلة أرض العيب، وهو شبيه بـ«ضمان الدرك», وهو جائز على غير قياس([50]).
أما الأساس الذي يبنى عليه فإنه يبنى على أصلين:
أولها: أصل عام، وهو المنع من أكل أموال الناس بالباطل، وإنزال الضرر بالغير, قال تعالى: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (البقرة: 188) , وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار), أخرجه مالك $ في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ﭫ, وهذا الحديث يعتبر قاعدة كثير من أبواب الفقه، من ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط، والتغرير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة لأنها شُرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف([51]).
الثاني: الأصل الخاص ، فهو الجائحة. قال القرافي: النظر الثالث في وضع الجوائح. فما هي الجائحة ؟
الجائحة من الجَوْح، قال صاحب الصحاح: الجوح بسكون الواو الاستئصال، جحت الشيء أجوحه، والجائحة: هي الشدة التي تجتاح المال من فتنة أو غيرها, ويقال جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى، وكذلك جاحه الله تعالى وأجاحه، واجتاحه إذا أهلكه بالجائحة, وفيه فصول في حقيقتها وقدرها ومحلها.
الفصل الأول: في حقيقتها المرادة في الثمار، ففي (الجواهر) قال ابن القاسم: هي ما لا يُستطاع دفعه إن علم به، فلا يكون السارق جائحة على هذا، وجعله في (الكتاب) جائحة. وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي، فلا يكون الجيش جائحة، وفي (الكتاب): جائحة([52]). وراعى أشهب ثلث قيمة النبات في الجائحة، وليس ثلث عين الثمرة «لأن القيمة هي المالية التي تتعلق بها الأغراض»، والمشهور خلافه([53]). قال ابن قدامة: (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة, الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة؛ منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري, ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح, وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : (إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟)، رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: (من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟), وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. قال الشافعي: (لم يثبت عندي أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده, ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير). قلنا: الحديث ثابت رواه الأئمة, منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ﭬ, ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغيرهم)([54]).
الفصل الثالث: أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه، قال أحمد: )إني لا أقول في عشر ثمرات، ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت جائحة تعرف الثلث أو الربع أو الخمس توضع), وفيه رواية أخرى: (أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري), وهو مذهب مالك والشافعي في القديم, لأنه لا بد أن يأكل الطير منها، وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط واحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة، والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة, ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة, بدليل قول النبي ﷺ في الوصية: (الثلث والثلث كثير)، فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به, ووجه الأول عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح, وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه, ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها، فكان ما تلف منها من مال البائع وإن كان قليلا كالتي على وجه الأرض، وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة فكأنه مشروط, إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن, وأما على الرواية الأخرى فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل ثلث القيمة، فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن، وإذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما تلف فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولأنه غارم، والقول في الأصل قول الغارم([55]).
قال المواق : (التونسي: انظر لو مات دودُ الحرير الذي لا يُرادُ ورقُ التوت إلا لأكله؛ هل مشتريه كمُكتَرٍ حمَّاماً أو فندقا خلا بلدُه فلا يجدُ من يعمُرُه فيكون له متكلَّم أو لا يشبهه؟ لأن منافع الرَّبْع في ضمان مُكرِيه؛ وورقَ التوت سلعةٌ تُضمن بالعقد، كمن اشترى علفا لقافلة تأتيه فعدَلَت عن محله؛ أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث يُباع وورقُ التوت لا ينقل؟ الصقلي: وكذا لو اشترى قومٌ ثمارَ بلدةٍ وانجلى أهلُها عنها لفتنة أو لأجل حربٍ كان ذلك جائحة. انتهى نص ابن عرفة.
ونصُّ ابن يونس: ورقُ التوت الذي يباع فيُجمع أخضرَ لعلفِ دودِ الحرير، قال ابن القاسم: إنه كالبَقْل يُوضع فيه ما قل منه أو كثُر، وانظر لو مات دود الحرير أو أكثرُه وهذا الورق لا يُراد إلا له؛ هل موت دود الحرير جائحة؟ فالأشبه أن يكون ذلك كالجائحة، كمن اكترى حمَّاما أو فندقا فخلا البلدُ فلم يجدْ من يسكنُه. ابن يونس: وكذا عندي لو اشترى قومٌ ثمارَ بلدٍ فانجلى أهلُه لفتنة أو غيرها؛ أن جائحةَ ذلك من بائعِه؛ لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه، فإذا لم يجدْه هلكت الثمرة، فذلك كهلاكها بأمرٍ غالِب. انتهى. انظر قوله «لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه كذا هو » يعني أيضا في الورق، قال: إنما اشترى الورقَ يقبضُه شيئا فشيئا فيبيعُه لمن ينتفع به، فجعله كالحمَّام والفندق, وقال: إنما اشترى منافعَ يقبضُها شيئا فشيئا ويبيعُها لمن ينتفع بها. ونقل أيضا أنه كذلك من اكتَرى رحىً سنةً فأصاب أهلَ ذلك المكان فتنةٌ جلَوا بها من منازلهم؛ وجلا معهم المُكتري أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعامٌ لجلاء الناس، فهو كبطلان الرَّحا من نقصان الماء أو كثرته، ويوضع عنه قدْرُ المدة التي جلوا فيها، وكذلك الفنادق التي تُكرى لأيامِ الموسم إذا أخطَأَها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها، بخلاف الدار تُكتَرى ثم يُجلى أهلُ ذلك المكان لفتنة وأقام المكتري آمناً أو رحل للوَحْشة وهو آمن, فإن هذا يلزمه الكِراء كله، ولو انجلى للخوف سقط عنه مدةَ الجلاء. انتهى.
وخرَّج المازري على خُلوِّ البلد مسألةً سُئل عنها؛ وهي: رجلٌ اكترى موضعا لغَسل الغَزْل بكِراءٍ غالٍ ثم أحدث رجلٌ بقربه موضعا آخر فنقص من كِراء الأول كثيرٌ, فأجاب: أنه إن عَقَد على أنه لا يمكن إحداثُه فجاء مِن ذلك ما لم يَظُن فله مقالٌ كما يكون له إذا خلا البلدُ أو غيرُه مما ذكره العلماء, وأما إن كان من الممكن الإحداثُ فلا مقالَ له؛ إذ نقصان الغَلَّة لإحداث فُرن على فرن ليس بعيب. وأفتى ابن رشد: إن رأى القاضي أن يضع شيئا للاسْتِئلافِ لمكتري الحبس فلا بأس به، كالوكيل المفوَّضِ إليه يحُطُّ بعضَ الثمن على هذا الوجه, وانظر أيضا الوكيلُ يبيعُ بالخِيار فيُزاد، قال في رسْم طلق من كتاب البضائع: رب رجلٍ لو زاده لم يبعْه يُكره مخالطتُه وخصومتُه، ويأمن من ناحية الذي زيد عليه وإن كان أقلَّ عطية. ونقل البرزلي عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه إذا أُجيحت دودُ الحرير فلم يجد مشتري الورقِ من يشتريها منه فإن ذلك جائحة، فإن وجدَ مشترياً منه بثمن يسير فلا يوضع عنه شيء)([56]).
إن هذا النقل يوسِّع دائرة الجائحة لتشمل الحوادث الطارئة التي قد تُلحق خسارة بأحد الطرفين ولو كانت غيرَ الثمار محل النص، فموت دود الحرير يسمح لمشتري التوت بالرجوع على البائع, ومكتري الحمَّام والفندق فيخلو البلدُ فلا يجد من يسكنه, والفنادق أيام المواسم فلم ينزل فيها الزبائن لفتنة أو غيرها, والمغسلة يكتريها فيزاحمه من يقيم مغسلة بقربه فينقص ذلك من عائد المغسلة إذا لم يكن ذلك متوقعا, كل هذه اعتُبرت جوائح، ومعنى ذلك أن الجوائح مفهوم فقهي مرن, ومرادنا من هذا النقل بيان حقيقة الجائحة وحكمها لقياس تدهور سعر العملة عليه؛ إذ ذلك في محل علة النص، فقول النبي ﷺ في الحديث المتقدم: )لِمَ تأخذ مالَ أخيك بغير حق؟( يدل على أن العلة في وضع الجائحة هو أخذ المال بغير حق، وهو إيماء إلى العلة كما قرر علماء الأصول، ومثَّلوا له بقول النبي ﷺ : )أرأيت لو تمضمضت؟) جواباً لعمر([57])، وذلك هو الوصف الجامع.
وهنالك أوجه شبه أخرى بين مسألتنا ومسألة الجائحة:
أولا: أن الجائحة وقعت بعد تمام البيع والقبض ونقد الثمن، بحيث لم يعُد بين المتعاقدين شيء، ومع ذلك حكم برجوع المشتري على البائع.
ثانيا: أن التضخم يشارك الجائحةَ في كون كل منهما فيه تمتّعُ طرف بأفضل مما بذل ووجودُ طرف متضرر، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بـ «أنه أخذ المال بغير حق» أي بغير مقابل.
ثالثا: أن هذا الوضع يشترك مع الجائحة بأنه لا يمكن دفعه إن علم, وهذا تعريف ابن القاسم للجائحة ـ كما مر ـ ، وقد رأيت كيف توسع العلماء في مفهوم الجائحة ـ تُراجع التفاصيل المتعلقة بالجائحة في الملحق المتعلق بتطبيق مبدأ الجوائح على حالة تغير قيمة النقود ـ.
رابعا: إذا قلنا بثبوت اللغة بالقياس، وقد قال بذلك القاضي أبو بكر ابن سريج وجماعة من الفقهاء، وقال به من أهل اللغة ابن جني في المصنف وغيره، فهذه جائحة ـ تقدم كلام الصحاح: الشدة تجتاح المال من فتنة أو غيرها ـ قال في مراقي السعود:
| وجاز بالمشتق دون اللقب | وإن يكن من صفة فقد أبي |
يعني أنه يجوز التعليل بالاسم المشتق من الفعل عند الأكثر، والمراد الفعل اللغوي([58]).
وإن لم يكن لنا الاجتهاد بالقياس فنحن نُخرج على مذهب أحمد ومالك، والتخريج هو «القول في مسألة لا نص فيها للإمام بمثل قوله في مسألة تساويها», فـ«إذا نص المجتهد على حكم في مسألةٍ لعلة بيَّنها فمذهبه في كل مسألة وُجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها»([59]).
يقول في مراقي السعود:
| إن لم يكن لنحو مالك ألف | قول بذي وفي نظيرها عرف | |
| فذلك القول هو المخرج | وقيل في الأخذ عليه حرج([60]) |
ويمكن اعتبار هذه المسألة من جنس المصالح المرسلة التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.
| والوصف حيث الاعتبار يجهل | فهو الاستصلاح قل والمرسل([61]) |
وهذا على مذهب مالك، وحيث إنها تخدم مقصدا شرعيا ضروريا وهو المحافظة على الأموال، فشروط الاستصلاح قائمة فيها دون مراعاة للجائحة ولا لغيرها, فالمصلحة جلب نفع أو دفع ضر، ثم إن شهدَ الشرع باعتبارها لاقتباسِ الحكم من معقولِ دليلٍ شرعي فقياسٌ, ولكن ما هو المقدار الذي إذا وصل إليه نقص العملة تلزمون بالتراجع بين الدائن والمدين؟
إن التقدير هو أمر اجتهادي حتى ولو كان في المماثلة في القضايا التعبدية, يقول الله سبحانه وتعالى في جزاء الصَّيد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ (المائدة: 95), وكذلك في تقدير أحوال الناس من فقر وحاجة وغنى وكفاية، فقد رد النبي ﷺ حالة السائل الذي تجوز له المسألة إلى تقدير ثلاثة في حديث قبيصة الذي يرويه مسلم: (إن المسألة لا تحل إلا لأحدِ ثلاثةٍ, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش – أو قال سدادا من عيش – , ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ..) ([62]).
وقد قدر الفقهاء في مسائل، وامتنع بعضهم عن التقدير فيها راداً الأمرَ إلى العُرف والعادة والاجتهاد والنظر، فمن هذه المسائل مسألة الغبن، والجائحة، وغلث الحب، وكذلك في بعض مسائل العبادات، كخرق الخف، ونقص ذَنَب الأضحية وأذنها, أما التقدير فقد يكون بالثلث، وهو يدخل – كما قال الإمام أحمد – في سبع عشرة مسألة, وعدَّد المالكية مسائل كثيرة الثلثُ فيها يسير؛ وأخرى الثلثُ فيها كثير، فهو كثير في المعاقلة وفي الجائحة وفي الخف وما تحمله العاقلة، وهو يسير في الوصايا والحب الغلث وتبرع الزوجة وغيرها. «راجع الملحق الخاص بنسبة التضخم المعتبرة في الديون».
وهذا التقدير يمكن أن يُحكم به كما يمكن أن يكون أساسا للصلح الذي نص عليه ابن عابدين في هذه المسألة، والدعوة إلى الصلح تعتمد على الاشتباه أو الشبهة, فالاشتباه ناشيء عن كون كل من الطرفين متضررا بالتضخم, فانخفاض قيمة العملة يضر الدائن؛ لأنه يأخذ بدلا عن دينه قيما ناقصة، والمدينَ؛ لأن موجوداته النقدية أصيبت بانخفاض ضعفت به قدرته الشرائية، فالأمر يحتاج إلى تقدير كل من الضررين, مما يستدعي تدخل القاضي لتقدير الحقوق، ولحث الطرفين على التراضي والتسامح لأن الأمر مشتبه, وهو أيضا شبهة, والشبهة لها أسباب، منها كون النص خفيا، وورود نصين متعارضين، ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا([63]).
ومعلوم أن موضوعنا لا يوجد به نص خفي أو ظاهر، فضلا عن وجود نصين متعارضين، فهو على أحسن تقدير من النوع الثالث الذي يؤخذ من القياس، فهو إذا شبهة، وقد قال الإمام أحمد عن الشبهة « بأنها منزلة بين الحلال والحرام»([64]), والاشتباه والإشكال مدعاة لطلب القاضي الصلح، قال ابن عاصم الغرناطي:
| والصلح يستدعي له إن أشكلا | حكمٌ وإن تعيَّن الحق فلا |
وقد ذكر العلماء رضوان الله عليهم مسائل ملتبسة يُدعى فيها إلى الصلح، من ذلك: )فرع): قال أبو الحسن في كتاب الرهون: وكذا لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان فله المتعارف من تلك السكة قبل حدوث الميزان، فإن جهل مقدار ذلك كان كمسألةٍ من آخر كتاب الصُّلح فيمن له عليه دراهم نَسِيا مبلغها، جاز أن يصطلحا على ما شاءا من ذهب أو ورِق، فإن أبَيَا أعرض عنهما الحاكم حتى يصطلحا([65]). وقد مضى نقل المواق في مسألة الغبن يدعى للصلح: فإن لم يصطلحا فللقاضي أن يحكم بتقدير الحقوق.
أما مسألة «الشرط المُسبق بمراعاة القيمة عند الأداء» فإن هذا الشرط في البيع وما شاكله يؤدي إلى جهالةٍ في الثمن وغررٍ من شأنه إبطال العقد، أما في القرض فإنه يؤدي إلى شبهة الربا، ولعل كلام الحطاب في «تحريم الكلام في مسائل الالتزام» يوضح المنحى الفقهي في مثل هذا الشرط، حيث قال: مما يؤول إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع، كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد في الثمن أو المثمن، أو إلى الوقوع في ربا الفضل أو في ربا النساء، كشرط مشورة شخص بعيد، أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة أو مدة زائدة عما قرره الشرع في السلعة المبيعة، أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول، أو شرط زيادة شيء مجهول في الثمن أو في المثمون، فهذا النوع يوجب فسخ البيع على كل حال، فاتت السلعة أم لم تفت، ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه, فإن كانت السلعة المبيعة قائمة رُدَّت بعينها، وإن فاتت رُدت قيمتها بالغة ما بلغت. راجع الملحق.
إن هذا الكلام يختصر محل اتفاق العلماء، ومسألتنا يمكن أن تدخل في شرط زيادةِ شيء مجهول في الثمن، وهذا داخل فيما يؤدي إلى الجهل والغرر في العقد المذكور، كذلك قد يؤدي إلى الربا في القرض؛ إذ من المعلوم أن الاشتراط في العقد أمر غير مقبول حتى ولو كان قبضة من علف([66]).
وإذا كنا لا نعتبر ذلك زيادة فإنه منفعة.
ومسألة الشروط هي مسألة تجاذبتها الأدلة ووردت فيها أحاديث عدة، أخذ كل فريق ببعضها وسلك بعضهم مسلك الجمع، ولا حاجة إلى الإضافة فيها, فإنها تخرجنا عن حد المقصود في بحث خاص بقضية واحدة ولو كان الشرط جائزا، وهو أمر دقيق، وبعد سرد جملة من النقول سيتضح لك مسلكنا في الاستنباط.
ذكر ابن أبي زيد مسألة الرهون في كتاب الصرف فقال: ومن استقرضتَه دراهمَ فلوسٍ وهو يومَ قبضها مائةٌ بدرهم ثم صارت مائتين لم تُردَّ إليه إلا عِدَّة ما قبضت، وشرطُكما غير ذلك باطل([67]).
وقد يقول قائل: كيف تستشهد ببطلان الشرط في هذه المسألة وتترك الشق الأول وهو صريح في منع الزيادة الناشئة عن انخفاض القيمة؟
الجواب: فإنه حسن قضاء، قال ابن قدامة: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز([68]).
ثانيا: لو قيل إن أخذ هذه الزيادة الصورية أمر مشروع؛ لأن المدار على القيمة وهي واحدة، فلماذا لا يجوز الشرط؟ قلنا: إنه ليس كل جائز في المآل يجوز اشتراطه في الابتداء، فمن المعلوم أنه إذا باع سلعة بنصف دينار ذهب، وعند حلول الأجل أخذ دارهم لأنه لا يوجد نصف دينار ذهب كان أمرا جائزا لا خلاف فيه، وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه، ومع ذلك فقد قال مالك في المدونة: (وإن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم لم يجز), فالممنوع هنا هو الشرط وليس قضاء الدينار بالدراهم, وقد بنى المالكية على ذلك قاعدة خلافية، فقال المقري: )قاعدة: اختلف المالكية في تأثير اشتراط ما يوجبه العقد في الفساد)، واستقرئ تأثيره من قوله في المدونة, وذكر مسألة المدونة التي ذكرناها, وقد نظم الزقاق في المنهج هذه القاعدة مع الفروع المبنية، فقال:
| هل شرط ما يوجبه الحكم منع | كهبة وعدة وما نزع |
لأم ولد إن تزوجت…………..
قوله «كهبة»: يريد به من وهب هبة ثواب، فإذا وهب وسكت وفهم إرادة الثواب فهي صحيحة اتفاقا وله الثواب, أما إذا اشترط الثواب مع الهبة فهي هبة ممنوعة عند عبد الملك بن الماجشون، وصححها ابن القاسم, قال في الذخيرة: قال سند: منع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل: أُقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها، وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل؛ لإظهار صورة المكايسة. قال أشهب: (يفسخ)([69])، قال: فإن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه, وكذلك إذا لم يقصد شيئا، فإن قصد المكايسة فهذا مكروه لا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض([70]).
ويبدو أن قوله عن أشهب (يفسخ( خطأ مطبعي، صوابه )يصح( لينسجم مع بقية الكلام المعزو لأشهب، وقد ذكر الحطاب هذا الفرع معزوا إلى الذخيرة وليس فيه لفظ )يفسخ(. يراجع فيه (الجزء 4) ([71])، “وما أكثر الأخطاء في هذه الطبعة من الذخيرة”.
قلت: وأكثر مسائل القرض تجوز في النهاية ولا تشترط في البداية، )كشَرْطِ عَفِنٍ بسالمٍ ودقيقٍ؛ أو كعكٍ ببلد)، ذلك نص خليل, علق عليه الزرقاني بقوله: هما به ليوفيه ببلد آخر ولو لِحاج؛ لما فيه من تخفيف مؤونة حمله، ومفهومه الجواز مع عدم الشرط, وهو كذلك خلافا لما في الحمديسية من جواز ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه([72]).
وهذا رأي المالكية، وهم أكثر الناس توسعة في الشروط بعد الحنابلة، كما يقول ابن تيمية. ـ راجع ملحق الشروط من هذه النقول تفهم الفرق بين المعالجة اللاحقة والشروط السابقة ـ.
ومنها نستخلص أن شرط الربط قد يخالف مقتضى العقد؛ إذ إنه قد يؤدي إلى جهالة في الثمن؛ لأن حالة الأسواق كحالة الجو والعملات في مهب رياح المضاربات الغاديات الرائحات، فهو وإن كان سيرد القيمة فإنه لا يعرف ما هو مقدار القيمة التي سيردها من ناحية العدد، ولا يدري لعل أي تضخم لا يحدث فلا يرد شيئا، إذن يوجد جهل بالعاقبة، بموجبه سيكون الشرط مدعاة للغرر، أما في القرض فتوجد شبهة ربا، سماها ابن القاسم «صورة المكايسة» ـ في الكلام الذي نقلناه عن القرافي آنفا ـ.
ولهذا فأنا أرى الأخذ باعتبار تغير العملات في المآلات والنهايات لا في البدايات, أراه معالجة لأمر واقع لافتراض متوقع.
تحصيل الرأي:
إن رخص قيمة العملة (التضخم) إذا كان فاحشا ـ ويقدر كونه فاحشا بالعرف ـ مؤثر في أعواض العقود الآجلة, مما يجب للمتضرر المطالبة بجبر الضرر اللاحق, حيث يردهما القاضي أو الجهة المحكمة إلى القيمة العادلة مع مراعاة الثمن في أصل العقد, حتى لا يربح مرتين – على حد عبارة ابن عباس ﭬ حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين([73])- لأنه قد يكون الدائن قد باع على المدين بسعر مرتفع تحسبا للتضخم، فعلى القاضي أن يراعي ذلك في تقدير القيمة العادلة لا وكس فيها ولا شطط بعد أخذ رأي المختصين، ولا يجوز الشرط في صلب العقد سواء كان عقد بيع أم نحوه أم في قرض – يمكن استثناء ودائع البنوك استحسانا من ذلك – ومع تفويت الوديعة وتحريكها بالتجارة يعتبر تسلفا كما قال الناصر اللقاني: لأن التجر فيها يتضمن سلفها([74]). إلا أن البنوك بوضعها للوديعة تحت الطلب يمكن استثناؤها من تأثير التضخم الذي منحه لفائدة المُودِع؛ لأن بقاءها دون سحب كان بسببه لا بسببها، إلا أن تماطل في السحب فيرجع الأمر إلى ما قررناه، وهو فرق تنطبق عليه قاعدة الاستحسان وقد بسطنا حيثيات هذا الرأي في البحث وملاحقه, وهي باختصار:
إن هذه المسألة جديدة اجتهادية لا نص فيها وإن أقوال الفقهاء لا تستبعدها، فقد قال بها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وحكيت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفُهمت من أقوال مختلفة من أقوال علماء المذاهب ذكرناها.
إن النقود الورقية بتقلباتها وأصلها الورقي الذي لا قيمة له في نفسه لا يمكن أن يحكم لها بما يحكم به للنقدين؛ لأنها أحط مرتبة من الفلوس – كما تبين من ملحق النقدين -.
لقد بينا رأينا على قاعدة نفي الضرر، والتشبيه بالجائحة قياسا أو تخريجا، وتطبيق المصلحة المرسلة اجتهادا وأن القيم أعدل، فيمكن أن تصبح معيارا عاما في المثلي وغيره – كما ذكرنا في ملحق الأعواض والمعايير -, وبينا أن تقدير التضخم المعتبر يكون على قاعدة العرف بعد أن ذكرنا جملة من المقادير المعتبرة عند الفقهاء كمؤشرات مساعدة في عملية التقدير والاجتهاد, ورفضنا الربط بالشرط للغرر والجهالة في البيع ونحوه، وشبهة الربا في القرض، فتمكن مراجعة “ملحق الشروط”, وقد أشرنا إلى أن قيام وسيط للتبادل يعتمد على القيمة أمر غير مستبعد، ورصدنا بواكير الأفكار الفقهية التي ينطلق منها.
الملحق الأول: النقود الشرعية وتطورها
نصوص للمؤرخين والفقهاء:
قال ابن خلدون في مقدمته:
السكة: وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة، ويضرب بها على الدنانير أو الدراهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه، فيكون التعامل بها عددا، وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا, ولفظ «السكة» كان اسما للطابع، وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه، وهي الوظيفة، فصار علما في عرف الدول, وهي وظيفة ضرورية للملك؛ إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة, وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصة بها، مثل تمثال السلطان لعهدها، أو تمثال حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك، ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم.
ولما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب، وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزنا، وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم، ويردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها بينهم، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك، فأمر
عبد الملك الحجاج – على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد – بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص، وذلك سنة أربع وسبعين، وقال المدائني: سنة خمس وسبعين، ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين ، وكتب عليها «الله أحد الله الصمد», ثم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك فجود السكة، ثم بالغ خالد القسري في تجويدها، ثم يوسف بن عمر بعده, وقيل: أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق سنة سبعين بأمر أخيه
عبد الله لما ولي الحجاز، وكتب عليها في أحد الوجهين «بركة الله» وفي الآخر «اسم الله» ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها اسم الحجاج، وقدر وزنها على ما كانت استقرت أيام عمر, وذلك أن الدرهم كان وزنه في الإسلام ستة دوانق، والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم، فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل, وكان السبب في ذلك أن أوزان الدراهم أيام الفرس كانت مختلفة، وكان منها على وزن المثقال عشرون قيراطا، ومنها اثنا عشر، ومنها عشرة، فلما احتيج إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط، وذلك اثنا عشر قيراطا، فكان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم, وقيل: كان منها البغلي بثمانية دوانق، والطبري أربعة دوانق، والمغربي ثمانية دوانق، واليمني ستة دوانق، فأمر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل، فكان البغلي والطبري اثني عشر دانقا، وكان الدرهم ستة دوانق، وإن زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالا، وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهما، فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش، عين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر ﭬ واتخذ طابع الحديد، واتخذ فيه كلمات لا صورا, لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها، مع أن الشرع ينهى عن الصور، فلما فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها، وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين، والكتابة عليهما في دوائر متوازية، يُكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله تهليلا وتحميدا وصلاة على النبي ﷺ وآله، وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة, وهكذا العباسيين والعبيديين والأمويين, وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر، اتخذها منصور صاحب «بجاية»، ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه, ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل، وأن يُرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه ويملأ من أحد الجانبين تهليلا وتحميدا، ومن الجانب الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون، وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد, ولقد كان المهدي – فيما ينقل – ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع, نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله، المخبرون في ملاحمهم عن دولته, وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة، وإنما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منها، ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ (الأنعام: 96), ولنختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما, وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال, والشرع قد تعرض لذكرهما، وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرهما, فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامه، دون غير الشرعي منهما.
فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار, ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة, وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع, فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع، أجوده الطبري وهو أربعة دوانق، والبغلي وهو ثمانية دوانق، فجعلوا الشرعي بينهما وهو ستة دوانق، فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسةَ دراهم وسطا, وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك وإجماع الناس بعد عليه – كما ذكرناه – ذكر ذلك الخطابي في كتاب «معالم السنن»، والماوردي في «الأحكام السلطانية»، وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها ـ كما ذكرناه ـ.
والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر؛ لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق، وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج، وإنما كان متعارفا بينهم بالحكم الشرعي على المقدار في مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة، ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع؛ ليستريحوا من كلفة التقدير، وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهماوعينهما في الخارج كما هو في الذهن، ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت، ونقش عليها سكة، وتلاشى وجودها، فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه, ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم، واختلفت في كل الأقطار والآفاق، ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول، وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين المقادير الشرعية, وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقل المحققون عليه الإجماع، إلا ابن حزم خالف ذلك وزعم أن وزنه أربع وثمانون حبة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق، ورده المحققون وعدوه وهما وغلطا، وهو الصحيح، والله يحق الحق بكلماته.
وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس؛ لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار، والشرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيها، والله أعلم ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (الفرقان: 2) ([75]).
قال السيوطي في الحاوي:
وقال ابن عبد البر في التمهيد: كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب الحجاز كلها رومية، تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك، واسم الذي ضُربت في أيامه مكتوب بالرومية، ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا – وهو وزن درهمين ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة – وكانت الدراهم بالعراق وأرض المشرق كلها كسروية، عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية، ووزن كل درهم منها مثقال، فكتب ملك الروم – واسمه لاوي بن قرفط – إلى عبد الملك: أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فتضرب عليها الدنانير، فقال عبد الملك لرسوله: لا حاجة لنا فيها، قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الملك قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج؛ لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان، وكانت قبل ذلك من حجارة، وأمر فنُودي أن لا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي ، فضرب الدنانير العربية وبطلت الرومية.
وقال القاضي عياض: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله ﷺ وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويوقع بها المبايعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان؛ وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل؛ ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نُقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغارا وكبارا، فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم .
وقال الرافعي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم ستة دوانيق, كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام.
وقال النووي في شرح المهذب: الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله ﷺ كانت معلومة الوزن معروفة المقدار – وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية – ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر، فإطلاق النبي ﷺ الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق، وهو كل درهم ستة دوانيق، كل عشرة سبعة مثاقيل، وأجمع على ذلك أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن النبي ﷺ وخلفائه الراشدين.
وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق في «كتاب الأحكام»: قال ابن حزم: بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور – هذا كلام ابن حزم – . قال النووي بعد إيراده في شرح المهذب: «وقال غير هؤلاء: وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا » انتهى.
وقال ابن سعد في «الطبقات»: حدثنا محمد بن عمر الواقدي, حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد, عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمسة وسبعين – وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها – . وفي الأوائل للعسكري أنه نقش عليها اسمه, وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق الحميدي عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: أول من وضع وزن سبعة الحارثُ بن أبي ربيعة – يعني العشرة عددا سبعة وزنا – , وأخرج ابن عساكر عن المغيرة قال: أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن زياد وهو قاتل الحسين, وفي تاريخ الذهبي: أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب عبد الرحمن بن الحكم الأموي القائم بالأندلس في القرن الثالث الهجري، وإنما كانوا يتعاملون بها بما يحمل إليهم من دراهم المشرق, وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا, وأخرج ابن جرير في تفسيره عن السدي في قوله تعالى: ﭽﮧ ﮨﭼ (آل عمران: 14) قال يعني: المضروبة حتى صارت دنانير أو دراهم([76]).
قال السيوطي: وقال ابن كثير في تاريخه: في سنة ست وخمسين وسبعمائة رسم السلطان الملك الناصر حسن بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه وجعل كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم, وكان قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل ونصف بدرهم. وهذا صريح في أن الدراهم النقرة كان سعرها كل درهم ثلثا رطل من الفلوس, كما أن ما قاله الذهبي صريح في أنه كان سعرها حين ضربت كل درهم عشر دينار.
وقال الحافظ ابن حجر في تاريخه «إنباء الغمر»: في سنة ست وسبعين وسبعمائة بيع أرادب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة، وقيمتها إذ ذاك ست مثاقيل ذهب وربع انتهى.
وهذا على أن كل عشرين درهما مثقال. وقال ابن حجر أيضا في هذه السنة: غلا البيض بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين بدينار, وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال.
التاسعة: التعامل بالفلوس قديم، قال الجوهري في الصحاح: «الفلس يجمع على أفلس وفلوس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس» انتهى.
وهذا يدل على وجودها في زمن العرب ، قال سعيد بن منصور في سننه: ثنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال: لا باس بالسلف في الفلوس. أخرجه الشافعي في الأم ـ وإبراهيم المذكور في السند هو النخعي ـ , وأورد البيهقي في سننه دليلا على أنه لا ربا في الفلوس, وهذا يدل على وجودها في القرن الأول.
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن مجاهد قال: «لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد», وأخرج عن حماد مثله, وأخرج عن الزهري أنه سئل عن الرجل يشتري الفلوس بالدراهم قال: «هو صرف، فلا تفارقه حتى تستوفيه». وذكر الصولي في كتاب «الأوراق» أنه في سنة إحدى وسبعين ومائتين ولي هارون بن إبراهيم الهاشمي حسبة بغداد في زمن الخليفة المعتمد، فأمر أهل بغداد أن يتعاملوا بالفلوس فتعاملوا بها على كره ثم تركوها([77]).
إشكالية الفلوس:
قال الحافظ ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمته لموفق الدين علي بن ثابت الطالباني: «وله كلام في بيع الفلوس النافقة بأحد النقدين أنه يجوز النساء فيها, قال: كما يجوز بيع غيرها من الرصاص والحديد والصفر والنحاس». قال: ومنعُ أحمد من السلف في الفلوس لا يصح حمله على ما ذكره الأصحاب أنها أثمان؛ لأنه يحتمل وجوها أخر، منها أنه لم يجوز السلم في الفلوس عددا لاختلافها في الخفة والثقل، فأما وزنها فقياس المذهب صحته. قال: ولو أراد المنع من أجل أنها أثمان لجوزه؛ إذ جعل رأس مال السلم فيها غير الأثمان، ويحتمل أنه منع من السلم فيها بناء على الرواية التي نقلت عنه أنه منع من النساء في أموال الربا سواء اتفق الجنس أو اختلف، ثم نقل عنه جواز النساء مع اختلاف الجنس، وهو الصحيح من المذهب، ويحتمل أنه منع من السلم فيها إذا كانت نافقة خوفا من تحريم السلطان لها قبل المحل، فيصير كما لو أسلم في شيء يحتمل أن يوجد أو لا يوجد، فإنه لا يصح. قال: ولا يصح جعلها أثمانا؛ لأن الثمنية تختص بالذهب والفضة, وقد ذكر هذا أبو الخطاب في هدايته. وذكر ابن عقيل في الفصول: أن التفاضل يحرم في بيع أحد النقدين بمثله بعلة كونه موزون جنس، فيتعدى إلى كل موزون، ولو كان كما ذُكر لما جاز إسلام النقدين في الحديد والرصاص والنحاس. وقد زعم أنه أجاز ذلك استحسانا, وهذا لا يستقيم لأنه يزعم أن الوزن ثبت كونه علة بإيماء صاحب الشرع، وهي مقدمة على الاستحسان بإجماع الفقهاء، ثم احتج على أنها ليست ثمنا بأنها تختلف في نفاقتها وكسادها بإختلاف البلدان والأزمان، بخلاف النقدين، وبأنها لا تثبت في الذمة مطلقة، وبأنها في الغصب والإتلاف تقوم بالنقدين لا بالفلوس. ثم أرسل ابن الطالباني هذا الكلام إلى الشيخ موفق الدين المقدسي، فكتب عليها: «هذه مسألة فروعية اجتهادية لا حرج على المجتهد فيها إذا كان من أهل ذلك، وليس ينبغي أن ينكر على مجتهد اجتهاده ، وإنما يتباحث الفقهاء ليعرف الصواب».
والذي ذكره الإمام موفق الدين – يعني ابن الطالباني – من كون الفلوس ليست ثمنا أصليا صحيح لما بينه، ولأنها لا تكون رأس مال في الشركة والمضاربة. وأما منع الإمام أحمد ﭬ من السلم فيها فإن الذي ذكره الموفق فيها محتمل، ولولا أن الإمام أحمد قد علل ذلك بأنه يشبه الصرف، وهذا يحتمل أن يكون منه على سبيل الورع؛ لشبه الفلوس بالأثمان في المعاملة بها وجريانها مجرى الدراهم والدنانير، وأما أنا: فإنني متوقف عن الفتيا في هذه المسألة، ولست منكرا على من وافق فيها، ولا على من خالف من عمل بفتياه.
قلت: أما كون الفلوس أثمانا عند نفاقها فهو قول كثير من الأصحاب، وقد صرح به أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره, ومنهم من جعلها أثمانا بكل حال كصاحب (المنهج)، وخالف في ذلك ابن عقيل في باب الشركة من فصوله، ونص أنها عروض بكل حال، كما رجحها ابن الطالباني، وأما ما نقله ابن الطالباني عن أبي الخطاب في هدايته أنه ذكر أن «الأثمان هي الذهب والفضة خاصة» فهذا ذكره تفريعا على الرواية الثانية والثالثة في علة ربا الفضل، وأما على المذهب المشهور فإنه صرح بأن النقدين من جملة الموزونات والعلة فيها الوزن، كما صرح بذلك غيره من الأصحاب، بل كلام أبي الخطاب في خلافه الصغير يقتضي أن العلة في النقدين الوزن بغير خلاف، وأن الخلاف إنما هو في علة الأصناف الأربعة البواقي، وهكذا قال القاضي في خلافه الكبير وابنه أبو الحسين. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي الخواتيمي «رطل حديد برطلي حديد لا يجوز قياسا على الذهب والفضة»، فنص على أن علتها الوزن.
وبالجملة، فالمذهب المشهور أن علة ربا الفضل في النقدين الوزن، وعلة الربا في الأربعة البواقي الكيل، كما قاله ابن عقيل، ولم ينفرد ابن عقيل بهذا كما ذكر، بل كل الأصحاب يوافقونه على هذا النقل، وإن كان من متأخريهم من رجح أن علة الذهب والفضة كونهما جوهري الأثمان, ولهذا قالوا في ربا النساء إنه يحرم في كل مكيل بيع بمكيل، أو موزون بيع بموزون وإن اختلف الجنسان. واستثنوا من ذلك بيع العروض الموزونة بالنقدين, وقد نقل ابن منصور في مسائله عن الثوري وأحمد وإسحاق جواز السلف في الفلوس، فإنه قال: «قلت لأحمد: قال – يعني سفيان – السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها، قال: – يعني أحمد – إن تجنبه رجل أرجو أن لا يكون به بأس، وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس». قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب. قال إسحاق – يعني ابن راهويه -: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان يمكنه ذهبا أو فضة، رآه قوم كالصرف وليس ببين([78]).
قال إمام الحرمين الجويني: مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه فالعلة صحيحة عند الإمام الشافعي ﭬ, ونفرض المسألة في تعليل الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية، وهي مختصة بالنقدين لا تعدوهما.
وقد أطال النفس وناقش نفاة العلة القاصرة كالأحناف، وفي هذه المناقشة عرج على مسألة الفلوس أكثر من مرة، فقال: ولقد اضطرب أرباب الأصول عند هذا المنتهى، ونحن نذكر المختار من طرقهم، ونعترض على ما يتطرق الاعتراض إليه، ثم ننص على ما نراه. قال قائلون ممن يصحح العلة القاصرة: فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إذا جرت نقودا، وهذا خرق من قائله، وضبط على الفرع والأصل، فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس إن استعملت نقودا، فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين، والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعمالها، ثم إن صح هذا المذهب قيل لصاحبه: إن كانت الفلوس داخلة تحت اسم الدراهم فالنص متناول فيها، والطلبة بالفائدة قائمة وإن لم يتناولها النص، فالعلة متعدية إذا، والمسألة مفروضة في العلة القاصرة([79]).
وقال القرافي في القراض: (الشرط الأول أن يكون نقدا، وقاله الشافعي وأبو حنيفة، ففي الكتاب (المدونة): لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم دون الفلوس لأنها تبطل، وعنه الجواز خلافا لـ (ش) و (ح)؛ لأنها في معنى النقد..( إلى قوله: ( ..وفي الفلوس أقوال ثالثها الكراهة لشبهها بالعروض والنقود اعتبارا للشبهين)([80]).
ذكرت لك ما قيل في أصول النقود الذهبية والفضية، وتطور الدنانير والدراهم من نقود ذهنية كما سماها ابن خلدون في زمنه عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين؛ إلى نقود مشخصة روعي فيه العيار الشرعي في أيام عبد الملك بن مروان، ثم رجوعها على ما كانت عليه من قبل حين فسد الضرب، ثم ذكرت لك اختلاف العلماء في الفلوس وصعوبة تقبلهم لها كنقود تجري فيها أحكام المبادلات: «أن الدنانير والدراهم أثمان لا تكاد تختلف أسواقها وإن اختلف رجعت»([81]), فإذا كان الخلاف وقع في الفلوس ولها قيمة في نفسها هل تقاس على الذهب والفضة على أنها معدنية وأصلها الوزن وينتفع منها في غير الثمنية؟ وعلمت كيف كانت الدنانير والدراهم عملة مستقرة، فما هو موقع النقود الورقية؟ إنها حتما في مؤخرة النقود، وإنها لا يمكن الاستدلال لها بحديث ابن عمر: أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فقال: (لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) رواه الخمسة, قال في نيل الأوطار بعد أن ساق الحديث بهذا اللفظ من نص منتقى الأخبار: واختلف الأولون، فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث، وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص وهو خلاف ما في الحديث([82]).
قلت: والحديث فيه رد إلى سعر السوق وقت قضاء أحد النقدين عن الآخر حتى لا يكون صرفا مؤجلا، فإنه لو قضاه بسعرها يوم اشترى كان كأنه باع دنانير إلى أجل بدراهم أو العكس، ولتجنب ذلك اعتبر ما في الذمة مصارفا به الآن وقد دفعه, ووجهه ابن تيمية قائلا: وكذلك إذا اعتاض عن ثمن البيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره, كما في السنن عن ابن عمر أنهم سألوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبيع الإبل بالنقيع بالذهب ونقبض الورق، ونبيع بالورق ونقبض الذهب, قال: (لا بأس إذا كان بسعر يومه إذا افترقتما وليس بينكما شيء)، فيجوز الاعتياض بالسعر لئلا يربح فيما لم يضمن, فإن قيل فدين السلم يتبع ذلك فنهى عن بيع ما لم يقبض، قيل: النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون([83]).
وهذه الاستشهادات المطولة يرجى من ورائها أن يشترك معي المطالع في أن الوضع الراهن للعملات بعيد كل البعد عن الأول الذي نزل التشريع في ظله، وهو عملة مستقرة كل الاستقرار – كما قدمنا – لذا فإن عملية التكييف برزت منها حقيقة أولى؛ وهي أن الخلاف الذي كان قائما في دفع المثل أو القيمة في الكساد لا يمكن أن يبقى قائما في وضع عملة لا قيمة لها في نفسها، وبالتالي يعرو المبيع إن كان بيعا عن عوض، وهو أمر لا تقبله أبسط مبادئ القواعد الفقهية, الأمر الثاني: هو أننا لا يمكن أن نقيس العملة الورقية على الدينار والدرهم؛ لأن هذه لها قيمة في نفسها, ولأنها أثمان (بالخِلقة), سواء قلنا مع المالكية والشافعية ومع شطر الخلاف في مذهب أحمد إن العلة الثمنية، أو قلنا مع الأحناف وأصل مذهب أحمد في العلة هي الوزن.
تنبيه: ليس ما سقناه في مسألة النقود والنماذج التي اقتطفناها من أقوال العلماء في الفلوس معروضا لإصدار حكم في ثمنية الفلوس أو عرضيتها، وهل علة الربا في النقدين الثمنية أو الوزن؟ وهل هي علة متعدية أو هي علة قاصرة؟ ليس ذلك من مقصدنا ولا من مرامنا في هذا البحث, لأنه حول تغيرات العملة، ولم نعترض لذلك إلا بقدر ما يبرز التطور التاريخي للنقود، واختلاف الأقوال في الفلوس واضطرابها، والتردد الذي يصل إلى التوقف في مسألتها, وذلك بهدف وضع الورقية في موضعها، وتحديد مستقرها ومستودعها, وأدعي أنه لا ربط بين كونها ربوية أو غير ربوية؛ وبين مسألة تأثير التضخم في الحقوق المترتبة في الذمم، فإن التلازم الشرعي ليس كالتلازم العقلي, ولهذا يقول ابن القاسم فيمن أقر بزوجة في صحته وليس بطارئ؛ أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: ترثه الزوجة، ويرثه المقر له، مع أن الزوجية لا تثبت والنسب لا يثبت بهذا الإقرار، واعتبره إقرارا بالمال، وهذا يدل على عدم وجوب التلازم.
ورأيي في هذه المسألة هو ما ذكره القرافي باختصار، وهو أن الفلوس دارت بين شبهين أشبهت العروض من جهة، والأثمان من الجهة الأخرى، فأعملنا فيها كلا من الشبهين بمقداره, وهذا ما يسميه المالكية بالقاعدة البينية. قال في المنهج المنتخب:
| وبيع ذمي وعتق هل ورد | الحكم بين بين كونه اعتقد |
كالبيع مع شرط يصح وبطل وحكم زنديق وشبهه نقل
قال المنجور في شرحه: اختلف هل ورد الحكم بين بين؛ أي حكم بين حكمين؟ فأثتبه المالكية وهو من أعظم أصولهم، ونفاه الشافعية، ويعمل به من أثبته في بعض صور تعارض الأدلة ولا ترجيح، كما إذا أشبه الفرع أصلين ولم يترجح أحد الشبهين. واستشهد بحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر), و (احتجبي منه يا سودة).
القاعدة الثالثة: هي قاعدة مراعاة الخلاف عند مالك، قال الزقاق في المنهج:
| وهل يراعى الاختلاف لا نعم | وعاب ذا اللخمي عياض وعدم |
قيسا وقد أجاب نجل عرفه بأنه إعمال ما قد عرفهخصم من الدليل في الذي لزم مدلوله وفي نقيضه حكمغير لرجحان………………..
وباختصار فإن مراعاة الخلاف إعمال دليل كل من الخصمين([84]).
ثانيا: وهذا هو الأهم, إن الفقهاء في تعاملهم مع الكساد في الفلوس كان منطلقهم المثليَّة، والمثلية تكون في العرض، فالعرض ينقسم إلى مثلي ومقوَّم([85]), ولا أدل على ذلك من أن الشافعية القائلين برد المثل في الفلوس لا يقولون بربويتها، بل يصرح النووي في المجموع: إذا راجت الفلوس رواج النقدين لم يحرم الربا فيها، هذا هو الصحيح المنصوص عليه, وبه قطع المصنف والجمهور([86]), لأن علة الثمنية هي علة قاصرة على الذهب والفضة دون الفلوس([87]), وكذلك قال إمام الحرمين: قد علل أبو حنيفة $ الربا في النقدين بالوزن، وهو متعد إلى كل موزون، وعلل الشافعي $ بكونهما جوهري النقدين، وهذا مقتصر على محل النص، فما قولكم في ذلك؟ قلنا: الوزن علة باطلة عند الشافعي([88]).
سبب هذا التوضيح أن بعض أصحاب الفضيلة في المجمع جعل موقفي من الفلوس دليلا على حكمي بعرضيتها، وهو ما لم أقله، بل سعيت إلى الجمع بين الأدلة طبقا لقواعد مذهب مالك المذكورة أعلاه.
الملحق الثاني: الأعواض والمعايير الشرعية
هل الأعواض المستقرة في الذمم معتبرة بمعيارها، ومتعينة بأشخاصها، أم أنها قيم معيارها العدل والعرف بدون تقيد بالأعيان، بل بقيمتها بحيث يجتهد في إيصال الحق إلى صاحبه؟ وما هو المعيار الشرعي الثابت؟
قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أهمية القيمة العادلة التي تتجاوز الأعيان في فصل ننقله على طوله لفائدته وعمق مغزاه، قال $: (عوض المثل) كثير الدوران في كلام العلماء – وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو ركن من أركان الشريعة، مثل قولهم: قيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل، ونحو ذلك, كما في قول النبي ﷺ: (من أعتق شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد), وفي حديثٍ أنه قضى في بروع بنت واشق بمهر مثلها لا وكس ولا شطط- يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوس والأموال والأبضاع والمنافع، وما يضمن بالمثل من الأموال والمنافع وبعض النفوس، وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة أيضا؛ لأجل الأرش في النفوس والأموال, ويحتاج إليه في المعاوضة للغير، مثل: معاوضة الولي للمسلمين، ولليتيم، وللوقف، وغيرهم, ومعاوضة الوكيل، كالوكيل في المعاوضة، والشريك والمضارب، ومعاوضة من تعلق بماله حق الغير، كالمريض, ويحتاج إليه فيما يجب شراؤه لله تعالى، كماء الطهارة، وسترة الصلاة، وآلات الحج، أو للآدميين، كالمعاوضة الواجبة مثلا, ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله، وهو نفس العدل ونفس العرف الداخل في قوله: ﭽﮀ ﮁﭼ (الأعراف: 157) ، وقوله: ﭽ ﭷ ﭸﭼ (الأعراف: 199)، وهذا متفق عليه بين المسلمين، بل بين أهل الأرض، فإنه اعتبار في أعيان الأحكام لا في أنواعها, وهو من معنى القسط الذي أرسل الله له الرسل وأنزل له الكتب، وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، كما قال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ (الرحمن: 60)، وقال: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ (الشورى: 40) ، وقال: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﭼ (البقرة: 178)، وقال: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ (النحل: 126)، لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب، والزيادة إحسان مستحب، والنقص ظلم محرم، ومقابلة السيئة بمثلها عدل جائز، والزيادة محرم، والنقص إحسان مستحب، فالظلم للظالم، والعدل للمقتصد، والإحسان المستحب للسابق بالخيرات, والأمة ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات, وكثيرا ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون في حقيقة عوض المثل في جنسه ومقداره في كثير من الصور؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأعواض والمعوضات والمتعاوضين, فنقول: «عوض المثل» هو مثل المسمى في العرف، وهو الذي يقال له السعر والعادة، فإن المسمى في العقود نوعان؛ نوع اعتاده الناس وعرفوه، فهو العوض المعروف المعتاد؛ ونوع نادر لفرط رغبة أو مضارة أو غيرهما، ويقال فيه ثمن المثل، ويقال فيه المثل؛ لأنه بِقَدْر مثل العين، ثم يقوم بثمن مثلها، فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم, ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات، ولا بد أن يقال في الأمر المعتاد، فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم, وقد عُلم بالعقول أن حكم الشيء حكم مثله، وهذا من العدل والقياس والاعتبار وضرب المثل الذي فطر الله عباده عليه, فإذا عُرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار عُلم أن ذلك ثمن مثله، وهو قيمته وقيمة مثله، لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض محرَّم كصنعة الأصنام والصلبان ونحو ذلك، كان ذلك العوض محرما في الشرع, فعوض المثل في الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعي، وهو أن تكون التسمية شرعية، وهي المباحة، فأما التسمية المحظورة إما لجنسها كالخمر والخنزير؛ وإما لمنفعة محرمة كالعنب لمن يعصره خمرا؛ أو الغلام لمن يفجر به؛ وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد أداؤها؛ أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين؛ كالمهور التي لا يقصد أداؤها، وهي تضر الزوج إلى أجل، كما يفعل جُفاة الأعراب والحاضرة ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس بتسمية شرعية، فليس هو ميزانا شرعيا يُعتبر به المثل حيث لا مسمى, فتدبر هذا فإنه نافع، خصوصا في هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة التي قد نهى الله عنها ورسوله، فإن من الفقهاء من يعتبرها في مثل كون الأيم لا تتزوج إلا بمهر مثلها، فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافا للشريعة؛ بناء على أنه مهر المثل حتى في مثل تزويج الأب ونحوه، فهذا أصل.
إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع, فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته، فعند قلته يُرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطلاب وقلتهم، فإن ما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها، فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها، وبحسب المعاوض، فإن كان مَلِياًّ دينا يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده، والملي المطلق عندنا هو الملي بماله وقوله وبدنه, هكذا نص أحمد.
وهذا المعنى – وإن كان الفقهاء قد اعتبروه في مهر المثل – فهو يعتبر أيضا في ثمن المثل وأجرة المثل وبحسب العوض، فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج، كالدراهم والدنانير بدمشق في هذه الأوقات، فإن المعاوضة بالدراهم هو المعتاد, وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين، فإذا كان الباذل قادرا على التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه، بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء, ومراتب القدرة والوفاء تختلف، وهو الخير المذكور في قوله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ (النور: 33)، قالوا: قوة الكسب ووفاء العهد, وهذا يكون في البائع وفي المشتري وفي المؤجر والمستأجر والناكح والمنكوحة، فإن المبيع قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا، فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب، وكذلك المشتري قد يكون قادرا في الحال على الأداء لأن معه مالا، وقد لا يكون معه لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة، فالثمن مع الأول أخف, وكذلك المؤجر قد يكون قادرا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة، وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة، كالقرى التي ينتابها الظلمة من ذي السلطان أو لصوص أو تنتابها السباع؛ فليست قيمتها كقيمة الأرض التي لا تحتاج إلى ذلك، بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفي منفعته إلا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته لأعوانه وأنصاره، أو يستوفي غيره منه منفعة يسيرة، وذو القدرة يستوفي كمال منفعته لدفع الضرر عنه, وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجر، بل والمشتري والمنكوح وغير ذلك، فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره؛ لقدرته على جلب الأسباب التي بها يكثر الانتفاع، وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاع، فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من الأسباب ودفعه من الموانع موجبا لأن يدخل ذلك التقويم إلا إذا فرض مثله، فقد تكون الأرض تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتَدِين أو السباع، أو لاحتياج استيفاء المنفعة إلى قوة ومال([89]).
قال ابن تيمية: وأما إذا أخره إلى حينِ حلول السلم ثم أراد رد مثل رأس ماله فليس هذا مثلا له، فإذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل، فإنهما تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من المسلم فيه لا من غيره، لكن لم يتفقا على القدر، فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب بالقياس، فإن قبض الثمن قبل قبض المُثمَّن, ولو اشترى سلعة لم يقطع فيها، وقلنا: هو بيع فاسد، فإذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة بالسعر وقت القبض, فكما أوجبنا هنا قيمة المقبوض من العوض نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم, ونظيرها من كل وجه أن يكون المبيع مكيلا وموزونا لم يقطع ثمنه لكنه مؤجل إلى حول، فحين يحل الأجل إن رد حنطة مِثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة، فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل، فهذا في الثمن والمثمن سواء.
والأصل فيه أن «كل ما كان أقرب إلى ما تعاقدا عليه وتراضيا به كان أولى بالاستحقاق مما لم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا به، وأن المضمون بالغصب والإتلاف إذا لم يكن مثليا فإنه يقدر بالقيمة لا بالعقود»، فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد آخر، لكن هذه المسألة «مسألة الحلول والتأجيل» مبنية على أصل آخر وهو «أن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل», وهذا مذكور في موضعه, والله أعلم([90]).
المأخذ الثاني:
مأخذ من يقول: يجوز بيع الربوي بالربوي على سبيل التحري والخَرص عند الحاجة إلى ذلك إذا تعذر الكيل أو الوزن، كما يقول ذلك مالك والشافعي وأحمد في بيع العرايا بخرصها، كما مضت به السنة في جواز بيع الرطب بالتمر خرصا، لأجل الحاجة, ويجوز ذلك في كل الثمار في أحد الأقوال من مذهب أحمد، وغيره، وفي الثاني: لا يجوز، وفي الثالث: يجوز في العنب والرطب خاصة كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي، وكما يقول نظير ذلك مالك وأصحابه في بيع الموزون على سبيل التحري عند الحاجة، كما يجوز بيع الخبز بالخبز على وجه التحري، وجوزوا بيع اللحم باللحم على وجه التحري عند السفر, قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولا ميزان عندهم فيجوز كما جازت العرايا، وفرقوا بين ذلك وبين الكيل، فإن الكيل ممكن ولو بالكَفّ.
وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحري والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند الحاجة، فمعلوم أن الناس يحتاجون إلى بيع هذه الدراهم المغشوشة بهذه الخالصة، وقد عرفوا مقدار ما فيها من الفضة بأخبار أهل الضرب وأخبار الصيارفة وغيرهم ممن سبك هذه الدراهم، وعرف قدر ما فيها من الفضة فلم يبق في ذلك جهل مؤثر، بل العلم بذلك أظهر من العلم بالخرص أو نحو ذلك، وهم إنما مقصودهم – أخذ – دراهم بدراهم بقدر نصيبهم، ليس مقصودهم أخذ فضة زائدة، ولو وجدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة خالصة من غير اختيارهم بحيث تبقى في بلادهم لفعلوا ذلك وأعطوه أجرته، فهم ينتفعون بما يأخذونه من الدراهم الخالصة ولا يتضررون بذلك، وكذلك أرباب الخالصة إذا أخذوا هذه الدراهم فهم ينتفعون بذلك ولا يتضررون.
وهذا «مأخذ ثالث» يبين الجواز وهو أن الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل، وذلك ظلم يضر المعطي، فحرم لما فيه من الضرر, وإذا كان كل من المتقابضين مقابضة أنفع له من كسر دراهمه وهو إلى ما يأخذه محتاج كان ذلك مصلحة لهما، فهما يحتاجان إليها، والمنع من ذلك مضرة عليهما، والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة ويوجب المضرة المرجوحة كما قد عُرف ذلك من أصول الشرع([91]).
قضية المعايير الشرعية:
قال في الدر المختار: («وما نص» الشارع «على كونه كيليا» كبُر وشعير وتمر وملح «أو وزنيا» كذهب وفضة «فهو كذلك» لا يتغير «أبدا, فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا» ولو «مع التساوي» لأن النص أقوى من العرف، فلا يترك الأقوى بالأدنى «وما لم ينص عليه حُمل على العرف» وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا, ورجحه الكمال).
قال ابن عابدين: (قوله ورجحه الكمال) حيث قال عقب – ما ذكرناه -: ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك، وهو يقول: يُصار إلى العرف الطارئ بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص حتى لو كان ﷺ حيا نص عليه اهـ. وتمامه فيه, وحاصله: توجيه قول أبي يوسف: إن المعتبر العرف الطارئ بأنه لا يخالف النص بل يوافقه؛ لأن النص على كيلية الأربعة؛ ووزنية الذهب والفضة؛ مبني على ما كان في زمنه ﷺ من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورود النص موافقا له، ولو تغير العرف في حياته ﷺ لنص على تغير الحكم, وملخصه أن النص معلول بالعرف، فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان, ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم, (قوله: وخرَّج عليه سعدي أفندي) أي في حواشيه على العناية، ولا يختص هذا بالاستقراض، بل مثله البيع والإجارة؛ إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار إليهما، ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس, وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية: إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف, لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله: أن العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لا يجوز، ولكن نحن نقول إذا كان الذهب والفضة مضروبين فذكر العد كناية عن الوزن اصطلاحا لأن لهما وزنا مخصوصا؛ ولذا نقش وضبط، والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ معيار الشرعي، وأيضا فالدرهم المقطوع عَرف الناس مقداره، فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العدد دالا عليه, وقد وقع في بعض العبارات ذكر العد بدل الوزن؛ حيث عبر في الزكاة درر البحار بعشرين ذهبا، وفي الكنز بعشرين دينارا بدل عشرين مثقالا ا هـ. ملخص.
وهو كلام وجيه، ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على دينار ولا درهم على درهم، والواقع في زماننا خلافه؛ فإن النوع الواحد من أنواع الذهب أو الفضة المضروبين قد تختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من ضرب سلطان زماننا أيده الله, فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن؛ أو يوفى بدلها وزنا لا عددا، وأما بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة، والظاهر أنه لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضا، فهو المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارئ على هذه الرواية أنه لو تُعورف تقدير المكيل بالوزن أو بالعكس اعتُبر، أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلا كما في زماننا من الاقتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز، لا على الروايات المشهورة ولا على هذه الرواية؛ لما يلزم عليه من إبطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة المجتهدين, نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددا بدون وزن اتباعا للعرف، بخلاف بيعها بالنقود الخالصة فإنه لا يجوز إلا وزنا كما سيأتي في كتاب الصرف إن شاء الله تعالى. وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف» فراجعها([92]).
قال الحطاب عند قول خليل )«وإلا فبالعادة»: ش: أطلق $ في العادة والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار فالمعتبر العادة العامة، فإن لم يكن فعادة محله كما صرح به ابن الحاجب، والله أعلم)([93]).
وقال المواق عند قول خليل: («واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع»: الباجي: بماذا يكون التماثل؟ أما في الحبوب فبالكيل؛ لأن ذلك معيارها في الشرع؛ لأن النبي ﷺ ذكر الأوساق في زكاة التمر, وحُكم الحبوب حكمها في اعتبار نصب الزكاة وفي إخراج زكاة الفطر، فلا يجوز على هذا شيء من الحبوب بجنسه بغير الكيل، وقد تقدم نص ابن رشد في الزيتون أن معيارها الكيل، وقول سحنون إن الدقيق كذلك، وانظر المذهب.
تقدم في الزكاة تقدير النصاب منها بمقتضى كلام ابن يونس وابن عرفة أنه بالوزن «وإلا فبالعادة» الباجي: أما ما لا مقدار له في الشرع فإن كان له مقدار معتاد من كيل أو وزن ولا يختلف باختلاف البلاد كاللحم والجبن الذي يعتبر في كل بلد؛ فلا يجوز التساوي فيه بمقدار غيره، وكذلك ما يُعتبر بالكيل في كل بلد، وانظر ما يختلف تقديره باختلاف عادة البلاد كالسمن واللبن والزيت والعسل، عادة بعض البلاد فيه الوزن، وبعضها الكيل. انتهى.
وقال ابن بشير: ما اختلف فيه البلاد قدر بعادة بلده، ولا ينتقل عنها إلا أن تعلم نسبة التنقل إليه من الجاري في العوائد، وفي الرجوع إلى التحري في البيض قولان. ابن عرفة: في مقابلة التحري عند وزنه، والوقف الذي تقدم للباجي نظر، وظاهر رواية ابن القاسم أن المعتبر فيه الوزن. انتهى.
انظر هل يكون على هذا قشر البيض وقشر الجوز واللوز بمنزلة نوى التمر، انظر قبل قوله «وذي زيت» . «فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته», من المدونة: قال مالك: لا يجوز صبرة قمح بصبرة شعير إلا كيلا مثلا بمثل، ولا يجوز تحريا, يريد وكذلك ما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري، إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة. قال ابن القاسم في العتبية: وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري، مثل اللحم والخبز والبيض، يجوز بعضه ببعض تحريا. قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع تحريه. ابن يونس: وذلك إذا لم يحضرهما ميزان, يؤيد ذلك قوله «لا يجوز ذلك فيما يكال إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة». ابن رشد: ظاهر المدونة جواز التحري في الموزون ولو لم تدع له ضرورة, ثم قال ابن يونس: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل بصنفه فلا بأس بقسمته على التحري كان مما يكال أو يوزن أو لا.
ابن عبدوس: أخطأ من قال عن ابن القاسم لا يجوز قسم البقل تحريا بعد الحزر، وهو يجيز التحري في الخبز واللحم؛ فكيف بما يجوز فيه التفاضل. انتهى.
وهذا الذي أنكره ابن عبدوس؛ وعزاه ابن رشد للمدونة؛ ونقل ابن يونس عن مالك أن ما يكال أو يعد من طعام أو غيره فلا يقسم تحريا، بخلاف ما يوزن فإنه يقسم ويباع بعضه ببعض بالتحري. انتهى.
فقد تحصل من هذا أنه لا ينبغي في المكيل والمعدود أن تقع فيه قسمة أو مبادلة بتحر، ولا بد من العد أو الكيل، وسواء كان ربويا أم لا، بخلاف ما يوزن فإنه يجوز قسمه ومبادلته بالتحري ولو لم يكن ربويا على ما لابن القاسم في نقل ابن عبدوس، وهو أيضا نقل ابن يونس عنه، وظاهر قول مالك في كتاب محمد مقتضى ما لابن يونس عن ابن القاسم: أن التحري يجوز في المكيل إذا كان يجوز فيه التفاضل, وسيأتي أيضا في المزابنة ما يشرح هذا. اهـ([94]).
واختلف المالكية في العدد والوزن أيهما يلغى عند التعارض فيقول الزرقاني: (لأن المتعامل به عددا ووزنا عندنا يلغى فيه جانب العدد), ويعلق عليه البناني بكلام الخرشي: «أو» أما إن كان التعامل بهما فيلغى الوزن، وهو صريح المدونة، وعليه حملها أبو الحسن, ونقل الباجي أنه يلغى العدد, وقد علمت أنه خلاف ظاهرها.
إن الأشياء المشخصة لا تثبت في الذمة، قال القرافي: «الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمة وما لا يثبت فيها: اعلم أن المعينات الشخصية في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم»، وأشار إلى هذا المعنى صاحب المنهج المنتخب بقوله:
| وهل تعين لما في الذمة | هل ينقل الحكم بعيد نية |
لكن ما هي الذمة؟
يعرفها القرافي بأنها «معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجور قابل للالتزام، فإذا التزم شيئا اختيارا لزمه، ويلزمه أرش الجنايات وما أشبه ذلك, والذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع، ترجع إلى التقادير الشرعية، وهي إعطاء المعدوم حكم الموجود».
بعدما نقلناه في شأن الأعواض وعدم تعين ما في الذمة؛ وما نقلناه بعد ذلك في المعايير الشرعية من كيل أو وزن أو عدد وتحر وحرز وأي شيء يشهد له العرف والعادة التي يمكن أن يحدد معيارا في الأمور التي فيها نص من الشارع عند بعضهم؛ وعند جميعهم فيما لم يرد فيه نص من الشارع، وقد رأيت أهمية القيمة.
فما هي القيمة؟
القيمة: بالكسر واحدة القيم، وهو ثمن الشيء بالتقويم، وأصله الواو؛ لأنه يقوم مقام الشيء، ويقال ما له قيمة إذا لم يدم على الشيء ولم يثبت، وهو مجاز. وقومت السلعة تقويما، وأهل مكة يقولون: استقمتها ثمنتها؛ أي قدرتها, ومنه حديث ابن عباس: )إذا استقمت بنقد فبعت فلا بأس به(, قال أبو عبيد: استقمت بمعنى قومت، وهذا كلام أهل مكة يقولون: استقمت المتاع؛ أي قومته، وهما بمعنى, وفي الحديث قالوا: يا رسول الله لو قومت لنا، فقال: )الله هو المقوم(؛ أي لو سعرت لنا, وهو من قيمة الشيء؛ أي حددت لنا قيمتها([95]).
قال تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قِيَما﴾ (النساء: 5), وهي قراءة نافع، جمع قيمة؛ أي بها تقوم أموركم, ودينار قائم إذا كان مثقالا سواءً لا يرجُح, وهو عند الصيارفة ناقص حتى يرجُح بشيء فيسمى ميَّالا, والجمع قُوَّم وقُيَّم، وهو مجاز , وتقاوموه فيما بينهم إذا قدروه في الثمن([96]).
هذا معنى القيمة لغة, أما في الاصطلاح عند الفقهاء فإنها على صنفين: قيمة سلطانية، وهذه قيمة النقود، وقيمة تحددها رغبات الناس، وهذه قيمة غيرها, قال الزرقاني: والمراد بالقيمة ما جعله الإمام قيمة في الدنانير والدراهم، وأما في غيرهما فتعتبر الجارية بين الناس([97]).
وفي قضية السِّكة الباطلة يذكر أكثر الفقهاء قيمتها بالذهب كما مر معك, إلا أنهم في بعض الأحيان يذكرون القيمة من العروض، كما فعل الدردير في الشرح الصغير كما تقدم, والأشياء بين مثلي ومقوم, فالمثلي هو الذي يباع كيلا أو وزنا, والمقوَّم هو ما ليس كذلك, ولهم كلمات قيمة في القيمة، منها قول ابن القاسم: «والقيمة أعدل»، وتعليل رأي أشهب بأن القيمة هي «الملاية التي تتعلق بها الأغراض»، وقول ابن تيمية: «فإذا أوجبت قيمة المسلم فيه وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب بالقياس»، وقول ابن قدامة: «القيمة أحصر».
ولأن القيمة تعبر عن حقيقة رغبة الناس في ذلك الشيء في الوقت المحدد الذي عبر في الحديث الشريف: (بسعر يومها), وإذا كانت النقود الورقية ستختفي كما يقال لتحل محلها بطاقات ائتمان أو نحوها، فنحن أمام وضع لا يمكن أن يكون معياره غير القيمة, وعلى الاقتصاديين أن يدرسوا كيف تكون عادلة في زمان يموج بالمضاربات والمقامرات التي ترفع أقواما وتضع آخرين، وتفقر أناسا وتغني أناسا.
هذا هو الغرض من جلب ما ذكرت ليتضح لك ما قاله العلماء، وما افترضوه في أوضاع أكثر استقرارا من أوضاع أسواقنا، وأقل حاجة للحركة والنشاط.
وبعد ذلك كله فإني لا أستبعد إذا قامت طريقةٌ للتبادل وللتعامل مبنية على القيمة دون اعتبار التشخيص الخارجي؛ وأصبحت عرفا معروفا وعادة مستقرة؛ أن يتقبلها الفقه الإسلامي، فقد كانت بواكير ذلك وبوادره ظاهرة في مذهب الإمام أحمد $ حيث اعتبر القيمة في المثليات، وبالأخص في مسألة الكساد – موضوع بحثنا – وكذلك في آراء أبي يوسف في مسألة تحكيم العرف في المعايير، وفي مسألة الكساد والرخص – موضوع البحث أيضا – , وفي موقف ابن عتاب وابن دحون في مسألة الكساد من وجوب رد القيمة لا المثل، وفي كلمات ابن القاسم وأشهب, ولكن الذي هتك أستارها ونفض غبارها هو ابن تيمية في مسألة عوض المثل وغيرها من مسائله التي نقلناها، فلله دره كعادته، لقد غاص على مكنونها، ونقب عن مخزونها.
كان ذلك مغزى النقول التي سبقت؛ ليفهم منها أن موضوعنا أولى بالقبول، وأقرب إلى القواعد والنقول.
الملحق الثالث: الشروط
في هذا الملحق لمحة عن الشروط، نبدؤها برواية ابن رشد في اختلاف ثلاثة من العلماء في الشروط؛ مما يدل على صعوبة منزعها، وتجاذب الأدلة فيها:
روي أن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت لأبي حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شيئا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا, إن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وشرط، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، قالت عائشة ڤ: أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة وأعتقها, وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، قال جابر: بعت من النبي ﷺ ناقة فشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة, البيع جائز والشرط جائز، فعرف مالك $ الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها، وتأولها على وجوهها، ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الأثر([98]).
والأحاديث المذكورة صحيحة إلا حديث أبي حنيفة الذي رواه عمرو بن شعيب فقد قالوا: إنه ليس بصحيح([99]). وإنما المنهي عنه شرطان لحديث أبي داود والترمذي: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع), وقال الترمذي: حسن صحيح([100]).
قال البناني: (تنبيه) قسم ابن رشد في المقدمات الشروطَ المتعلقة بالبيع على أربعة أقسام، وفي المصنف إشارة على جميعها، ولنذكر طرفا من حكمها فنقول:
القسم الأول: شرط ما يقتضيه العقد، كتسليم المبيع، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع, أما ما لا يقتضيه ولا ينافيه، ككونه لا يؤول إلى غرر وفساد في الثمن أو المثمن، ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفي مصلحة أحد المتابعين ، كالأجل والخيار والرهن والحميل وبيع الدار واستثناء سكناها أشهرا معلومة أو سنة كبيع الدابة واستثناء ركوبها ثلاثة أيام ونحو ذلك أو إلى مكان قريب.
وهذا القسم من الشروط صحيح لازم يقضى به مع الشرط، ولا يقضى به دون شرط إلا ما كان يقتضيه العقد، فإنه يقضى به لو لم يشترط، ويتأكد مع الشرط، وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: كشرط رهن وحميل وأجل.
القسم الثاني: ما يؤول إلى الإخلال بشرط من الشروط المتقدمة في صحة البيع، كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد أو في الثمن أو في المثمن أو إلى الوقوع في ربا الفضل أو ربا النساء، كشرط مشاورة شخص بعيد، أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة، أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول, فهذا النوع يوجب الفسخ على كل حال، فاتت السلعة أو لم تفت، ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه، فإن كانت السلعة المبيعة قائمة رُدَّت بعينها، وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت، ويستثنى من هذا النوع مسألة البيع بشرط السلف فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن، لكن إنما يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكا بشرطه، فإن أسقط شرطه صح البيع. وهذا القسم أشار له المصنف $ بالشروط المتقدمة مع قوله بعدها «وفسد منهي عنه إلا بدليل».
القسم الثالث: ما يكون من الشروط منافيا لمقتضى عقد البيع؛ لأن فيه تحجيرا على المشتري مثل أن يبيع السلعة على أن المشتري لا يبيعها ولا يهبها، أو على أن يتخذ الجارية أم ولد، أو على ألا يخرج بها من البلد، أو على أن لا يعزل عنها، أو على أنه إن باع المشتري السلعة فالبائع أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، أو على الخيار إلى أمد بعيد، أو ما أشبه ذلك مما يقتضي التحجير، فالمشهور في هذا النوع أنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع، هذا إذا كانت قائمة، فإن فاتت كان فيه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضه، قال في «البيان»: ويستثنى من هذا الحكم مسألتان؛
إحداهما: إذا باع الأمة وشرط على المشتري أن لا يطأها، وأنه إن وطئها فهي حرة أو فعليه كذا وكذا، فهذا يفسخ على كل حال على حكم البيع الفاسد، ولا يكون للبائع أن يترك الشرط من أجل أنها يمين لزمت المشتري؛ الثانية: أن يشترط الخيار إلى أمد بعيد، فإن البيع يفسخ فيها على كل حال، ولا يمضي إن رضي مشترط الخيار ترك الشرط؛ لأن رضاه بذلك ليس تركا منه للشرط، وإنما هو اختيار للبيع على الخيار الفاسد… اهـ. وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: «وكبيع وشرط يناقض المقصود».
القسم الرابع: ما يكون فيه الشرط غير صحيح إلا أنه ضعيف، فلم تقع له حصة من الثمن، فيصح البيع ويبطل الشرط، وإلى هذا القسم بفروعه أشار المصنف $ في فصل التناول بقوله: «كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة ولا مواضعة …» إلخ. (هذا تفصيل الإمام مالك ﭬ في بيع الشروط([101])).
وقد قسم الحنابلة الشروط أربعة أقسام:
قال ابن قدامة: (فصل): والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم، وخيار المجلس، والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما، ولا يؤثر في العقد.
الثاني: تتعلق به مصلحة العاقدين، كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة؛ أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة والكتابة ونحوها، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا.
الثالث: ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه وهو نوعان, أحدهما: اشتراط منفعة البائع في البيع، فهذا قد مضى ذكره, الثاني: أن يشترط عقدا في عقد نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، وهو على ضربين, أحدهما: اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل أن يشترط البائع على المشتري عتق العبد، فهل يصح؟ على روايتين, إحداهما: يصح، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي؛ لأن عائشة ڤ اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها وولاءها، فأنكر النبي ﷺ شرط الولاء دون العتق, والثانية: الشرط فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة, لأنه شرط ينافي مقتضى العقد أشبه إذا شرط أن لا يبيعه, لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه أشبه ما لو شرط أن لا يبيعه([102]).
قال ابن تيمية: القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه([103]).
وقد قدمنا علاقة الشروط بالتضخم, حيث أوضحنا أنه لا يجوز أن يشترط عليه ربطا بسعر معين فيما لو حدث التضخم؛ لأن هذا يؤدي إلى جهالة في الثمن لأنه مبني على توقع، وإنما يكون علاج التضخم بعد الوقوع.
الملحق الرابع: تطبيق مبدأ وضع الجوائح على حالة تغيُّر قيمة النقود محل الدَّين والالتزام.
وستكون خطتنا في هذا البحث كالتالي:
تعريف مختصر للتضخم, لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم تعريف بالجوائح وأحكامها وعللها، ثم تقديم جملة من الفروع الفقهية المبنية على مبدأ الظروف الطارئة لبيان علاقتها بالجوائح، ثم توضيح أوجه قياس تدهور قيمة العملة على وضع الجوائح مع بيان أن المسألة مسألة اجتهادية لا نص فيها للشارع, لذا فهي مسألة خلافية، مع ذكر بعض الأقوال فيها باختصار, ولن أتوسع في عرض أقوال العلماء في مسألة تغيرات العملة من كساد وانقطاع وبطلان ورخص وغلاء، فقد مضى الكلام فيها، وقد نلمح إلى بعضه فقط, وحسبي هنا أن أتعرض لأحكام الجائحة لتطبيقها على مسألة تغيير قيمة العملة بالرخص المعروف بالتضخم, ذلك هو الموضوع المحدد في رسالة التكليف.
ما هو التضخم؟ وما نتائجه؟
إن التضخم بكل بساطة انخفاض قيمة العملة وارتفاع أثمان السلع، مع ما يرافق ذلك من شظف في العيش بالنسبة للطبقات المتوسطة، وشح في الدخل.
أسباب التضخم عديدة ومتنوعة ومتداخلة ومتشابكة، قد ترجع إلى كوارث الجفاف الذي يهلك المحاصيل الزراعية، وإلى الحروب والفتن والاضطراب, كما ترجع إلى ضخ كمية من وسائل الدفع من طرف الدولة في الدورة الاقتصادية لغرض قد يكون لإيجاد موازنة أو لتمويل مشاريع، أو غيرها. هذه بعض أسبابه، وهي إن التبست واشتبهت فإن نتائجه واضحة، فالتضخم يحول الدائنين إلى خاسرين تدفع لهم ديونهم بمال قلت قيمته.
هذه النتيجة هي التي تشغل بال الباحثين والفقهاء والاقتصاديين، كيف نعوض خسارة الدائن؟ أم كيف نجعل المدين «الرابح» يتحمل مع الدائن الغُرم بعد أن استفاد من الغُنم؟
إن الإجابة على هذا السؤال هي بيت القصيد الذي يبحث عن أسس شرعية لرفع الخسارة المحققة للدائن دون إلحاق خسارة بالمدين, «فالضرر لا يزال بالضرر».
إذا كانت الجائحة تنقسم إلى جائحة سماوية، وهي التي لا يد لأحد فيها، وإلى جائحة مكتسبة، وهي التي من صنع الآدمي، فإن أسباب التضخم التي أشرنا إليها بعضها سماوي؛ وهو ناشئ عن الكوارث؛ وما هو من قبيل صنع الإنسان؛ كذلك الناشيء عن السياسة الاقتصادية للحكومات والحروب, وفي كل الأحوال فهو يدخل في حد ابن القاسم للجائحة بأنها «ما لا يستطاع دفعه إن علم به».
فما هي الجائحة؟
قال القرافي: النظر الثالث في وضع الجوائح, وهي من الجوح، قال صاحب الصحاح: الجوح بسكون الواو الاستئصال، جحت الشيء أجوحه، والجائحة هي الشدة التي تجتاح المال من فتنة أو غيرها، ويقال جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى، كذلك جاحه الله تعالى وأجاحه إذا أهلكه بالجائحة.
وفيه ثلاثة فصول في حقيقتها وقدرها ومحلها:
الفصل الأول: في حقيقتها المرادة في الثمار، ففي «الجواهر»: قال ابن القاسم: هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به، فلا يكون السارق جائحة على هذا ، وجعله في «الكتاب» جائحة, وقال مطرف و
عبد الملك: هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي، فلا يكون الجيش جائحة، وفي «الكتاب» جائحة([104]).
والجوائح منها المكتسب ومنها السماوي، قال أبو بكر بن العربي في كتابه «القبس»: بيد أن المتقدمين من علمائنا اختلفوا في نكتة، وهي أن الجائحة المكتسبة هل تساوي الجائحة الواقعة بالقدرة الإلهية أم لا ؟ وصورتها: أن نزول الجيش على البلد وإفساده للثمار هل يساوي هبوب (الريح)([105]) ووقع البرد أم لا ؟ وهي مسألة نظرية، وقد حققناها في مسائل الفروع([106]).
أشار خليل في مختصره إلى النوعين من الجائحة، وإلى الخلاف في السارق خاصة بقوله: (وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف؟(. قال البناني في حاشيته على الزرقاني («أو سارق خلاف»: القول الأول لابن نافع، وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية، قال في «التوضيح»: وعليه الأكثر، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور، والقول الثاني لابن القاسم في المدونة، وصوبه ابن يونس، واستظهره ابن رشد قائلا: لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك؛ لما بقى على البائع في الثمرة من حق التوفية)([107]), ونقله الدسوقي في حاشيته على الدردير حرفا بحرف([108]), وما عزى للباجي ذكره في «المنتقى»، فقد عزى القول الأول لابن نافع ولابن القاسم في الموازية، وذكر قوله في المدونة بالعبارة التالية: «وروى ابن القاسم في المدونة أن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كان فهو جائحة سارقا كان أو غيره»، إلا أنه ذكر عن مطرف وابن الماجشون: «لا يكون جائحة إلا ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر، وأما ما كان من صنع آدمي فليس بجائحة»([109]).
قال في «البيان والتحصيل»: قال ابن القاسم: الجيش جائحة, قال محمد بن رشد: وكذلك السلطان والغاصب الذي لا تأخذه الأحكام هو جائحة على مذهب ابن القاسم, وروايته عن مالك لأنه أمر غالب([110]).
وقال في «البيان والتحصيل» أيضا: وقد اختُلف إذا عابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها ولا أفسدتها جملة كالغبار يعيبها؛ والريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها بحيث ينقص ذلك من قيمتها، فقيل وهو المشهور إن ذلك جائحة، ينظر إلى ما نقص العيب منها، فإن كان الثلث فأكثر وضع عن المبتاع، وقيل ليس ذلك بجائحة وله حكم العيب، فيكون المبتاع فيه بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له، أو يرد ويرجع الثمن([111]). وهذا هو الخلاف الذي أشار إليه أبو بكر بن العربي، وذكره القرافي في كلامه السابق.
فتحصل في مذهب مالك ثلاثة أقوال في الجائحة:
القول الأول: ما لا يُستطاع دفعه إن علم به، ويدخل فيها النوعان السماوي والمكتسب إن كان جيشا.
والقول الثاني: كل ما أصاب الثمار فهو جائحة ولو كان سارقا، وهذا يوسع دائرة الجائحة, وهذان القولان لابن القاسم، أحدهما في كتاب ابن المواز، والثاني في المدونة.
القول الثالث: وهو قول مطرف وعبد الملك بن الماجشون: إنما تكون الجائحة بسماوي فقط, وهو قول يستبعد الجائحة المكتسبة.
وقد توسع المالكية في جائحة الثمار لتشمل المكتسبة كالجيش والسارق على الخلاف السابق, ووسعوا دائرة الجائحة لتشمل الظروف الطارئة, «ولو اشترى شرب يوم أو شهر لسقي زرع فغار الماء يوضع عن المشتري الماء ما قل منه، وهو في المدونة، وذكره الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة, ومنها «مسألة موت دود القز» الذي يراد له ورق التوت، ومكتري الحمَّام أو الفندق فيخلوا البلد، فيوضع عن المشتري في الأول، وعن المستأجر في الثاني كما سيأتي».
ومذهب الإمام أحمد هو كالقول المرجوح في مذهب مالك من حصر جائحة الثمار في السماوية دون المكتسبة، قال ابن قدامة: (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة, الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري, ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح, وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: )إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟), رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: )من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا, علامَ يأخذ أحدكم مال آخيه المسلم؟)، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه, قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر، ورواه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه وغيرهم.
الفصل الثالث:
إن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه، قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت جائحة تعرف الثلث أو الربع أو الخمس توضع، وفيه رواية أخرى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم؛ لأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط واحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة، والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها الوصية وعطايا المريض وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة بدليل قول النبي ﷺ في الوصية: )الثلث والثلث كثير(, فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به، ووجه الأول عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه؛ ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها فكان ما تلف منها من ضمان البائع وإن كان قليلا كالباقي على وجه الأرض، وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط.
إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل ثلث القيمة، فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن، وإذا اختلف في الجائحة أو قدر ما تلف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولأنه غرم، والقول في الأصل قول الغارم)([112]).
هذا حكم الجائحة: فما هي علة وضعها؟
وإذا كانت العلة هي الوصف أو المعنى الذي من أجله شرع الحكم في الأصل، فإن ذلك المعنى إذا وجد في غيره أمكن قياسه عليه.
أولا: هناك تعليل ورد في نص الشارع، وهو أنه أخذ مالا بغير حق أي بغير مقابل، لكن الفقهاء اختلفت عبارتهم في التعليل، فقد رأى أبو بكر بن العربي أنه من باب قاعدة العرف؛ وأنه من باب المقاصد والمصالح، فقال: )وأما باب الجوائح في الثمار فهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر فقهاء الأمصار، وهي مسألة تبنى على القاعدة الخامسة في العرف، وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح…)، وبعد ذكره الحديث في وضع الجوائح قال: )فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ينفي اعتراضات المخالفين وتأويلاتهم مرده إلى قاعدة المقاصد والمصالح والعُرف الجارية عليه الأحكام الشرعية، فنقول: من حكم عقد البيع تنزيل المشتري منزلة البائع في المبيع ملكا بملك وحالا بحال ومنفعة بمنفعة، وإذا اشترى الثمرة بعد بُدوِّ صلاحها من صاحبها فذلك محمول على حال البائع فيها؛ وعلى عرف الناس في العمل بها، وهو أن يقبضها ملكا بملك وحالا بحال، ولا يقال إن عليه أن يجذها جملة؛ لأن البائع لها لما لم يكن حاله كذلك فيها، ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا يقتضي ذلك فيها، فإذا نزلت الجائحة عليها من غير تفريط من المشتري في اقتضائها مصيبة نزلت قبل القبض فلا كلام لأحد من المخالفين عليها)([113]).
وقد علل ذلك البناني في كلامه المذكور قبل هذا, وإلى نحو ذلك أشار ابن قدامة في المغني, حيث قال وهو يرد على من لا يرى وضع الجوائح: (ولأن التخلية ليست بقبض تام؛ بدليل ما لو تلف بعطش عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض؛ بدليل المنافع في الإجارة يُباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من المؤجر، كذلك الثمرة فإنها في الشجرة كالمنافع قبل استيفائها توجد حالا فحالا)([114]).
وكلام ابن قدامة هو بمنزلة التفسير لحق التوفية المعلل به في كتب المالكية؛ لأن حق التوفية يكون في المكيل بعد بيعه وقبل كيله، وكذلك في الموزون والمعدود, وإذا كان هذا في الجائحة من باب حق التوفية، فإنه في التضخم من باب حق الوفاء, والتعليلات هنا تأخذ منحيان:
- منحى القياس على ما فيه حق التوفية، أو التوسع في حق التوفية.
- اعتبار الجوائح من باب المقاصد والمصالح كما مضى في عبارة أبي بكر بن العربي.
وهذه التعليلات إنما جاءت في سياق الرد على المخالف افتراضَ عدم النص، وإلا فإن الجوائح أصل قائم بنفسه لا يحتاج إلى أصل يقاس عليه؛ ولا إلى مقصد ليندرج فيه، وعلتها منصوصة وهي أخذ مال أخيه بغير حق, ونظرا لهذه العلة قالوا بمراعاة أحكام الطوارئ في الإجارات وما أشبهها، وهي التي جعلها البعض مندرجة في نظرية الظروف الطارئة.
ولنا في ذلك تفصيل كالتالي:
إن نظرية الظروف الطارئة بهذا الاسم نشأت في الغرب، واختلفت فيها قوانين الغرب، ولكن تبنتها بعض القوانين العربية، كالقانون المصري بعد أن قررها السنهوري، واعتبرها موافقة للشريعة تحت عنوان: (نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي) .
وخلاصة نظرية الظروف الطارئة أنها «رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول من طرف القاضي، بحيث يعالج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة مع موازنة مصلحة الطرفين», والظروف الطارئة هي حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة([115])، ويترتب عليها أنه «يجوز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول»([116]).
هذا نص القانون المصري، وقد اعتبر العلامة السنهوري نظرية الظروف الطارئة منطبقة على الأعذار في عقد الإجارة والجوائح في بيع الثمار في الفقه الإسلامي.
ولكن الذي يظهر لنا أن أحكام الطوارئ في الشريعة كما سماها ابن رشد أرحب صدرا وأوسع في مفهومها، وأشد مرونة من نظرية الظروف الطارئة في القانون، وإن كانت تلتقي معها في مبدأ إعادة النظر في نتائج العقد المرهقة لأحد الأطراف، وتعديلها بما يرفع الضرر عن الاثنين، إلا أن اشتراط استثنائية الظروف وكونها عامة ليس شرطا في كثير من المسائل الفقهية المبنية على مبدأ الطوارئ, ويظهر أن تميز الفقه الإسلامي في انسجام أحكام الطوارئ فيه مع أحكام الجوائح التي تنتظم في عقد واحد وترتبط برباط وثيق؛ هو نسيج وحده في كثير من الفروع, فهي في باب الإجارة على وجهين؛ الأول: عيب ليس من فعل المتعاقدين يطرأ على محل العقد، بحيث يتعذر استيفاء المنفعة المتوخاة منه كليا أو جزئيا، وهذا الوجه في الجملة شبه متفق عليه, أما الوجه الثاني: فهو عذر طارئ على المستأجر يجعل تنفيذه للعقد يلحق ضررا بنفسه أو ماله، حسب عبارة الأحناف. إنه تعريف استنبطناه من تلك الفروع.
ولقد ذكر ابن رشد الحفيد هذه الفروع تحت عنوان «أحكام الطوارئ», وذلك في بابي «الإجارة» و «القراض».
أما الأحناف فاستعملوا في باب الإجارة العيب الذي يفوت المنفعة كليا أو جزئيا، وهو موجب للخيار في الفسخ أو عدمه، وذلك كانهدام العين المؤجرة كليا فيثبت الخيار؛ أو جزئيا فيختلف فيه: «لو خرجت الدار سقط كل الأجرة ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر على الأصح»، وعن الوهبانية: «لو انهدم بيت من الدار يسقط الأجر بحسابه» وهو خلاف ظاهر الرواية, «لو كانت تسقى الأرض المستأجرة بماء السماء فانقطع المطر فلا أجر، خانية: أي وإن لم تنفسخ على الأصح، كما مر»، وفي الجوهرة : «لو جاء من الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك أو دفع بحساب ما روى منها». وفي مسألة الحمام «عن لسان الحكام»: استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه، وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر([117]).
وهي فروع كثيرة تتعطل فيها المنفعة فتوجب الخيار وسقوط الأجر عند التمسك، وتتعطل المنفعة جزئيا فيختلف فيها بين قائل بقيام الخيار وبين الفسخ والتمسك مع سقوط مقدار من الأجر يساوي المنفعة التي تعذر استيفاؤها.
الوجه الثاني: العذر الطارئ للمستأجر، وقد بنى عليه الأحناف فروعا كثيرة معروفة في كتبهم, فصَّل الخلافَ في بعضها بين الجمهور وبين الأحناف ابنُ رشد الحفيد في باب الإجارة تحت عنوان «أحكام الطوارئ»، حيث قال: (الجملة الثانية؛ وهي النظر في أحكام الطوارئ, الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ، فنقول: إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة، فذهب الجمهور إلى أنه عقد لازم، وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيها بالجُعْل والشركة, والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيما تنفسخ به، فذهب جماعة فقهاء الأمصار كمالك والشافعي وسفيان الثوري وأبي ثور وغيرهم إلى أنه لا تنفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها؛ أو ذهاب محل استيفاء المنفعة, وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر مثل أن يستأجر دكانا ليتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق, وعمدة الجمهور قوله تعالى: ﭽ ﮍ ﮎﭼ (المائدة: 1)؛ لأن الكراء عقد على منافع، فأشبه النكاح ولأنه عقد على معاوضة فأشبه البيع, وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة)([118]) ، ثم ذكر اختلاف مذهب مالك في هذه المسألة, ومثل ما للأحناف فيما يخص العيب الذي يمنع من استيفاء المنفعة ما للمالكية وغيرهم، فالمالكية فرقوا بين ما يفوت جزءا من المنفعة فيحط عنه بقدره من الكراء، وبين ما يضر فيوجب الخيار بين الفسخ وعدمه مع لزوم الكراء كاملا تارة؛ وسقوطه تماما إذا كان الضرر فادحا.
قال خليل في المسائل التي يرجع المستأجر بحصة من الأجر : )لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل, أو انهدم بيت منها أو سكنه مُكريه, أو لم يأت بسلم للأعلى, أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته).
أما المُضر الذي يثبت فيه الخيار فقد قال فيه خليل: )وخُيِّر في مُضِر كهَطْل، فإن بقي فالكراء كعطش أرض صلح(, إلى قوله: )عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل)([119]).
في هذه المسائل الأخيرة لا يدفع شيئا من الكراء، وهذا مثل ما في الذخيرة للقرافي: )فرع في الكتاب: إذا لم ينزل المطر, أو غرقت الأرض، أو هارت البئر قبل تمام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء لعدم تسليم المنفعة، فإن لقي الماء للبعض وهلك البعض حصل ما له به نفع وعليه من الكراء بقدره وإلا فلا)([120]).
أما الحنابلة فيمثل مذهبَهم في أحكام الطوارئ خير تمثيل العلامةُ ابن تيمية حيث يقول وسُئل عمن استأجر أرضا فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع هل توضع الجائحة؟ فأجاب: (أما إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد فله الفسخ باتفاق العلماء, بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر, وأما إذا نقصت المنفعة فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة، نص على هذا أحمد بن حنبل وغيره, فيقال كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال ألف درهم, ويقال كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال خمسمائة درهم، فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة، فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها، فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه, وكذلك لو أصاب الأرضَ جراد، أو نارٌ أو جائحة، فتلف بعض الزرع، فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة).
وقال أيضا: )وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ، كما لو استأجر طاحونا، أو حماما، أو بستانا له ماء معلوم، فنقص ذلك الماء نقصا فاحشا عما جرت به العادة، بخلاف الجائحة في بيع الثمار، فإن فيها نزاعا مشهورا, فلو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك وأحمد, وهو قول الشافعي الذي علقه على صحة الخبر، وقد صح الخبر في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: (إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا, بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟))([121]).
وقال في موضع آخر: (وأما الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة، لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة؛ لأن الثمرة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية، وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال؛ ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها قبل التمكن من الانتفاع بها، إلا خلافا شاذا حكوه عن أبي ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه تلف المبيع بعد القبض، جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة, وقد يقال هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح، لكن يقولون المعقود عليه هنا المنافع، وهي معدومة لم تقبض، وإنما قبضها باستيفائها والتمكن من استيفائها، وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك، والاستحقاق، وجواز التصرف، فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة, وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها, والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة، وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود في الموضعين، فأبو ثور طرد القياس الفاسد، كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة, وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى، وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ، وتعطل بعض الأعيان المستأجر يسقط نصيبه من الأجرة، كتلف بعض الأعيان المبيعة، مثل موت بعض الدواب المستأجرة، وانهدام بعض الدور)([122]).
إنه كلام واضح يوسع دائرة الجوائح، فقد سمى شيخ الإسلام ما أسماه ابن رشد الحفيد «بالطوارئ» بالجوائح, وكذلك أشار المالكية إلى فروع من هذه الطوارئ تحت عنوان الجائحة.
قال المواق: (التونسي: لو مات دود الحرير أو أكثرُه وهذا الورق لا يُراد إلا له؛ هل موت دود الحرير جائحة؟ فالأشبه أن يكون ذلك كالجائحة، كمن اكترى حمَّاما أو فندقا فخلا البلدُ فلم يجدْ من يسكنُه. ابن يونس: وكذا عندي لو اشترى قومٌ ثمارَ بلدٍ فانجلى أهلُه لفتنة أو غيرها؛ أن جائحةَ ذلك من بائعِه؛ لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه، فإذا لم يجدْه هلكت الثمرة، فذلك كهلاكها بأمرٍ غالِب. انتهى. انظر قوله «لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه كذا هو » يعني أيضا في الورق، قال: إنما اشترى الورقَ يقبضُه شيئا فشيئا فيبيعُه لمن ينتفع به، فجعله كالحمَّام والفندق, وقال: إنما اشترى منافعَ يقبضُها شيئا فشيئا ويبيعُها لمن ينتفع بها. ونقل أيضا أنه كذلك من اكتَرى رحىً سنةً فأصاب أهلَ ذلك المكان فتنةٌ جلَوا بها من منازلهم؛ وجلا معهم المُكتري أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعامٌ لجلاء الناس، فهو كبطلان الرَّحا من نقصان الماء أو كثرته، ويوضع عنه قدْرُ المدة التي جلوا فيها، وكذلك الفنادق التي تُكرى لأيامِ الموسم إذا أخطَأَها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها، بخلاف الدار تُكتَرى ثم يُجلى أهلُ ذلك المكان لفتنة وأقام المكتري آمناً أو رحل للوَحْشة وهو آمن, فإن هذا يلزمه الكِراء كله، ولو انجلى للخوف سقط عنه مدةَ الجلاء. انتهى.
وخرَّج المازري على خُلوِّ البلد مسألةً سُئل عنها؛ وهي: رجلٌ اكترى موضعا لغَسل الغَزْل بكِراءٍ غالٍ ثم أحدث رجلٌ بقربه موضعا آخر فنقص من كِراء الأول كثيرٌ, فأجاب: أنه إن عَقَد على أنه لا يمكن إحداثُه فجاء مِن ذلك ما لم يَظُن فله مقالٌ كما يكون له إذا خلا البلدُ أو غيرُه مما ذكره العلماء, وأما إن كان من الممكن الإحداثُ فلا مقالَ له؛ إذ نقصان الغَلَّة لإحداث فُرن على فرن ليس بعيب. وأفتى ابن رشد: إن رأى القاضي أن يضع شيئا للاسْتِئلافِ لمكتري الحبس فلا بأس به، كالوكيل المفوَّضِ إليه يحُطُّ بعضَ الثمن على هذا الوجه, وانظر أيضا الوكيلُ يبيعُ بالخِيار فيُزاد، قال في رسْم طلق من كتاب البضائع: رب رجلٍ لو زاده لم يبعْه يُكره مخالطتُه وخصومتُه، ويأمن من ناحية الذي زيد عليه وإن كان أقلَّ عطية. ونقل البرزلي عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه إذا أُجيحت دودُ الحرير فلم يجد مشتري الورقِ من يشتريها منه فإن ذلك جائحة، فإن وجدَ مشترياً منه بثمن يسير فلا يوضع عنه شيء) ([123]).
إن هذا النقل يوسع دائر الجائحة لتشمل الحوادث الطارئة التي قد تلحق خسارة بأحد الطرفين ولو كانت غير الثمار محلَّ النص، فموت دود الحرير يسمح لمشتري التوت بالرجوع على البائع، ومكتري الحمام والفندق فيخلو البلد فلا يجد من يسكنه، والفنادق أيام المواسم فلم ينزل فيها الزبائن لفتنة أو غيرها, والمغسلة يكتريها فيزاحمه من يقيم مغسلة بقربه، فينقص ذلك من عائد المغسلة إذا لم يكن ذلك متوقعا، كل هذه اعتبرت جوائح، ومعنى ذلك أن الجوائح مفهوم مرن، وذلك هو مرادنا, وهذه المسألة مسألة اجتهادية؛ إذ أن النقود من غير الذهب والفضة لا نص فيها دائرة بين العرضية والنقدية، صرح بذلك الموفق ابن قدامة في إجابته على رسالة الموفق بن الطالباني وقد تقدم ذلك مستوفى.
ثانيا: إن التضخم يشارك الجائحة في كون كل منهما فيه تمتع طرف بأفضل مما بذل، ووجود طرف متضرر، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ المال بغير حق أي بغير مقابل، وقد تقدم ذلك في سياق آخر.
ومما يرجح قياسَ التضخم على الجائحة ومساواته مسائل أحكام الطوارئ أن بعض العلماء قد قال بالقيمة وألغى المثل، وأهم ما ورد في ذلك قول أبي يوسف، وما ذهب إليه بن دحون وابن عتاب من المالكية، وما ذكره السيوطي في مسألة غلاء الفلوس يقضى بقيمتها, وما قاله مالك في مكيلة القمح يماطل في استرجاعها فتغلو يقضى بالقيمة, وما ذكره ابن تيمية في فتاويه قد مرت معك تفاصيل أقوالهم.
تحصيل الرأي: مما مر نستنتج النتائج التالية:
أولا: أن التشابه بين أحكام الطوارئ وأحكام الجوائح في أن كلا من الصنفين يقع فيه تداركُ نتائج العقود بعد اللزوم والإبرام دون تدليس ولا عيب سابق يوجب ضمان الدرك.
ثانيا: حرص الشريعة على وضع المتعاقدين على قدم المساواة وتوزيع الأرباح والمغارم بينهما على سواء ما دامت آثار العقد باقية وعواقبه متداركة.
ثالثا: الاهتمام في الجملة مما لم يكن للمتعاقدين فيه يد من الخسائر التي تحدث في موضوع العقد, وعليه فإن رخص قيمة العملة (التضخم) إذا كان فاحشا؛ ويقدر كونه فاحشا بنسبة الثلث أو بالعرف؛ مؤثر في أعواض العقود الآجلة, مما يجيز للمتضرر المطالبة بجبر الضرر اللاحق به، وإلزام الطرف الآخر بتعويضه قضائيا بعد الدعوة إلى الصلح، حيث يردهما القاضي أو الجهة المحكمة إلى القيمة العادلة مع مراعاة الثمن في أصل العقد )حتى لا يربح مرتين(([124])، على حد عبارة ابن عباس ﭬ, حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين؛ لأنه قد يكون الدائن قد باع إلى المدين بسعر مرتفع تحسبا للتضخم، فعلى القاضي أن يراعي ذلك في تقدير القيمة العادلة لا وكس فيها ولا شطط بعد أخذ رأي المختصين، ولا يجوز الشرط في صلب العقد سواء كان عقد بيع أو نحوه أو قرضا يمكن استثناء ودائع البنوك استحسانا من ذلك، ومع أن تفويت الوديعة وتحريكها بالتجارة يعتبر تسلفا كما قال الناصر اللقاني: «لأن التجر فيها يتضمن سلفها»([125]) إلا أن البنوك بوضعها للوديعة تحت الطلب يمكن استثناؤها من تأثير التضخم لفائدة المُودِع -بصيغة الفاعل- لأن بقاءها دون سحب كان بسببه لا بسببها، إلا أن تماطل في السحب فيرجع الأمر إلى ما قررناه، وهو فرق تنطبق عليه قاعدة الاستحسان, والله تعالى ولي التوفيق.
الملحق الخامس: نسبة التضخم المعتبرة في الديون
الفصل الأول: المقادير المؤثرة في الأحكام بين النص والقياس والعرف:
إنه باستقراء نصوص الشرع وأقوال الفقهاء يستطيع الباحث أن يدرك المقادير المعتبرة حدا فاصلا بين حكمين، ومعبرا للانتقال من نهي إلى إذن، ومن كثرة إلى قلة، وقد يكون المقدار عبارة عن نصيب حده الشارع لفائدة شخص كأنصباء الورثة، والتي حددها الشارع في الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثين, ومن هذا القبيل تحديد الشارع نصف الصداق للمطلقة قبل المسيس، وتحديد الشارع الثلث في الوصية, ومما هو من قبيل المرفوع قول سعيد بن المسيب بتقدير الثلث في معاقلة المرأة الرجل، تعاقله أي تساوي ديتها ديته حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت رجعت إلى ديتها التي هي نصف ديته، قائلا إن ذلك هو السنة، بمعنى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو عمر بن عبد البر النمري: حديث سعيد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته, وكذلك روى مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان كقول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف في دية الرجل([126]), وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل، فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاثة؟ فقال: ثلاثون من الإبل، فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي([127]).
ومما هو من قبيل النص عملُ أهل المدينة فيما تحمله العاقلة في قتل الخطأ، فإنها لا تعقل إلا فيما زاد على الثلث, فقد قال مالك $ في الموطأ: (والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا)([128]).
أما المسائل الأخرى التي اعتبر فيها الثلث، فهي مسائل مقيسة: ففي الخف إذا انخرق، فإذا كان الشق ثلث القدم فأكثر لم يمسح عليه، قال في المختصر )فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك)([129]). استحقاق الشيء من دار جامعة كفندق مثلا، فيستحق منها جزء شائع، فإن استحق منها سهم دون الثلث لزم البيع في الباقي، وإن استحق الثلث فأكثر رد الباقي, وكذلك دار السكنى وإن كانت تنقسم بلا نقص في الثمن كما قال ابن رشد. ذكر هذه المسائل صاحب المنهج([130]).
قلت: هذه المسائل الأخيرة اجتهادية لا يرجع فيها إلى أصل كما في المسألتين قبلها, وقد تعرضوا لمسائل أخرى اعتبروا فيها الثلث يسيرا كالوصية؛ لأنه يجوز بلوغه في الوصية، وفي القمح الغَلَث الذي فيه الزوان، فيجوز أن يكون الغلث ثلثه، ويباع بلا غربلة ، قال خليل في باب القسمة: (ووجبت غربلة قمح كبيع إن زاد غَلَثُه على الثلث وإلا ندبت)([131]), وكذلك تبرع الزوجة بثلث مالها بلا إذن زوجها، قال خليل: )وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها، وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لها بعد الثلث إلا أن يبعد)([132]), وكذلك مسألة الثمر والصبرة أي استثناء قدر الثلث في الثمار في بيعها، وقدر الثلث في الصبرة في بيعها، وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره، حيث قال عاطفا على الجائز: )وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث(, وكذلك الشجر يكون على الأرض المؤجرة: (واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم)([133]), وكذلك الغبن على القول به يكون بالثلث، كما قال ابن عاصم: )والغبن بالثلث فما زاد وقع(, وقد نفى خليل القيام بالغبن، وكذلك البياض في مسألة المساقاة، فيكون ثلثا للشجر كما قال خليل: )كبياض نخل أو زرع…(, إلى قوله: (وكان ثلثا)([134]), وكذلك المحبس يستثنى من حبسه ما ينتفع فيه ويسكنه، يجوز إن كان ثلثا، وكذلك البائع يستثني ثلاثا من نخله، قال في التوضيح: (إن كانت قدر الثلث فأدنى جاز)([135]).
وقد يسوون بين النصف والثلث في بعض الأحكام، كما في استحقاق نصف أو ثلث بعد القسمة، فإنه يخير المستحق من يده بين بقاء القسمة على حالها ولا يرجع بشيء، وبين رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بقدر ماله، قال خليل: )وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع، وفسخت في الأكثر)([136]), واعتبر النصف في بعض المسائل حدا فاصلا بين القلة والكثرة، ومنها مسألة المدونة: (من أسلم ثوبين في فرس موصوف فاستحق أحدهما، فإن كان وجه الثوبين بطل السلم «أي الأعلى قيمة»، وإن كان الأدنى فعليه قيمته وثبت السلم، وكذلك في استحقاق الجزء الشائع في العروض)([137]).
وقد دارت تقديرات الفقهاء حول الثلث باعتباره حدا فاصلا بين القلة والكثرة للحديث السالف الذكر، فذكر الإمام أحمد $: (أنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة, ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة؛ بدليل قول النبي ﷺ: )الثلث والثلث كثير(، فيدل على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به)([138]).
ونقل الباجي عن بعض البغداديين أن النصف قليل محتجا بآية المزمل ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ (المزمل: 2-3) ، ورد ابن بشير باحتمال كون نصفه بدلا من الليل([139]).
ويقع التحديد بالربع في بعض المسائل كالعيب في المثلي، قال خليل: )ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع، وإن انفك فللبائع إلزام الربع بحصته), قال الزرقاني: (أما إذا زاد على الربع فليس له ذلك, وقد يقدر بالعشر في العيب القليل بدار)، قال خليل: )وعيب قل في دار وفي قدره تردد(.
قال المواق في حاشيته على خليل: )ورأيت لابن عتاب العيبُ الذي يحُطُّ من الدار ربعَ الثمن كثيرٌ يجب الرد به. وقال ابن العطار: إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد المبيع, وإن كانت قيمتُه عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به، فقال: إن كانت عشرة مثاقيل كثيرا ولم يبين من أي ثمن, والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثيرٌ يجب الرد به. انتهى من ابن رشد) ([140]).
وقدرت مجلة الأحكام الغبن الفاحش بنصف العشر في العروض، والعشر في الحيوان، والخمس في العقار, وما يزيد على الخمس هو رأي نصر بن يحيى من الحنفية([141]).
ولعل هذه النقول السريعة تفيد رجحان الثلث لكثرة مسائله وثبوت أصله، ولأن ما زاد عليه يعتبر خسارة فادحة خارجة على المعتاد، ومع ذلك فإن التقدير بالعرف أمر وارد، فيفرق بين التضخم الجامح والتضخم اليسير الذي هو عبارة عن تذبذب للعملة لا يخلو منه اقتصاد, والله تعالى أعلم.
الخلاصة:
إن التقدير بالثلث يرجع إلى أنه عليه الصلاة والسلام جعله حدا فاصلا بين الضرر المؤثر في الحكم، وبين الضرر اليسير الذي لا يؤثر, فردُّ الوصية بما زاد على الثلث إنما كان لمنع الإضرار بالورثة، يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: )الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس), لهذا كان ما دون الثلث يعتبر أمرا غير مؤثر, فلهذا يمكن أن يكون الثلث أساسا مقبولا لتحديد مقدار التضخم.
التقدير بالعرف والعادة: قال ابن قدامة: )إن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلفه كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه، قال أحمد: «إني لا أقول في عشر ثمرات، ولا في عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت جائحة تعرف الثلث أو الربع أو الخمس، توضع»(, وقد وجه ابن قدامة هذه الرواية عن أحمد بقوله: )ووجه الأول عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه؛ ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها فكان ما تلف منها من ضمان البائع وإن كان قليلا كالباقي على وجه الأرض، وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة فكأنه مشروط, إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب)([142]).
والتقدير بالعرف في مذهب مالك في الجائحة والغبن، ولعل هذا أولى، بناء على أن «ما لا حد له في الشرع أو الوضع يرجع فيه إلى العرف»([143]).
وإليك نموذجا من تردد علماء المالكية بين الثلث وما تقضي به العادة في مسألة الغبن، قال الحطاب: (قال ابن الحاجب بعد أن حكى ما تقدم: والغبن قيل الثلث، وقيل ما خرج عن المعتاد، قال ابن عبد السلام: حيث يكون للمغبون الرجوع بالغبن، إما في محل الوفاق أو في محل الخلاف، فقيل قدر الغبن في حق البائع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر، وقيل لا يُحد بالثلث ولا بغيره من الأجزاء سوى ما دلت العادة على أنه غبن, وظاهر كلام المؤلف – يعني ابن الحاجب – أن هذين القولين في الغبن المتفق على اعتباره وفي المختلف في اعتباره، وظاهر كلام غيره أن الغبن المتفق على اعتباره لا يوصل فيه إلى الثلث ولا إلى ما قاربه إذا خرج عن الثمن المعتاد في ذلك المبيع صح القيام به, ونقله في التوضيح وزاد فقال: وقال ابن القصار إذا زاد على الثلث فيكون قولا ثالثا. انتهى. وحكى ابن عرفة الثلاثة الأقوال، ويظهر من كلام ابن عبد السلام والتوضيح ترجيح القول بأنه ما خرج عن المعتاد، وصدَّر به في الشامل، وعطف القولين الأخيرين بـ «قيل»، فقال: والغبن ما خرج عن العادة ، وقيل الثلث، وقيل ما زاد عليه. انتهى) ([144]).
إن مسألتنا هذه في التضخم تقاس في المقدار على الجائحة بجامع اشتراك التضخم مع الجائحة في كون كل منهما تمتع فيه طرف بأفضل مما بذل مع وجود طرف متضرر، كما سنشير إليه في ملحق مستقل, أما هنا فقياسه عليها إنما هو من جهة مقدار الثلث لو لم يثبت نص عن الشارع يحدد الثلث, وقد ذكر المالكية حديثين, أحدهما ذكره عبد الحق الصقلي قائلا: روى أبو محمد من حديث عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة)، والثاني قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن الشعبي عن عبد الجبار عن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة فصاعدا. وسكت عنه عبد الحق، ولم يتعقبه ابن القطان. انتهى كلام ابن عرفة في مختصره الفرعي([145]).
ومهما يكن من غرابة هذين الحديثين، فالأول في سنده أندلسيان إذا كان أبو محمد هو علي بن حزم الظاهري، كما استظهر المحقق، وعبد الملك بن حبيب السلامي القرطبي، عن مدنيين هما: مطرف بن عبد الله بن سليمان ابن أخت مالك، والثاني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري النجاري، وهما من رجال الصحيح، لكن ابن حزم لا يمكن أن يروي عن عبد الملك بن حبيب، وكلام عبد الحق ليست فيه عنعنة، بل إنه قال إنه رواه من حديثه، أما الحديث الثاني فهو مرسل مع ما في سنده من ضعف وجهالة، فلو صح هذان الحديثان أو أحدهما لكان ذلك نصا وتعيَّن الثلث، ولكن ذلك لم يثبت.
وقد نقل في المدونة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﭬ أن الجائحة تكون إذا أصابت الثلث، وهناك أصل عام وهو في الوصية، حيث جعل النبي ﷺ الثلث حدا أقصى فيها.
ثم اطلعت على حديث عبد الرزاق في المصنف, وهو الذي رواه عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أن النبي ﷺ قال: (إذا ابتاع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة), وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة وقد قدمنا ما فيه, وقد قال أبو داود لم يصح في الثلث شيء عن النبي ﷺ, وهو رأي أهل المدينة.
وقد أشار ابن يونس إلى حديث الثلث، قال في جامعه: وفي حديث آخر توقيت الثلث وعمل به، وقاله كثير من الصحابة والتابعين, ولو لم يأت فيه توقيت استحال وضع ما لا بال له؛ إذ لا بد من سقوط شيء منها، وعليه يدخل المشتري، فانبغى أن يوضع ماله بال والثلث عدل ماله بال في سنة الوصايا وغيرها، وحد فيما بين القلة والكثرة في الأصول([146]).
إن هذه التقديرات منها ما هو منصوص وهو القليل، ومنها ما هو مقيس، ومنها ما هو موكول إلى العرف، والأرجحُ في النصوص والقياس الثلث, والعرف هو الاستحسان؛ فقد اختلف العلماء فيه كاختلافهم في الجائحة والغبن وغيرهما, ويتعضد العرف بالقاعدة الفقهية التي تقول: إن «ما لا حد له في الشرع أو الوضع يرجع فيه إلى العرف»([147]).
كما أن موقف الاقتصاديين المتعلق بتعريف التضخم الجامح، قد يكون من باب تحقيق المناط بالعرف, ولهذا فإن الضرر الفادح بدون شك معتبر في هذا الباب, أما كيف يحدد هذا الضرر، فإن الثلث والربع والخمس والعشر كلها كانت أساسا للتقدير في حالات مختلفة ترجع إلى الاجتهاد ومجاري الظنون.
أما العرف فإنه أساس للقاعدة الشرعية التي ذكرناها، وهو الذي أختاره في هذه المسألة، ويمكن أن يبنى على رأي الاقتصاديين في التضخم الجامح, والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
خاتمة:
لقد تعرضنا في افتتاحية البحث إلى أهمية الموضوع وإلى منهجية البحث وأبوابه باختصار, في مقدمة البحث استعرضنا المصطلحات المتعلقة بتغيير العملة من كساد وانقطاع ورخص (تضخم)، فعرفناها لغة واصطلاحا لنحدد من خلال التعريف إشكالية (التضخم), حيث التقطنا من الاقتصادية (سوزان لي) أهم نتيجة من نتائج التضخم الذي يُحول الدائنين إلى خاسرين تدفع لهم ديونهم بمال قلت قيمته, واعتبرنا أن هذه النتيجة هي بيت القصيد بالنسبة للباحث الذي يحاول تخفيف هذه الخسارة لوضع ميزان قسط بين الدائن والمدين لاقتسام الغرم.
أما الفصل الأول فقد عرضنا في تضاعيفه أقوال الفقهاء في تغيرات العملة من كساد وانقطاع ورخص، فبينما سجلنا مواقف واضحة فيما يتعلق بالكساد والانقطاع بين قائل بفسخ البيع، ومخير للبائع، ومن يحكم على المشتري بمثل العملة المنقطعة، ومن يقضي بالقيمة.
إلا أن الذي لفت انتباهنا واستأثر باهتمامنا، هو تغير قيمة العملة بالرخص (التضخم), فثورنا فيه أقوال الفقهاء، واستنطقنا نصوصهم بين تصريح وتلويح؛ حيث أثبتنا رأي الجمهور بأن الرخص لا يؤثر على مقدار ما في الذمة، وأنه يجب قضاؤه بمثله في المثليات, وقررنا رأي من يقول بأن الرخص يؤثر مطلقا مع تقييد بعضهم له بالفاحش, واعتبرنا أن هذا الرأي أقرب إلى العدل، وأولى بالصواب في كوارث تغيرات قيمة العملات التي لا قيمة لها في نفسها, ورددنا الخلاف إلى أنه قد يكون خلافا في حال، وتحقيقا لمناط.
وفي الفصل الثاني لخصنا موضوع البحث، وأصلنا فقه المسألة بالإجابة على خمسة أسئلة تشكل العُقد المستحكمة التي تشد أطرافه.
إجابات مختصرة غير أنها وافية بالمقصود – إن شاء الله – بعد أن قررنا أنها مسألة اجتهادية لا نص بخصوصها من الكتاب والسنة، وليست كذلك منصوصة بالنوع وإن كان لا يستبعد كونها منصوصة بالجنس، وكان ذلك أساس قياسنا لها على الجائحة بجامع أخذ المال بغير حق, أي في غير مقابل.
وقررنا في إجابتنا عن الزيادة التي قد يدفعها المدين إلى الدائن لجبر ضرره أنها زيادة صورية؛ لأن العبرة بالقيمة التي أصبحت معيارا كمعيار العدد الذي قد يُلغى من أجله الوزن في النقدين عند من يقول به، أو معيار الوزن الذي قد يلغى له العدد، كما فصلناه في ملحق الأعواض والمعايير.
ومن خلال جوابنا على مبنى هذا الرأي أوضحنا أنه يرجع إلى أصل عام، هو نفي الضرر وأنه مقيس على أصل خاص هو الجائحة في الثمار التي هي نص في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم، وقد قال بها مالك وأحمد، وافترضنا أن يكون تخريجا عليها لو قال قائل: لا يحق لكم القياس، وهو من اختصاص المجتهد المطلق:
| ولكن البلاد إذا اقشعرَّت | وصوَّح نبتُها رُعي الهشيم |
وعرفنا التخريج بأنه «القول في مسألة لا نص فيها للإمام بمثل قوله في مسألة تساويها».
وانتقلنا إلى إمكان اعتبار هذه المسألة من المصالح المرسلة إذا اعتبرنا أن حكم الجوائح قاصر على الثمار، فهو يدخل في حدها عند مالك.
وتركنا تقدير المقدار الذي يعتبر فاحشا إلى العرف والعادة، مع ذكر مقادير كمؤشرات يلجأ إليها الحكم كالنصف والثلث والربع، وبينا أن الصلح قد يلجأ إليه إلا أن الحكم قد يتعين, وإن تقدير الأضرار يجب أن يراعى فيه الطرفان، كما أبرزنا أننا لا نرى الشرط المسبق, بل نعالج واقعا محققا لا متوقعا مرتقبا, لأن الشرط قد يؤدي إلى الغرر والجهالة في العقد وشبهة الربا في القرض, كل هذه التفاصيل كانت مؤيدة بالنصوص الأصلية وأقوال الفقهاء وسوابق الاجتهاد.
ثم وضعنا خمسة ملاحق، هي عبارة عن مستودع نصوص مختارة تتعلق ببحثنا، من شأنها أن تساعد من يود الاطلاع على النص كاملا في الرجوع إليه، بدلا من الاكتفاء بالمقتطفات التي قد نقطفها من مكان إلى آخر من هذه الملاحق التي أعدت أيضا لتوسيع دائرة التأصيل للنتائج التي توصلت إليها مع تعليق مختصر على كل ملحق يوضح مقصوده.
في ملحق النقود نلاحظ ميلاد النقود الشرعية التي هي بلا خلاف ذهبٌ وفضة، وأنها بحكم نفاسة معدنها وندرة المتداول منها في مأمن من التقلبات العاصفة، الأمر الذي لاحظه العلماء الأوائل في النقول التي سقناها عن ابن رجب في الذيل عن ابن الطالباني عن الفلوس «أنها تختلف في نفاقها وكسادها باختلاف البلدان والأزمان بخلاف النقدين الذهب والفضة». الحطاب عن ابن القاسم: )ومرة رأى أن الدنانير والدراهم أثمان لا تكاد تختلف أسواقها وإن اختلفت رجعت)([148])، أنها عملات مستقرة، فلما جاءت الفلوس صعب تقبلها, واختلفوا فيها من ملحق بالنقدين؛ ومن يجريها مجرى العروض.
إنهم ما لاحظوا إثبات أسعار الذهب والفضة إلا تعليلا لثمنيتها بالخلقة، وتحذيرا من النقود المتذبذبة التي تجلب معها التضخم، لقد كان لهم إحساس بالآثار السيئة للتضخم، وقد عبر عن ذلك المقريزي وابن حجر مبررا عيب الفلوس وسرعة تقلبها.
فإذا كان ذلك في الفلوس المساعدة للذهب – فكان الخلاف فيها اختلافا في حال، فمن رأى ثمنيتها كنقود مساعدة للنقدين ألحق التابع بالمتبوع، ومن لاحظ سرعة تقلبها وضعف تحملها طردها عن مجرى الأحكام الثابتة للذهب والفضة – إذا كان الأمر كذلك، والفلوس لها قيمة معدنية، فما ظنك بنقودنا الورقية التي لا قيمة لها في نفسها، لا يتزين بها ولا تصنع منها سكين، إنها حقا نقود رديئة.
وفي ملحق الأعواض والمعايير دفعنا المسترشد إلى أن يلاحظ بنفسه موقف الفقهاء في المماثلة، ومعايير المبادلة من كيل ووزن وعدد وتحر وحزر ومعيار عرف وعادة، ونوَّهنا بمعيار القيمة؛ حيث سجلنا ومضات نيرة من كبار الفقهاء كابن القاسم وأشهب صاحبي مالك وابن تيمية وابن عتاب وابن دحون.
أما في ملحق تطبيق مبدأ الجوائح على حالة تغير قيمة النقود، فقد فصلنا فيه مفهوم الجائحة، ومفهوم الظروف الطارئة؛ أو ما أسماه ابن رشد بأحكام الطوارئ , حيث أبرزنا سعة هذا المفهوم، وبخاصة في باب الإجارة وغيره؛ حيث اعتبرنا التضخم جائحة توسيعا لمفهوم الجوائح، وتطبيقا لأحكام الطوارئ.
وفي ملحق نسبة التضخم المعتبرة في الديون بينا المقادير والنسب المؤثرة في الأحكام الشرعية، والتي تمثل حدا فاصلا بين القلة والكثرة غير المعتبرة والكثرة المعتبرة, حيث سقنا النصوص الشرعية، واستعرضنا اجتهادات الفقهاء التي تبنى تارة على القياس؛ وتارة على أعراف الناس.
وفي النهاية قدمنا استخلاصا لرأينا بصفة مختصرة بحيثياته التي سبق بسطها متمثلا في مراعاة التضخم، وتقاسم الأضرار، وأنه يجب أن تجبر بالصلح، وإلا فبالحكم.
وانتهينا إلى هذه الخلاصة التي وصفنا فيها رحلتنا مع هذا البحث، ورسمنا تضاريس خريطته, وهكذا نكف شَباةَ القلم اكتفاء بما حصل، واستغناء بالنَّهل عن العلل, ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه من غوائل القول ومزاحل العمل، وهو المستعان.
([1]) مُعود الحكماء هو معاوية بن مالك بقوله:
أُعَوِّدُ مثلَها الحكماءَ بعدي إذا ما الحَقُّ في الأشياع نابا
انظر: تاج العروس ، للزبيدي 2/485.
([2]) انظر: تاج العروس ، للزبيدي 7/79.
([4]) بدائع الصنائع للكاساني 5/242.
([5]) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين 4/533 .
([6]) كشاف القناع، للبهوتي 3/315.
([7]) شرح مختصر خليل، للزرقاني 5/60.
([8]) مواهب الجليل ، للحطاب 5/142.
([9]) المرجع السابق بالجزء والصفحة.
([10]) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/533.
([11]) انظر: تاج العروس 7/373.
([13]) لاروس بالفرنسية ص536 petitIAROUSSE .
([14]) سوزان لي، أبجدية علم الاقتصاد, ص112 , ترجمة خضر نصار، مركز الكتب الأردني.
([15]) انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي، ص: 42- 44.
([16]) بدائع الصنائع، للكاساني 5/242.
([17]) حاشية ابن عابدين، المسماة: رد المحتار على الدر المختار .
([18]) الشرح الصغير، للدردير 3/69-70.
([19]) حاشية الصاوي: أحمد بن محمد على الشرح الصغير للدردير 3/70.
([20]) مواهب الجليل، للحطاب 5/305.
([24]) الديباج المذهب، لابن فرحون 2/466.
([25]) شرح مختصر خليل ، للزرقاني 5/60.
([26]) حاشية البناني على الزرقاني، 5/60.
([27]) المدونة الكبرى لمالك بن أنس 14/321.
([29]) المعيار المعرب ، للونشريسي 6/106.
([30]) المرجع السابق 11/155-156.
([34]) نهاية المحتاج ، للرملي 4/228.
([37]) المغني ، لابن قدامة 4/214.
([39]) كشاف القناع، للبهوتي 3/314.
([40]) انظر: المبدع على المقنع, 4/207.
([41]) انظر: الحاوي للسيوطي 96- 99.
([42]) الضياء اللامع على جمع الجوامع ، لابن حلولو 3/164-165.
([43]) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود، لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 2/278.
([44]) مختصر الروضة وشرحه للطوفي 3/640-641.
([45]) انظر: رسائل وفتاوى بابطين, ص: 251، و: الدرر السنية 5/110.
([46]) انظر: المغني، لابن قدامة 4/209-210.
([47]) أنباء الغمر، لابن حجر 3/419.
([48]) رسالة النقود، للمقريزي, ص6.
([49]) الفتاوى، لابن تيمية 29/473-474.
([50]) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي, ص: 88.
([51]) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي, ص: 83- 84.
([52]) الذخيرة، للقرافي 5/212.
([53]( انظر: المرجع السابق 5/217.
([54]) انظر: المغني، لابن قدامة 4/85-86.
([56]) التاج والإكليل، للمواق 4/508.
([57]) شرح مختصر الروضة ، للطوفي 3/366.
([58]) نشر البنود على مراقي السعود ، لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 2 /142.
([59]) شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/638.
([60]) البيتان في نظم مراقي السعود، لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ، كتاب التعادل والترجيح, أرقامهما من النظم (861 ، 862).
([61]) البيت رقم (733) من نظم مراقي السعود، لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في أواخر فصل مسالك العلة.
([62]) مسلم في صحيحه من كتاب الزكاة 2/722.
([63]) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب 1/68-69.
([65]) مواهب الجليل للحطاب 4/190. التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، لابن عبد البر 4/68.
([66]) انظر: المغني ، لابن قدامة 4/212.
([67]) مواهب الجليل، للحطاب 5/142.
([68]) المغني ، لابن قدامة 4/212.
([69]) انظر تصويبنا لهذه الكلمة بعد سطرين.
([70]) الذخيرة، للقرافي 5/291.
([71]) جاء في مواهب الجليل للحطاب 4/547, دار الفكر – بيروت – 1398، الطبعة الثانية، ما نصه: ” (فرع): قال في الذخيرة: قال سند: ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها, وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة, قال أشهب: إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه, وكذلك إن لم يقصد شيئا, فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض اهـ”.
([72]) شرح مختصر خليل ، للزرقاني 5/228.
([73]) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/518.
([74]) شرح مختصر خليل ، للزرقاني 6/115.
([75]) مقدمة ابن خلدون 1/263- 264.
([76]) الحاوي للفتاوي، للسيوطي 1/102-103.
([78]) كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب 4/125-128.
([80]) الذخيرة، للقرافي 6/ 30 ـ 31.
([81]) مواهب الجليل، للحطاب 5/188.
([82]) نيل الأوطار، للشوكاني 5/255.
([84]) الإسعاف بالطلب، للتواتي ص71 ـ 74.
([85]) شرح مختصر خليل، للزرقاني 5/60.
([87]) انظر: المرجع السابق 9/393.
([88]) البرهان في أصول الفقه، للجويني 2/825.
([89]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/520-525.
([90]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/414-415.
([91]) مجموع الفتاوى، 29 /454 ـ 456.
([92]) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين 5/176-177.
([93]) مواهب الجليل، للحطاب 5/164.
([94]) التاج والإكليل، للمواق 4/361. حاشية البناني على الزرقاني 5/60.
([95]) انظر: تاج العروس، للزبيدي 9/36.
([97]) شرح خليل، للزرقاني 5/101.
([98]) التاج الإكليل ، للمواق 4/372.
([99]) انظر: المغني، لابن قدامة 4/80.
([101]) حاشية البناني على شرح الزرقاني 5/89.
([102]) المغني، لابن قدامة 4/157.
([103]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/132-133.
([104]) الذخيرة، للقرافي 5/212.
([105]) في الأصل (الضرر)، والصحيح ما أثبتناه.
([106]) القبس، لابن العربي 2/813.
([107]) حاشية البناني على الزرقاني 5/195.
([108]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 3/185.
([109]) المنتقى، للباجي 4/232-233.
([110]) البيان والتحصيل، لابن رشد 12/179.
([111]) البيان والتحصيل، لابن رشد 12/180.
([112]) انظر: المغني، لابن قدامة 4/86، مع حذف ما لا يتعلق به غرض.
([113]) القبس، لابن العربي 2/813.
([114]) المغني، لابن قدامة 6/178.
([115]) نظرية الظروف الطارئة، لعبد السلام الترباني، ص109.
([117]) انظر الفروع المذكورة في حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/ 48.
([118]) بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 4/15.
([120]) الذخيرة، للقرافي 5/538.
([121]) الفتاوى لابن تيمية 30/258.
([122]) المرجع السابق، ص288ـ 289 .
([123]) التاج والإكليل ، للمواق 4/508.
([124]) الفتاوي، لابن تيمية 29/518.
([125]) شرح مختصر خليل ، للزرقاني 6/115.
([129]) المختصر، لخليل بن إسحاق ص 93.
([130]) يراجع السجلماني عليه، ص 254، مخطوطة.
([135]) نسبه إليه السجلماني في شرحه للمنهج، ص157، مخطوط.
([136]) المختصر لخليل, ص: 237.
([137]) انظر: المدونة الكبرى لمالك بن أنس 14/396.
([138]) المغني، لابن قدامة 4/87.
([139]) يراجع (شرح المنجور على المنهج) واختصاره (إسعاف الطلب)، ص: 121 ـ 128.
([140]) التاج والإكليل ، للمواق 6/346.
([141]) انظر: مجلة الأحكام العدلية المادة (165)، والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/317.
([142]) انظر: المغني ، لابن قدامة 6/177-179.
([143]) أنوار البروق للقرافي 1/317, وجاء في كتاب: (القواعد الفقهية بين الأصالة والتجديد) لمحمد بكر إسماعيل, ص 435، ما نصه: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في اللغة يرجع فيه إلى العرف.
([144]) مواهب الجليل للحطاب 4/472.
([145]) بنقل أبي زكريا يحيى الحطاب (الابن) في كتابه (القول الواضح في بيان الجوائح)، ص97.
([146]) الجامع لابن يونس القسم الثاني من البيوع ص 321ـ322 أطروحة جامعية للطالب خالد الزير.